تلك المسافة الضبابية بين الأصدقاء و”الفريندز”

تلك المسافة الضبابية بين الأصدقاء و”الفريندز”
شاهدت قبل أشهر بالصدفة حلقة من مسلسل “فريندز” الذي عرض لأول مرة قبل ثلاثة عقود في أميركا. وفكرت كيف نجح هذا المسلسل بأن يطبع ذاكرة أجيال متتالية، وما زال حتى اليوم يعبر الزمن جيلاً بعد جيل؟
المسلسل كان ذكياً عندما وضع الصداقة في العنوان، وكان من السهل أن يسمى بأي اسم آخر: الشباب، المساكنة، حلو الحياة ومرّها، ألخ.
يبدو أن أهمية الصداقة في حياة البشر لم تتلاشَ عبر الأجيال. ربما لأنها لم تخضع لأي تنظيم اجتماعي صارم، كالزواج والتعليم والعمل، وأمكنها بالتالي أن تعبر جميع هذه المؤسسات.
دراسات عديدة أجريت حول المسلسل، لكن ما لفتني مؤخراً هو دراسة في علم الاجتماع للباحثتين البريطانيتين ساشا روزنيل وشيلي بادجيون. برأيهما أن نجاح المسلسل ناجم عن كوننا أصبحنا نضع الصداقة على مستوى موازٍ لخياراتنا الحياتية الكبرى كالزواج مثلاً، أو أحياناً كبديل منه.
بمعنى آخر، إتجه البشر في العقود الثلاثة الأخيرة شيئاً فشيئاً نحو تثمين الصداقات في حياتهم، بعد أن سادت لفترة طويلة ثقافة الثنائي- الزوجي أو الثنائي-الغرامي، أو ما يسمى “كوبل” بالأجنبية. وصداقات الكوبل إجمالاً مشتركة، وتنتمي الى ما يمكن تسميته بالعلاقات الاجتماعية، فلا تشبه ما تحمله الصداقة بين شخصين أو أكثر من حميمية.
ليس اختيار فايسبوك تعبير الصداقة لوصف العلاقات التي نقيمها على صفحاتنا بريئاً، لأنه استفاد مما تحمله في مخيلتنا جميعاً من مشاعر مستحبّة: ثقتنا بالآخر والاعتماد عليه والإخلاص المتبادل، خاصة حين نبوح بمكنوناتنا أو بلحظات ضعفنا أمام الأصدقاء دون غيرهم. حتى أن الخيانة في الصداقة تلاقي استهجاناً إجتماعياً أكبر من الخيانة في الحب.
لكن فايسبوك قصد في البدء جيل المراهقين والشباب عبر اختياره هذا التعبير. لأن الصداقة هي أول تجربة تواصل حميمية لديهم، وهي تسبق الحب وترافقه فيما تستمر أحياناً بعد نهايته. وتشير الدراسات إلى ان الصداقة في عمر المراهقة لا تتمحور على تمضية الوقت والنشاطات المشتركة فقط. إنها تكتسب أهمية خاصة في تكوين الشخصية المبنية على القيم الحياتية والاجتماعية، حيث ينخرط الأصدقاء في هذا العمر بنقاشات جدية فيما بينهم/هن حول هذه الأمور.
ولم يتوقف الأمر عند هذا الحد، فقد استوحى فايسبوك أيضاً تعبير المشاركة (شارينغ) من الصداقة. فحين يُطلب من المراهقين الحديث عن أصدقائهم، فإنهم يركزون بالدرجة الأولى على ما يتشاركون به، فعدا مشاريع الترفيه واللهو، فإنهم يشدّدون على ما يحبون أو يكرهون أي ما يجمعهم من أفكار وآراء، وأسرار بالطبع (وهذه لها تطبيقات أيضاً ومنها محمية جداً أو تُتلف الرسائل الخاصة بسرعة).
منذ حوالي عشرين عاماً، بدأت الأجيال الجديدة تولد أو تكبر في زمن تلتبس فيه المسافات بين الصداقة الفعلية (أي وجهاً لوجه) والصداقة الإفتراضية. وعانت هذه الأجيال وما تزال من هذا الالتباس، إذ أنها لا تمتلك تجربة سابقة في الصداقة كأهلها.
وقد تعلمت على حسابها حول ما يجب أن تكشف أو لا تكشف من حياتها الخاصة للأصدقاء الإفتراضيين. ووصل الأمر حدود الانتحار أو الأزمات النفسية الحادّة، فيما عجز الأهل والمربّون عن تدارك الأمر، لأن زمن الإنترنت وسرعته هما اللذان أتاحا حرية كبرى للأولاد خفية عن أهلهم. ولا شك أن هؤلاء تأخروا كما تأخرت التكنولوجيا والتربية في مساعدتهم على التنبه لصعوبات حياة أولادهم الإفتراضية. لقد تطرقت للموضوع بتوسع أكبر في مقالة سابقة لي.
وماذا عن الأكبر سناً؟ في احدى الدراسات النفسية اعتبرت النساء ان حميمية الصداقات النسائية هي بنفس المستوى وجهاً لوجه أو في التواصل الافتراضي، فيما على العكس أعتبر أغلب الرجال ان حميمية العلاقات بينهم أقوى عبر وسائل التواصل.
إن عادات الاجتماع الذكوري النمطية تفرض نفسها على الرجال، فيمنعهم الضغط المعنوي من أصدقائهم الذكور من أن يبوحوا بمكنوناتهم وجهاً لوجه، وهو ما تفعله النساء إجمالاً. إن سيادة علاقات السلطة في اجتماع الرجال تجعل الرجل يشعر أنه يفقد من هيبته أمام الرجال الآخرين إذا ما باح بنقاط ضعفه وأوجاع فؤاده. وبشكل عام إن تحدث الرجل عن مشاكله الحميمية مع اصدقائه، فإنه يلجأ الى المزاح وتحليل مواقف شريكته وعقلنة المشكلة، دون التعبير بصراحة عن مشاعره.
لكن هذا الأمر تغيّر أيضاً، بفضل المسافة التي تتيحها وسائل التواصل، وبوجه خاص لدى الشبّان. هذا ما استنتجته عالمة الإجتماع الفرنسية كريستين كاسلتين مونيه في كتابها “مكانة الرجال وتحولات العائلة”. أصبح هؤلاء يعبّرون أكثر فأكثر عن خيباتهم في الحب، يذرفون الدموع بعفوية، ويعبّرون عن رغبتهم بأن تبادر الفتيات الى التقرب منهم أو حتى إلى مغازلتهم.
وهل ننسى أن مارك زغربيرغ، مؤسس فايسبوك، كان قد أطلق مشروعه بعد خيبته من علاقة حب، وكتابته لرسالة حزينة قام بتوزيعها على البريد الإلكتروني لطلاب جامعته ؟ ومن هنا أتته الفكرة.
ما واكبته التكنولوجيا الرقمية إذن هو تغيرٌ فعلي في الحياة المجتمعية والشعورية للبشر: حرية أكبر لدى الرجال في التعبيرعن مشاعرهم، وحرية أكبر لدى النساء في التعبير عن أرائهن وميولهن.
تتخذ الصداقة هذه الأهمية في حياتنا اليوم لأن كل فرد في الكوبل اصبح يختار الاهتمام بتنمية حياته الخاصة باستقلالية نسبية عن الحياة المشتركة. وإن كان ذلك أكثر سهولة للرجل بسبب الحرية التي يتمتع بها تقليدياً، فإن التحول يحصل بشكل رئيسي لدى المرأة ونظرتها الى نفسها وحاجاتها باستقلالية أكبر عن الزوج أو الحبيب.
من هنا تتخذ وسائل التواصل الإجتماعي أهمية خاصة بالنسبة للنساء. فهي تساعدهن على توطيد صداقات مبنية على النشاطات والأهواء المشتركة للتخفيف من الصداقات الاجتماعية التي تفرضها العلاقات الزوجية أو العائلية، أو تلك المحصورة بصداقات الجيرة. حتى على صعيد العمل استطاعت العديدات منهن تحويل مواهبهن ومهاراتهن أو انتاجهن المنزلي الى مصدر رزق، بمساعدة “الفريندز” طبعاً !
لقد جرى دائماً التبخيس من إجتماع النساء في لغة الذكور ولغة المجتمع عموماً. وما زلنا حتى اليوم نسمع تعابير من مثل: “نساء الفرن” أو “صبحيات النسوان”، خاصة عند الإشارة إلى الثرثرة واغتياب الآخرين، وكأن الرجال لا يثرثرون في لقاءاتهم ! والواقع ان النساء يتداولن في لقاءاتهن بشؤون اجتماعية وحياتية وحتى في حل المشاكل سلمياً بين الرجال، كما بآراء حيوية بعضها مصيري عندما يتعلق بالعائلة والتربية والتعاضد في بينهنّ. ونرى إنعكاس كل ذلك بوضوح اليوم على شبكات التواصل الاجتماعي.
بالرغم من السجال بين الباحثين حول ما إذا كان الأصدقاء الإفتراضيين “حقيقيين” أم “غير حقيقيين”، ينزع البشر عموماً الى إقامة مسافة واضحة بين صداقاتهم الفعلية وتلك الإفتراضية. ونادراً ما يسعون الى خرقها، لأن الصداقة الإفتراضية تجربة جديدة وممتعة ولا يريدون تحميلها أعباء الصداقات العادية. لقد أصبحت لها مكانة خاصة في النفس، حيث يكفي أن ننقر صباحاً أو مساء على هواتفنا الجوّالة، ليأتينا دفق من أصدقاء لم نلتقهم يوماً، يحبون ما نفعل، يتضامنون معنا، يقرأوننا ويشاهدون شذرات من حياتنا، أو يحبون عائلاتنا دون معرفة سابقة. باختصار، يفرح الكثيرون لفرحنا ويحزنون لحزننا، وبفورية لا يمكن أن تحدث لنا في الحياة الفعلية.
وإن تساعد الصداقات الإفتراضية الناس على إظهار أو إخفاء جوانب من شخصياتهم أو حتى من أوضاعهم النفسية، فذلك مرغوب أيضاً. أنهم يبتكرون في هذه الحالة شخصيات خاصة بهم كانوا أحياناً يتمنون امتلاكها، وقد ينجحون حتى بالتطور شيئاً فشيئاً لتبني عناصر منها. هذا دليل على حاجتنا للتعبير عن أنفسنا أو تطوير شخصياتنا دون الخضوع لنظرة الآخرين المباشرة.
كما أن التقرّب من الآخرين عبر الكتابة وتداول الرأي عن بُعد، يفسح لنا مجالاً للتفكير المسبق والتأني معهم وصولاً الى اختيار التقرب منهم أو تفاديهم بحرية أكبر، وخاصة في العلاقات الغرامية.
تقف البشرية اليوم، بفضل التكنولوجيا الرقمية، أمام تجارب جديدة للعلاقات والصداقات سواء كانت في المحيط المباشر أو المهني أو عبر الأثير. إنها تجارب مليئة بالوعود والإحتمالات كما بالخيبات. وما زلنا ببداية المشوار.
اقرأ ايضاً لبولا الخوري على الملف الاستراتيجي
http://box5852.temp.domains/~iepcalmy/strategicfile/%d8%b9%d9%84%d9%85-%d8%a7%d8%ac%d8%aa%d9%85%d8%a7%d8%b9/%d9%84%d8%a7-%d8%aa%d8%a8%d8%ad%d8%ab-%d8%b9%d9%86-%d8%a7%d9%84%d8%b3%d8%b9%d8%a7%d8%af%d8%a9-%d8%af%d8%b9%d9%87%d8%a7-%d8%aa%d8%ac%d8%af%d9%83%d9%92/










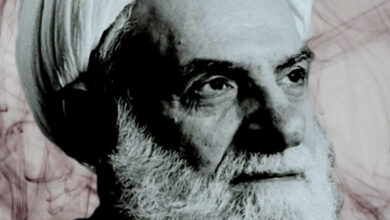

الموضوع جيد، والتناول لا بأس به من حيث الشمولية، غير أن مستوى اللغة والأسلوب لدى الكاتبة يلزمهما كثير من التحسن.
This text is priceless. Howw can I find out more?
My brother suggested I might like thiss website.
He waas totally right. This post actually made my day.
You cann’t imagine simply how much time I had spent for this info!
Thanks!