كتاب سلطان البدايات… بحث في السلطة: هل نعيش فعلا أزمة سلطة؟ | بقلم صلاح الدين ياسين
للاشتراك بالنشرة البريدية اضغط هنا
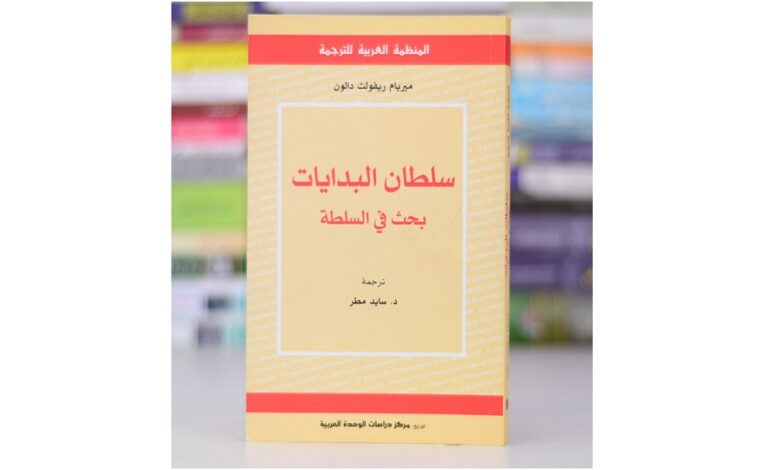
يكتسي هذا الكتاب أهمية نظرية مزدوجة، فهو من ناحية يسوق لنا تشريحا دقيقا لمفهوم السلطة (في بعدها السياسي على وجه الخصوص) من خلال عرض لجذورها التاريخية وعناصرها البنيوية ومقوماتها وخصائصها، ومن ثم فهو يقف على مسافة واضحة من التعريفات التقنية والتبسيطية لهذا المفهوم الجدلي. كما أنه ومن جهة ثانية يندرج في إطار أدبيات ما بعد الحداثة والتي تعبر عن موقف متشكك إزاء مشروع الحداثة ومآلاته الراهنة، وهو ما يتيح لنا فهما أعمق لمقتربات هذا الاتجاه.
وبحسب مؤلفة الكتاب، فإن ظاهرة السلطة السياسية غير مرتبطة بنشأة الدولة الحديثة كما يزعم البعض، بل تمتد بجذورها إلى القدم وعلى وجه التحديد التجربة السياسية الرومانية كما يدل على ذلك الأصل اللاتيني للمفهوم (auctoritas)، حيث كانت السلطة مجسدة أساسا في مجلس الشيوخ الروماني الذي كان وجوده ينطوي على رمزية اعتبارية لكونه يضفي الشرعية على قرارات وأفعال الحاكم (الذي كان يسمى بقنصل روما)، بالرغم من أنه لم يكن يتوفر على صلاحيات تشريعية ولا تكتسي مخرجاته صبغة عملية وتنفيذية :
” السلطة هي الحق المعترف به لمجلس الشيوخ بأن يعطي مشورة ملزمة، بمعنى أنها مشورة تلزم من دون إكراه من دون أن يكون المرء مجبرا على إتباعها. وبهذا المعنى تعتبر السلطة أقل من أمر وأكثر من مشورة. فهي مشورة من الصعب للمرء أن يعفي نفسه من إتباعها، تماما كالمشورة التي يقدمها صاحب المهنة إلى عديم الإلمام، أو التي يسديها رئيس حزب برلماني إلى أعضاء فريقه.”
أما بخصوص المقومات والعناصر التي تحدد جوهر السلطة السياسية، فلا يمكن إدراكها دون تميز مفهوم السلطة (authority/autorité) عن مفهوم السلطان (power/pouvoir). فإذا كان هذا الأخير يشير إلى ممارسة الحكم عبر الإكراه والسيطرة وفرض نظام معين بواسطة القوة الجبرية بما يحوله إلى مجرد وسيلة في يد الحاكم لبلوغ مآربه السياسوية الضيقة، فإن مفهوم السلطة يستند على عنصري الاعتراف والشرعية بوصفهما أساس قيامها :
” والقول بأنه قد تم الاعتراف بالسلطة لهو نوع من اللغو: فكل سلطة قائمة هي سلطة معترف بها، ما يعني أنها سلطة شرعية. فلا معنى، إذا، للكلام عن سلطة لا شرعية أو غير قانونية : فهو تناقض في التعبير على ما قال كوجيف. فالذي يعترف بسلطة (ولا وجود لسلطة غير معترف بها) يعترف بالفعل نفسه بشرعيتها أيضا .”
كما أنه وعلى خلاف مفهوم السلطان الذي ينطوي على بعد مكاني واضح حيث ينظم العلاقة بين أفراد الجماعة في حيز مكاني محدد ويزول بمجرد تفرقهم وتوقفهم عن العيش المشترك، فإن السلطة لها صلة وثيقة بالزمنية وهو ما يتجسد في وجودها المفارق والعابر للأزمنة لكونها تؤمن دوام واستمرارية العيش المشترك بين الأجيال المتلاحقة من خلال المرجعيات المتسامية التي تؤسس لها، وهو ما يمكن تلمسه في التجربة التاريخية للحاضرة الرومانية :
” غالبا ما أشير إلى الأهمية التي أولتها روما للديمومة من حيث الإصرار على ما مارسه التقليد من تأثير بالغ على العقلية الرومانية. وهي عقلية تؤثر وتثق بكل ما ينسلك في الزمان. إن قوة التقليد تغذي المدينة. لذلك يعود تفوق الدستور الروماني، بحسب (canton l’ancien)، إلى كونه لم يصنعه عقل إنسان واحد، بل شاركت في صياغته عقول كثيرة، وليس على مدار حياة إنسان واحد بل على امتداد أجيال وقرون عدة .”
وبالرغم من التمييز السابق الذي أقامته المؤلفة بين مفهومي السلطة والسلطان، توجد بعض نقاط الالتقاء بينهما، ذلك أن وجود السلطة السياسية ينطوي بالضرورة على نوع من التراتبية والهيراركية بين فئة الحكام الذين يمارسون السلطة وفئة المحكومين الذين يطيعون الأفعال والأوامر المنبثقة منها، غير أن الفارق الأساسي هنا يكمن في توافر عنصر الاعتراف والقبول المتبادل بين الفئتين والذي يشكل جوهر السلطة السياسية وماهيتها.
يفسر ما سبق سبب الارتباط الوثيق لمفهوم السلطة بالتجربة السياسية الرومانية بالمقارنة مع المدينة اليونانية والتي وضعت حدا فاصلا بين التفكير العقلاني وعلوم نشأة الكون القديمة، فقد استندت تلك التجربة إلى نموذج المساواة أمام القانون، إذ لم يعد الشأن العام حكرا على شخص واحد أو قوى غيبية وفقا للتفكير الميثولوجي بقدر ما أصبح موضوع اهتمام وتداول عام بين المواطنين الأحرار الذكور، في حين كان ينظر إلى السلطان على أنه مجرد حكم يقف على مسافة واحدة بين المواطنين المتساويين أمام القانون. إن هذا النموذج (والذي يعبر عنه أحيانا بالديمقراطية المباشرة) الذي يكرس فرادة أثينا بوصفها فضاء يحتضن المواطنة السياسية هو ذاته ما يفسر لنا سبب عدم إقدام اليونان على اجتراح مفهوم خاص بهم عن السلطة السياسية :
” ولأن هذا التخليد يمارس عبر تتالي الأجيال، فهو ينطوي أيضا على اعتراف في تفاوت الأجيال، الأمر الذي لا يمكن تحديده مباشرة في التجربة اليونانية. ذلك أن الحيز العمومي القائم على المساواة أمام القانون لا يمكن أن يسكنه سوى جماعة أشخاص متساوين. فمسلمة السياسة اليونانية التي ترتبط بشروط ظهور الفضاء العمومي، هي مسلمة مساواتية في الأساس. أما مسلمة السياسة الرومانية القائمة على مبدأ التأسيس والمرتبطة بالديمومة المؤسساتية، هي مسلمة تشتمل بصلبها على تفاوت بين الأجيال : يقوم امتياز القدماء، الرواد، الأجداد على إعطائهم الأجيال القادمة مثل العظمة .”
بعد إسهاب المؤلفة في عرض الإطار التاريخي لظهور مفهوم السلطة السياسية واستكناه خصائصه ومقوماته، سرعان ما تنكشف أمام القارئ تدريجيا الأطروحة التي ينبني عليها الكتاب، والذي يستند في صلبه إلى فرضية رئيسة قوامها أننا نعيش حاليا أزمة سلطة في شتى الميادين وفي القلب منها السلطة السياسية. وتماشيا مع ذلك الطرح تمضي الكاتبة إلى سبر أغوار مشروع الحداثة الذي يجهر بأنه يستمد مشروعية وجوده من المستقبل بوصفه شرطا للتقدم، في مقابل تمسكه بنبذ التقليد الموروث :
” مهما تعددت تعريفات الحداثة وتنوعت، يبقى هناك إجماع على الأقل على أن ما يميز الحداثة بشكل وثيق هو سعيها إلى الانسلاخ عن الماضي وعن التقليد. وتتجلى ميزة الحداثة في تأسيس ذاتي عقلاني وتأسيس ذاتي سياسي في آن واحد : وكلاهما لا ينفصلان، والصلة المشتركة المؤكدة بينهما هي المطالبة بنوع من المشروعية التي تنفصل بقوة عن التقليد والماضي .”
ومن هنا تكمن الإجابة على إشكال أزمة السلطة الحديثة، ذلك أن الحداثة بحسب وجهة النظر التي تعتنقها المؤلفة وقعت في ما يمكن تسميته بخطيئة التأسيس، حيث قامت بالخلط بين مفهومي السلطة والسلطان، أي بين الماضي الذي يحيل إلى فرادة التجربة اليونانية والرومانية، والتقليد الذي ارتبط بحقبة العصور الوسطى المظلمة، حيث قطعت الحداثة صلتها بالاستمرارية التي ينطوي عليها البعد الزمني للسلطة والتي كانت تضفي معنى على العيش المشترك وتؤمن استمرارية الروابط بين الأجيال المتلاحقة، ولكن دون أن تفلح في تأسيس سلطة السياسية ترتكز إلى مرجعيات صلبة تؤمن نوعا من الديمومة لمشروعها، ويسوق الكتاب مثلا لذلك بنظريات العقد الاجتماعي التي أسندت السلطة على مشروعية هشة ومشروطة بما يجعلها قابلة للانحلال في أي لحظة :
” تبعا للمنظور اللاهوتي، الله هو، نوعا ما، الإله الحافظ الذي يضمن الاستمرارية (النسب)، أو وحدة الجماعة. في المقابل، حين ننظر إلى فرضية العقد الاجتماعي، نجد أن السلطة الأولى سلطة انبثقت عن قرار جماعي، أي إنها انبثقت عن فعل هؤلاء الذين سيخضعون لها. فالسلطة هي، إذن، سلطة مشروطة بشيء مختلف عنها : وفي هذه الحالة، بالإمكان الشك بأن الإجراء التعاقدي يحل مسألة تكون السلطة. ”
كما يمكن فهم هذا الطرح على نحو أكثر وضوحا بالرجوع إلى تصور أحد أبرز المفكرين السياسيين في القرن 19 وهو ألكسيس دو توكفيل الذي اشتهر بكتابه ” الديمقراطية في أمريكا “. فعلى الرغم من أن هذا الأخير دافع عن المجتمع الديمقراطي الذي يقطع مع التفاوتات الطبيعية والامتيازات غير المشروعة القائمة في المجتمع الأرستقراطي ويضمن المساواة الاجتماعية والسياسية (التي تفيد المساواة في الحظوظ وتساوي الفرص دون أن تشمل الثروة والمساواة الفكرية)، غير أن توكفيل نبه في الآن نفسه إلى أزمة الاغتراب التي يسببها المجتمع الديمقراطي للأفراد والناجمة عن فقدان روابط وصلات المجتمع الأرستقراطي، دون أن يستعاض عنها بمرجعيات بديلة تؤمن العيش المشترك بين أعضاء المجتمع في ظل نزعة المساواة التي تدفع الأفراد إلى الرغبة في التمايز عن بعضهم البعض :
” أما في المجتمع الأرستقراطي فلا يوجد تشابه طبيعي بين الأسياد والخدم : فهناك مسافة كبيرة فيما بينهم يحددها تراتبيا سلم الكائنات، ومع ذلك ينتهي الأمر إلى توحيد بعضهم مع بعضهم الآخر. وهناك مجموعة كبيرة من الذكريات تربطهم، مهما كانت الاختلافات فهم يستوعبون بعضهم بعضا. أما في الديمقراطيات حيث هم طبيعيا شبه متساوين، فإن الواحد منهم يبقى غريبا عن الآخر. إن استمرارية الزمان هي عامل الرابط الاجتماعي الأرستقراطي. ”
ومن هذا المنطلق، فإننا لن نجد صعوبة وفق وجهة النظر هذه في تفسير الفراغ الذي تعيشه الديمقراطيات الليبرالية الحديثة من حيث المعنى والمرجعيات المؤسسة للعيش المشترك والناجم أساسا عن رفض الحداثة المطلق واليقيني لسلطة الماضي. ومن بين تجليات ذلك شيوع الفردية المتطرفة بالموازاة مع تراجع الاهتمام بمفاهيم الشأن العام والتداول الحر في الأفكار والقيم وضعف المشاركة السياسة، دون إغفال تضخم العقلانية التقنية التي عملت على تشييئ الإنسان وتحويله إلى مجرد مستهلك سلبي بدل أن تكون مصدر رفاه للبشرية. وبالنتيجة فإن مشروع الحداثة قد وصل إلى أفق مسدود بسبب استنفاد وعوده ورهاناته التأسيسية لصلاحية وجودها :
” وأزمة السلطة واضحة جدا اليوم مع انهيار المشاريع نفسها المرتبطة بخصائص المستقبل العينية. وهو ما سمي، أخطأ كان أم صوابا، نهاية الأيديولوجيات، انهيار الأساطير الثورية والديانات العلمانية. كل ذلك أسهم في تعميق الأزمة من خلال زعزعة علاقتنا بالزمنية بعمق. ومع زوال أفق الأمل العلماني أتى زمن الذي لا وعود فيه، ولم يعد بمقدور السلطة مذ ذاك أن تستفيد من هذه الألحقية أو من هذا التقدم الارتجاعي الذي كان يوجه مسار أفعالنا. لقد توقف الزمن عن الوعد بشيء ما. ”
بعد إجراء المؤلفة لهذا التشخيص القاتم لواقع سلطة المحدثين، تقر هذه الأخيرة بأن السبيل الوحيد لردم تلك الفجوة القائمة هو إعادة الاعتبار لماض لم تعره الحداثة الاهتمام الذي يستحقه، أي الماضي اليوناني والروماني العريق، في أفق حل إشكالية الاغتراب وانسداد أفق المستقبل التي تواجه مشروع الحداثة السياسية عبر إحياء الصلة بالاستمرارية والديمومة السابقة ورد الاعتبار إلى مفاهيم الشأن العام والمشاركة السياسية وقواعد العيش المشترك. غير أن تلك الاستعادة الملحة لا تنطبع بالضرورة بطابع التقليد، ذلك أن إحياء الماضي لا يراد من خلاله الاستنساخ والمحاكاة، بقدر ما يشكل مصدر إلهام لفعل تجديدي ينفتح على ممكنات المستقبل:
” فإن هجر هذه الخصائص لا يعني فقدان القدرة على الانفتاح من جديد على ماض ذي حيوية غير متوقعة لم يعره أحد أي اهتمام. إعادة النظر إلى ماض لا يتطابق مع التقليد : أو أيضا الإنصات إلى دلالات ماض منفتحة تدعو، وحتى يومنا هذا، إلى اتخاذ مبادرات جديدة والإقدام على ابتكارات لم تعرف من قبل.











