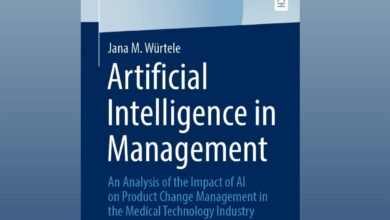مراجعة أدبية Literature Review
مقدمة
شهدت الفترة التي أعقبت الحرب العالمية الثانية تحولاً جذرياً في تصور الولايات المتحدة لنفسها ودورها العالمي. فبعد خروجها من الصراع كقوة اقتصادية وعسكرية لا مثيل لها، تخلت الأمة عن ميلها التاريخي نحو الانعزالية، واتخذت بدلاً من ذلك موقعاً قيادياً عالمياً. لم يكن هذا التحول نتيجةً للواقع الجيوسياسي فحسب، بل كان متشابكاً بعمق مع تطور التصورات الأمريكية عن الذات، لا سيما فيما يتعلق بقيمها السياسية الأساسية – الديمقراطية والحرية والأسواق الحرة – ومسؤوليتها المتصورة في تشكيل النظام الدولي وفقاً لذلك. تبحث هذه المراجعة الأدبية في كيفية رؤية الولايات المتحدة لنفسها فيما يتعلق بقيمها السياسية ودورها العالمي منذ نهاية الحرب العالمية الثانية وحتى يومنا هذا، بالاعتماد حصرياً على مصادر من داخل الولايات المتحدة، بما في ذلك تحليلات من مراكز أبحاث ومؤسسات تاريخية بارزة.
يهدف هذا البحث إلى تجميع وجهات نظر حول تطور هذا التصور الذاتي واستمراريته وتناقضاته، واستكشاف كيف أثرت أحداثٌ مثل الحرب الباردة والعولمة والأزمات الدولية المختلفة على فهم أمريكا لهويتها وهدفها على الساحة العالمية. يركز التحليل تحديدًا على المواد المناسبة لأبحاث الدراسات العليا، بهدف تقديم نظرة شاملة على السرديات السائدة والتأملات النقدية في الخطاب الأمريكي حول هذا الموضوع.
التحول بعد الحرب العالمية الثانية من الانعزالية إلى القيادة العالمية
يُعدّ التحول الجذري من الانعزالية التي سادت قبل الحرب إلى تبني القيادة العالمية موضوعًا ثابتًا في تحليلات تصورات الأمريكيين عن أنفسهم في حقبة ما بعد الحرب العالمية الثانية. وتُفصّل مقالة المتحف الوطني للحرب العالمية الثانية، بعنوان “مسؤوليات عظيمة وقوة عالمية جديدة”، هذا التحول بوضوح، مشيرةً إلى أنه قبل الحرب، لم تكن القيادة العالمية “طموحًا للسياسيين الأمريكيين”، حيث اكتفى معظم الأمريكيين بترك قوى مثل بريطانيا العظمى تتولى هذا الدور. إلا أن نتائج الحرب، التي جعلت الولايات المتحدة واحدة من قوتين عالميتين مهيمنتين إلى جانب الاتحاد السوفيتي، غيّرت هذه النظرة جذريًا. وتُؤكد المقالة أن فترة ما بعد الحرب مباشرةً شهدت “رغبة واضحة لدى القادة السياسيين والاقتصاديين الأمريكيين في حماية هذه القوة الجديدة وترسيخ مكانة الولايات المتحدة كقائدة للعالم الحر” (المتحف الوطني للحرب العالمية الثانية، 2020). وقد ترسخت هذه النظرة بفضل القوة الاقتصادية غير المسبوقة التي امتلكتها الولايات المتحدة – حيث صُنعت أكثر من نصف سلع العالم وامتلكت ثلثي احتياطيات الذهب بحلول عام ١٩٤٥ – والتي جلبت معها “عددًا من المسؤوليات الجديدة” ذات التداعيات العالمية (المتحف الوطني للحرب العالمية الثانية، ٢٠٢٠). وتتردد أصداء هذه الرواية عن التحول في مصادر أخرى. يصف مقال معهد أبحاث السياسة الخارجية (FPRI)، بعنوان “الحرب العالمية الثانية وأهميتها للأمريكيين”، الحرب العالمية الثانية بأنها “المرحلة الحاسمة في تاريخ أمريكا في القرن العشرين” و”لحظة فارقة في تاريخ أمريكا” شكّلت هوية الأمة ودورها في العالم” (أيزنهاور، ٢٠٠٧). ويقارن المقال بين نتائج الحرب العالمية الثانية والحرب العالمية الأولى بشكل حاد، مجادلًا بأن الحرب العالمية الثانية “فتحت الأبواب أمام أسلوب حياة جديد وأفضل” وأظهرت قدرة أمريكا على الانتصار، محولةً إياها إلى “قوة عظمى اقتصادية وعسكرية وصناعية” (أيزنهاور، ٢٠٠٧). عزز هذا النجاح الشعور بالثقة، وعزز الإيمان بمكانة أمريكا وقدراتها الفريدة. وبالمثل، يتناول تعليق مؤسسة بروكينغز، “عولمة السياسة”، حقبة ما بعد الحرب الباردة، لكنه يُصوّرها على أنها تتويج لعملية بدأت بعد الحرب العالمية الثانية. ويشير إلى أن انهيار الاتحاد السوفيتي يعني تحقيق “الهدف الرئيسي للسياسة الخارجية الأمريكية” – منع الهيمنة الأوراسية، التي سعت إليها منذ الحرب العالمية الثانية – (دالدر وليندسي، 2003). وعزز هذا النجاح صورة الولايات المتحدة باعتبارها “القوة العالمية الحقيقية الوحيدة”، الفريدة في التاريخ، ذات النفوذ العسكري الذي لا يُضاهى، والقوة الاقتصادية، والجاذبية السياسية/الثقافية (دالدر وليندسي، 2003). يمثل التحول من استراتيجية جغرافية (جيوسياسية) مركزة إلى استراتيجية محددة بالقوة العالمية والعولمة استمرارًا وتطورًا لدور القيادة المفترض بعد عام 1945. إن فعل إنشاء مؤسسات ما بعد الحرب مثل الأمم المتحدة وحلف شمال الأطلسي وبريتون وودز وخطة مارشال، كما أبرزه كل من المتحف الوطني للحرب العالمية الثانية ومؤسسة بروكينجز، أظهر هذا الابتعاد عن الانعزالية والبناء النشط لنظام عالمي تقوده الولايات المتحدة، مما يعزز التصور الذاتي لأمريكا باعتبارها المهندس والضامن لعالم ما بعد الحرب. تعزيز “القيم المركزية” للتصور الذاتي الأمريكي الذي يدعم دورها العالمي هو مفهوم الاستثنائية الأمريكية، والذي غالبًا ما يتشابك مع القيم السياسية الأساسية للأمة. إن الاعتقاد بأن الولايات المتحدة فريدة من نوعها بين الدول، ولديها مهمة خاصة لدعم وتعزيز الحرية والديمقراطية والأسواق الحرة، هو دافع متكرر في المناقشات حول هويتها بعد الحرب العالمية الثانية. تُسلّط مقالة المتحف الوطني للحرب العالمية الثانية الضوء على الرغبة التي سادت بعد الحرب مباشرةً في ترسيخ مكانة الولايات المتحدة كـ”قائدة للعالم الحر”، وهي عبارةٌ زاخرةٌ بطبيعتها بأحكامٍ قيميةٍ وشعورٍ فريدٍ بالمسؤولية (المتحف الوطني للحرب العالمية الثانية، ٢٠٢٠). لم يُنظر إلى هذا الدور القيادي من منظور القوة فحسب، بل كواجبٍ أخلاقيٍّ متجذّرٍ في القيم الأمريكية. تُعزّز مقالة معهد أبحاث السياسة الخارجية هذا، مشيرةً إلى أنه بينما يُمكن للأمريكيين أن يُمارسوا النقد الذاتي، فإن جيل الحرب العالمية الثانية، الذي شكّل حقبة ما بعد الحرب، كان “واثقًا بقيمه ومؤسساته” و”مؤمنًا بأمريكا” (أيزنهاور، ٢٠٠٧). تُرجمت هذه الثقة إلى نهجٍ في السياسة الخارجية، حيث أصبح تعزيز القيم الأمريكية جزءًا لا يتجزأ من المصلحة الوطنية. يقارن المقال بين انعدام المعنى المُتصوَّر للحرب العالمية الأولى والنتيجة الإيجابية المُؤكِّدة للقيم في الحرب العالمية الثانية، مُشيرًا إلى أن الأخيرة رسَّخت الإيمان بصلاح المُثُل الأمريكية وفعاليتها على الساحة العالمية (أيزنهاور، ٢٠٠٧). يُقرُّ تحليل بروكينغز، مع تركيزه على حقبة ما بعد الحرب الباردة، ضمنيًا بالدور الراسخ للقيم في التصور الأمريكي للذات والسياسة الخارجية. ويتحدث عن استخدام القوة الأمريكية “لتشكيل بيئة دولية مُواتية لمصالحها وقيمها” والحاجة إلى قيادة الجهود لبناء عالم “يكون فيه الرخاء والأمن والحرية هي القاعدة” (دالدر وليندسي، ٢٠٠٣). يُقدَّم مفهوم “القوة الناعمة”، أي جاذبية القيم السياسية والثقافية الأمريكية، كمكون أساسي للنفوذ الأمريكي العالمي (دالدر وليندسي، ٢٠٠٣). ومع ذلك، يُقدِّم مقال المتحف الوطني للحرب العالمية الثانية منظورًا نقديًا، مُشيرًا إلى التوتر الذي نشأ خلال الحرب الباردة، حيث دفعت الرغبة في الحفاظ على القوة العالمية ومحاربة الشيوعية الولايات المتحدة أحيانًا إلى التنازل عن قيمها المعلنة من خلال دعم أنظمة غير ديمقراطية، مُسلِّطًا الضوء على تناقض متكرر في السرد الاستثنائي (المتحف الوطني للحرب العالمية الثانية، ٢٠٢٠). يُشير هذا إلى أنه على الرغم من أن تعزيز القيم يُعدّ جوهريًا في الصورة الذاتية الأمريكية، إلا أن تطبيقه في السياسة الخارجية كان مُعقَّدًا ومُتضاربًا في بعض الأحيان.
الركيزة الاقتصادية للقيادة العالمية:
ارتبط تولي الولايات المتحدة الأمريكية القيادة العالمية بعد الحرب العالمية الثانية ارتباطًا وثيقًا بهيمنتها الاقتصادية غير المسبوقة، وهو عاملٌ برز بقوة في التصور الأمريكي الذاتي لقوتها ومسؤولياتها. يقدم مقال المتحف الوطني للحرب العالمية الثانية وصفًا مفصلًا لهذا الصعود الاقتصادي، مقارنًا بين وضع الدولار الأمريكي قبل الحرب، الذي كان ضعيفًا أمام العملات الأوروبية، وهيمنته بعد الحرب. بحلول عام ١٩٤٥، تحولت الولايات المتحدة الأمريكية من “مدين صافٍ إلى دائن صافٍ”، وأصبحت تُصنّع أكثر من نصف سلع العالم، وتمثل أكثر من ثلث الصادرات العالمية، وتمتلك ما يقرب من ثلثي احتياطيات الذهب المتاحة (المتحف الوطني للحرب العالمية الثانية، ٢٠٢٠). لم تكن هذه القوة الاقتصادية الهائلة مجرد نتيجة ثانوية للمجهود الحربي (“ترسانة الديمقراطية”)، بل أصبحت ركيزة أساسية في الصورة الذاتية الأمريكية كقوة عالمية. يُقدَّم مؤتمر بريتون وودز عام ١٩٤٤ على أنه لحظة محورية في ترسيخ هذه القوة الاقتصادية، مُرسِّخًا بذلك الدولار عملةً احتياطيةً عالميةً، ومُرسِّخًا مكانة الولايات المتحدة كـ”حاملة لواء الاقتصاد في عالم ما بعد الحرب” من خلال منظماتٍ مثل صندوق النقد الدولي والبنك الدولي، ومقرَّيها واشنطن العاصمة (المتحف الوطني للحرب العالمية الثانية، ٢٠٢٠). لم يُنظر إلى هذا الهيكل الاقتصادي على أنه مُجرَّد خدمةٍ ذاتية، بل كوسيلةٍ لمنع أي كسادٍ عالميٍّ مُستقبليٍّ وتعزيز السلام من خلال الترابط الاقتصادي – وهو انعكاسٌ للقيم الأمريكية المُنعكسة على الساحة العالمية. علاوةً على ذلك، تُصاغ مبادراتٌ مثل خطة مارشال كامتدادٍ لهذه القيادة الاقتصادية، مُحققةً غرضين. فبينما كان الهدف الظاهري هو إعادة بناء أوروبا الغربية التي مزقتها الحرب لمنع الانهيار الاقتصادي وتعزيز السلام (استنادًا إلى الاعتقاد بأن “الدول التي تتاجر معًا أقلُّ عُرضةً لشنِّ الحرب”)، فقد ساهم أيضًا في تعزيز المكانة الاقتصادية الأمريكية، وخلق أسواقٍ للسلع الأمريكية، والتصدي استراتيجيًا لانتشار الشيوعية من خلال الترويج للرأسمالية (المتحف الوطني للحرب العالمية الثانية، ٢٠٢٠). يُبرز هذا كيف أصبحت السياسة الاقتصادية أداةً أساسيةً لتفعيل الدور العالمي المُتصوَّر لأمريكا، وتعزيز صورتها كقائدٍ مُحسنٍ، ولكنه بارعٌ استراتيجيًا، عززت قوته الاقتصادية قدرته على تشكيل العالم وفقًا لمصالحه وقيمه. كما يُقرّ تعليق بروكينجز بهذا الأساس، مُشيرًا إلى أن القوة الاقتصادية الأمريكية عنصرٌ أساسيٌّ في تغذية التجارة والصناعة العالميتين، مما ساهم في مكانتها كـ”القوة العالمية الوحيدة” حتى بعد عقود (دالدر وليندسي، ٢٠٠٣).
حتمية الحرب الباردة:
تشكيل الهوية والفعل، شكّل التنافس بين الولايات المتحدة والاتحاد السوفيتي خلال الحرب الباردة بوتقةً قويةً امتدت لعقود، وشكّلت بعمقٍ صورة أمريكا عن نفسها ودورها العالمي. نشأ هذا الصراع الأيديولوجي والجيوسياسي مباشرةً بعد الحرب العالمية الثانية تقريبًا، وشكّل إطارًا للعلاقات الدولية، ووفّر سياقًا واضحًا، وإن كان عدائيًا، للقيادة الأمريكية. يصف مقال المتحف الوطني للحرب العالمية الثانية كيف “استهلكت الحرب الباردة الولايات المتحدة بسرعةٍ في أسلوبٍ جديدٍ لإدارة الصراعات”، مُهيمِنةً بذلك النظام العالمي لما بعد الحرب (المتحف الوطني للحرب العالمية الثانية، ٢٠٢٠). أدّى التهديد المُتصوّر للتوسّع السوفيتي والشيوعية مباشرةً إلى اعتماد “سياسة الاحتواء” كمبدأٍ أساسيٍّ في السياسة الخارجية الأمريكية، مُمثّلًا بذلك ابتعادًا حاسمًا وتدخليًا عن سياسة الانعزالية التي سادت قبل الحرب (المتحف الوطني للحرب العالمية الثانية، ٢٠٢٠). أصبحت سياسة الاحتواء هذه، التي ترسخت من خلال تحالفاتٍ مثل حلف شمال الأطلسي (الناتو)، سمةً مُميّزةً لانخراط أمريكا العالمي. لقد تعززت باستمرار النظرة الذاتية للولايات المتحدة كـ”قائدة العالم الحر” من خلال الصراع الوجودي ضد الشيوعية. وقد بررت هذه الضرورة التزامات عسكرية واسعة النطاق، وانخراطها في حروب بالوكالة (كوريا، وفيتنام)، وتغييرات داخلية كبيرة، بما في ذلك تشديد المراقبة وتمكين أجهزة الاستخبارات (المتحف الوطني للحرب العالمية الثانية، 2020). كما يشير تقرير مؤسسة كارنيغي إلى سياق الحرب الباردة، مشيرًا إلى كيف أن الحرب الكورية (نتيجة مباشرة لتوترات الحرب الباردة) برهنت على صحة الاستراتيجية العسكرية الشاملة الموضحة في وثيقة مجلس الأمن القومي رقم 68، والتي كان من الممكن تأجيلها لولا ذلك (تشيفيس وآخرون، 2024). يوضح هذا كيف وفرت الحرب الباردة الأساس المنطقي والدافع السياسي لنظرة ذاتية محددة وحازمة عالميًا وسياسة خارجية مقابلة. ومع ذلك، تُقر المصادر أيضًا بالتوترات الكامنة التي أوجدتها ضرورة الحرب الباردة. تشير مقالة المتحف الوطني للحرب العالمية الثانية إلى التناقض بين قيم الحرية والديمقراطية المروج لها والدعم الأمريكي المتكرر للأنظمة غير الديمقراطية التي اعتبرتها حلفاء ضروريين في الحرب ضد الشيوعية (المتحف الوطني للحرب العالمية الثانية، 2020). يشير هذا إلى أن الحرب الباردة، بينما عززت تصورًا ذاتيًا للقيادة العالمية والغرض الأخلاقي، فرضت أيضًا تنازلات عقّدت سردية الاستثنائية الأمريكية وتعزيز القيم، وهو توتر سيستمر في التأثير على النقاشات حول دور أمريكا في العالم، والأحادية القطبية والعولمة والتحديات المتطورة. كان انهيار الاتحاد السوفيتي عام 1991 بمثابة نهاية ثنائية القطبية التي سادت خلال الحرب الباردة، وبشر بعصر اعتبرت فيه الولايات المتحدة نفسها، وكان يُنظر إليها على نطاق واسع، على أنها القوة العظمى الوحيدة في العالم. ينصّ تعليق بروكينغز صراحةً على أنه بعد ترسيخ المكاسب الديمقراطية في أوروبا والانخراط في آسيا خلال تسعينيات القرن الماضي، “لا تُشكّل أي قوة… اليوم تهديدًا هيمنيًا لأوراسيا”، تاركةً الولايات المتحدة “القوة العالمية الحقيقية الوحيدة” (دالدر وليندسي، 2003). عزّزت هذه اللحظة الأحادية القطبية الشعور بالاستثنائية والقيادة الأمريكية، لكنها تزامنت مع تسارع قوى العولمة، التي أدخلت تعقيدات وتحديات جديدة على تصور الولايات المتحدة لنفسها ودورها العالمي. العولمة، كما وصفها دالدر وليندسي (2003)، ليست اقتصادية فحسب، بل هي أيضًا سياسية وثقافية وعسكرية وبيئية، وتتميز بسرعة وحجم غير مسبوقين للتفاعلات عبر الحدود. وبينما قدّمت فوائد كالنمو الاقتصادي وانتشار الأفكار الديمقراطية، جلبت معها أيضًا “مخاطر جديدة مروّعة”. وتُستشهد بهجمات الحادي عشر من سبتمبر كمثال صارخ على كيفية استغلال الجهات الفاعلة غير الحكومية للترابط العالمي لضرب جوهر القوة الأمريكية. تشمل الأمثلة الأخرى العدوى الاقتصادية الناجمة عن المضاربة بالعملة في الخارج، والتي أثرت على الوظائف الأمريكية، والتهديدات السيبرانية، والقضايا العابرة للحدود الوطنية مثل تغير المناخ (دالدر وليندسي، 2003). هذه الطبيعة المزدوجة للعولمة – التي تخلق فرصًا ونقاط ضعف في آن واحد – فرضت إعادة تقييم للتصور الأمريكي عن الذات. فالولايات المتحدة، على الرغم من قوتها، لم تكن بمنأى عن الاضطرابات العالمية؛ بل إن قوتها نفسها جعلتها “جاذبًا للإرهاب” (دالدر وليندسي، 2003، نقلاً عن بيتس). ونتيجةً لذلك، تلاشى التمييز بين السياسة الداخلية والخارجية، مما تطلب سياسة خارجية عالمية النطاق، تركز على إدارة الترابط، ومكافحة التهديدات الجديدة، وتعزيز الاستقرار، ليس فقط من باب الإيثار، بل من باب المصلحة الذاتية في عالم مترابط (دالدر وليندسي، 2003). وقد مثّل هذا تحولًا في التصور الأمريكي عن الذات من مجرد قيادة “العالم الحر” ضد عدو واحد إلى إدارة نظام عالمي معقد محفوف بتحديات متنوعة.
الأزمة كمحفز للتغيير الاستراتيجي:
من الملاحظات المتكررة في الدراسات التحليلية الدور المهم الذي تلعبه الأزمات في تسهيل التحولات الكبرى في استراتيجية السياسة الخارجية الأمريكية، وبالتالي في تصور أمريكا لدورها العالمي. يُخصص تقرير مؤسسة كارنيغي، “التغيير الاستراتيجي في السياسة الخارجية الأمريكية”، تحليلاً مُعمّقاً لهذه الظاهرة، مُجادلاً بأن “الأزمات مُحفّز ومُيسّر كبير للتغيير” (تشيفيس وآخرون، ٢٠٢٤). تُنشئ الأزمات “مرونة سياسية”، مما يفتح آفاقاً جديدة للتحولات الاستراتيجية التي قد تواجه، لولا ذلك، مقاومة بيروقراطية أو سياسية لا تُقهر. ويستشهد التقرير بتأثير الحرب الكورية في ترسيخ استراتيجية مجلس الأمن القومي رقم ٦٨، ودور هجمات ١١ سبتمبر في تمكين إدارة بوش من التركيز على مكافحة الإرهاب وتعزيز الديمقراطية في الشرق الأوسط كأمثلة رئيسية (تشيفيس وآخرون، ٢٠٢٤). يتماشى هذا مع تعليق بروكينغز، الذي يُحدد أحداث الحادي عشر من سبتمبر على أنها إيذان بنهاية الحقبة الجيوسياسية لما بعد الحرب الباردة وظهور حقبة جديدة من “السياسة العالمية” تتطلب إعادة تقييم لدور أمريكا (دالدر وليندسي، 2003). ووفقًا لكارنيجي، تُسهّل الأزمات التغيير من خلال توليد دافع عاطفي للعمل، وإجبار إعادة تقييم الافتراضات عندما تثبت عدم كفاية الأطر القائمة، وخلق شعور بالإلحاح يتغلب على الجمود (تشيفيس وآخرون، 2024). في حين أن الأزمات لا تُملي استجابات سياسية محددة – فالبدائل موجودة دائمًا، وتتشكل وفقًا للثقافة الاستراتيجية والأفكار الموجودة مسبقًا – إلا أنها تخلق مناخًا متساهلًا حيث يصبح التغيير الكبير ممكنًا سياسيًا. في المقابل، يشير التقرير إلى محاولة كارتر الفاشلة لسحب القوات من كوريا الجنوبية كمثال على صعوبة تحقيق تغيير جذري “في غياب أزمة لتحفيز وحشد الدعم” (تشيفيس وآخرون، 2024). يشير هذا إلى أنه في حين أن التصور الأمريكي عن الذات قد يتطور تدريجيًا، فإن إعادة توجيه دوره العالمي المُتصور غالبًا ما تتطلب صدمة الأحداث الخارجية للتغلب على المقاومة الكامنة للتغيير داخل النظام السياسي الأمريكي. الديناميكيات الداخلية، والقيود، والتناقضات. في حين تهيمن السرديات الكبرى للاستثنائية الأمريكية والقيادة العالمية على جزء كبير من الخطاب، تُقر المصادر التي تم تحليلها أيضًا بأن التصور الأمريكي عن الذات والسياسة الخارجية يتشكلان، وغالبًا ما يُقيّدان، بديناميكيات داخلية معقدة وتناقضات جوهرية. يُشدد تقرير مؤسسة كارنيغي على أن التغيير الاستراتيجي الجذري ليس حكرًا على الرئيس فحسب، بل يتضمن التعامل مع البيروقراطية الحكومية، والكونغرس، والرأي العام، ومجتمعات الخبراء التي غالبًا ما تكون مقاومة (تشيفيس وآخرون، 2024). تم تحديد المقاومة البيروقراطية، الناجمة عن الجمود التنظيمي أو التحيزات المعرفية أو المصالح المتنافسة، كعقبة شائعة، مستشهدًا بأمثلة من تنفيذ NSC-68 إلى تخطيط حرب العراق (Chivvis et al.، 2024). وبالمثل، يلعب الكونجرس دورًا حاسمًا، ولكنه متغير، وقادر على تمكين (على سبيل المثال، تمويل NSC-68 بعد كوريا) ومنع (على سبيل المثال، انسحاب كارتر من كوريا) التحولات السياسية الرئيسية، متأثرة بالحزبية والسياق السياسي والعلاقات التنفيذية التشريعية (Chivvis et al.، 2024). الرأي العام، على الرغم من أنه غالبًا ما يكون غير مباشر في تأثيره، يعمل أيضًا كقيد أو ممكّن. يشير تقرير كارنيجي إلى كيف ضغط تآكل الدعم العام بشكل كبير على تغييرات السياسة خلال حرب فيتنام، بينما سهّل الدعم الأولي القوي حرب العراق، فقط ليتراجع لاحقًا (Chivvis et al.، 2024). وهذا يسلط الضوء على حدود السلطة الرئاسية؛ حتى القادة المُصمّمون يواجهون عقباتٍ كبيرة في تنفيذ تغييراتٍ كبيرةٍ في الدور المُتصوّر لأمريكا، مما يُشير إلى أن التدرّج غالبًا ما يكون أكثر جدوىً من التحوّلات الجذرية (تشيفيس وآخرون، ٢٠٢٤). علاوةً على ذلك، فإنّ التناقض الكبير الذي أبرزته، لا سيما مقالة المتحف الوطني للحرب العالمية الثانية، هو التوتر بين قيم الحرية والديمقراطية المُعتنقة التي تُشكّل جوهر التصور الأمريكي للذات والإجراءات البراغماتية، المُتناقضة أحيانًا، المُتّخذة على الساحة العالمية، لا سيما خلال الحرب الباردة. يُجسّد دعم الأنظمة غير الديمقراطية لمواجهة الشيوعية كيف يُمكن أن تُؤدي الضرورات المُتصوّرة للحفاظ على القوة العالمية إلى تسوياتٍ تحدّت صورة الأمة عن نفسها كداعمٍ ثابتٍ لقيمها الأساسية (المتحف الوطني للحرب العالمية الثانية، ٢٠٢٠). يُعدّ هذا التعقيد الداخلي والفجوة بين المُثُل والأفعال عناصرَ حاسمةً في فهم الفروق الدقيقة في التصور الأمريكي للذات بما يتجاوز التصويرات المُوحّدة.
مفارقة: الثقة مقابل النقد الذاتي
وأخيرًا، ثمة موضوع دقيق ولكنه بالغ الأهمية برز من الأدبيات، وسلطت عليه الضوء مقالة معهد أبحاث السياسة الخارجية الأمريكية (FPRI) بشكل خاص، وهو الطبيعة المتناقضة للتصور الأمريكي للذات، والذي يتميز بميل مستمر نحو النقد الذاتي العلني، إلى جانب ثقة راسخة، غالبًا ما تكون غير معلنة، في قيم الأمة وقدراتها ومصيرها. يلاحظ ديفيد أيزنهاور (2007) أن الأمريكيين غالبًا ما يعيشون “في حالة من القلق الجاد إزاء المشاكل المتعددة التي تُصر الشخصيات العامة على وجودها حولنا”، والتي تُذكر باستمرار بالانقسامات المجتمعية وإخفاقات السياسات. ويشير إلى أن “التاريخ الأمريكي يُقدم عادةً كقصة وعود لم تُحقق، ليس كقصة تُحتفى بها، بل كإرث يجب استعادته”. ورغم هذا التوجه النقدي الظاهري، يُجادل أيزنهاور بأن “الحقيقة هي أن الأمريكيين محظوظون ويدركون ذلك”. إنهم مبدعون، قلقون، متفائلون، وغير راغبين في تبادل الأدوار مع أي شخص في أي مكان” (أيزنهاور، 2007). ويشير إلى جيل الحرب العالمية الثانية تحديدًا باعتباره تجسيدًا لهذه الثقة – ثقة في قيمهم ومؤسساتهم وقدرتهم على مواجهة التحديات وإيمانهم بالتقدم وبأمريكا نفسها. ويشير إلى أن هذه الثقة الكامنة تُفسر “سجل أمريكا الثابت من النمو والتقدم” على الرغم من الخطاب العام المستمر الذي يُركز على المشاكل وأوجه القصور (أيزنهاور، 2007). وتشير هذه المفارقة إلى أن التصور الأمريكي للذات الذي يُحرك دورها العالمي ليس مجرد سردية انتصارية، بل هو تفاعل أكثر تعقيدًا بين الطموح والنقد الذاتي والإيمان الراسخ بنقاط القوة والإمكانات الأساسية للأمة، وهو اعتقاد عززته بقوة نتائج الحرب العالمية الثانية واستمر خلال التحديات اللاحقة.
الخلاصة:
ترسم الأدبيات المستمدة من المؤسسات الأمريكية صورة معقدة للتصور الأمريكي للذات فيما يتعلق بقيمها السياسية ودورها العالمي منذ الحرب العالمية الثانية. لا يمكن إنكار الأثر التحويلي للحرب، إذ نقلت الأمة من موقف انعزالي إلى قيادة عالمية حازمة، مدعومة بقوة اقتصادية وعسكرية لا مثيل لها. وقد صُمم هذا الدور القيادي باستمرار من منظور الاستثنائية الأمريكية، مع مهمة مُتصورة لتعزيز قيم جوهرية كالديمقراطية والحرية، على الرغم من أن الحرب الباردة والوقائع الجيوسياسية اللاحقة غالبًا ما أدت إلى إجراءات براغماتية خلقت توترًا مع هذه المُثل. شكلت القوة الاقتصادية أساسًا وأداةً لهذا الانخراط العالمي، بينما شكّلت الأزمات الكبرى مُحفزاتٍ لإعادة توجيه استراتيجية هامة. طرحت حقبة ما بعد الحرب الباردة تحدياتٍ جديدة من خلال العولمة، مما تطلب تحولًا نحو إدارة الترابط والتهديدات العابرة للحدود الوطنية. وطوال هذه الفترة، قيّدت الديناميكيات الداخلية، بما في ذلك العمليات البيروقراطية ونفوذ الكونغرس والرأي العام، وشكّلت تنفيذ الدور العالمي المُتصور لأمريكا. وأخيرًا، ثمة مفارقة مُستمرة: ميلٌ نحو النقد الذاتي العام إلى جانب ثقةٍ راسخةٍ بقيم الأمة الأساسية وقدراتها. إن فهم هذا التطور، الذي غالباً ما يكون متناقضاً، في تصور الذات أمر بالغ الأهمية لتحليل السياسة الخارجية الأميركية وتفاعلاتها مع بقية العالم منذ عام 1945 وحتى يومنا هذا.