كتاب “معارك التنويريين والأصوليين بأوروبا”: ما جوهر فلسفة التنوير الأوروبية؟ بقلم صلاح الدين ياسين
للاشتراك بالنشرة البريدية اضغط هنا
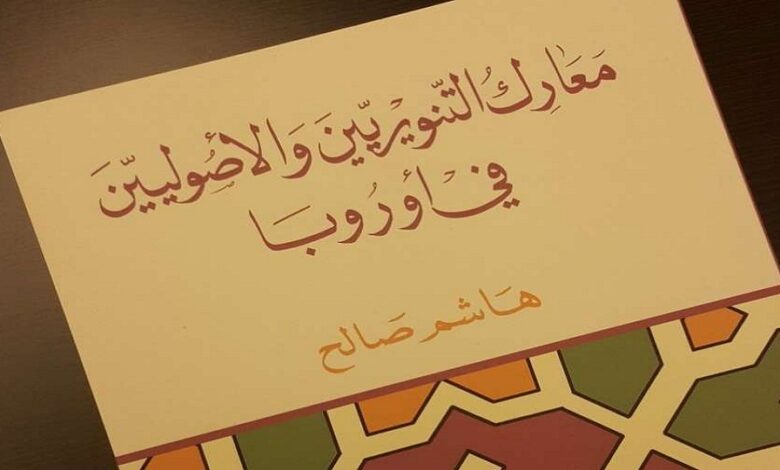
يعد هذا الكتاب من أبرز الأعمال التي عنيت بدراسة وتفكيك المرتكزات والمنطلقات الأساسية لعصر التنوير الفكري بأوروبا والذي يمكن وصفه بالرحم التي تمخضت عنها الحضارة الأوروبية الحديثة، حيث عرض مؤلفه للإسهامات الفكرية النوعية التي جاد بها فلاسفة التنوير والمعارك الكبرى التي خاضوها ضد أصوليي أوروبا في سبيل انتزاع أمتهم من براثن العصور الوسطى المظلمة ومن ثم دخول غمار عصر الحداثة.
لقد نشأ عصر التنوير الفكري في أوروبا خلال القرن 17 كرد فعل على التعصب الديني والأصولية الظلامية، إذ كانت الكنيسة تمارس وصاية مطلقة على عقول وأرواح الناس. ولذلك فقد نادى فلاسفة التنوير ببلورة إيمان عقلاني حر قائم على التسامح الديني وحرية الضمير والمعتقد، بما مفاده تحويل الإيمان إلى مسألة شخصية مرتبطة بضمير الفرد واعتقاده، فالفرد حر بأن يعتقد ما يشاء أو لا يؤمن على الإطلاق وفق ما يمليه عليه اقتناعه الشخصي دون إكراه أو إجبار من أية سلطة كانت.
كما أعاد مفكرو التنوير صياغة العلاقة بين الدين والأخلاق، بحيث نشأ خلال تلك الحقبة تصور جديد عن الأخلاق العلمانية أو ما يسمى بعلمنة الأخلاق عبر الفصل بين الأخلاق والدين في تحد صارخ للكنيسة، ومؤدى ذلك أنه ليس ضروريا أن تكون مؤمنا أو متدينا لكي تتحلى بالأخلاق الحميدة. وقد ضرب الفلاسفة مثلا على ذلك بفساد طبقة رجال الدين الذين لم يمنعهم تدينهم من استغلال عامة الناس البؤساء والمعدمين والإستئثار لأنفسهم بالثروات والخيرات. كما أن علمنة الأخلاق تعني أيضا وجوب معاملة جميع الناس معاملة أخلاقية متساوية وليس فقط بني جلدتنا الذين يشاركوننا ديننا أو طائفتنا. غير أن ما سبق لا يعني بالضرورة أن فلاسفة التنوير كانوا ملاحدة أو معادون للأديان، ذلك أن معظمهم كان يؤمن بوجود إله متعال حكيم بوصفه المهندس الأعظم للكون وواضع قوانين الطبيعة والناموس الكوني.
وعطفا على ذلك، شرع فلاسفة الأنوار في تحرير فعل المعرفة ذاته من المرجعية اللاهوتية المقدسة وسلطة الماضي ومن ثم تأسيسه على العقل والتجربة المحسوسة، ومن هنا يمكن تفسير نشأة الإبستمولوجيا التي تعني حرفيا علم المعرفة أو نظرية المعرفة. وما التنوير عند الفيلسوف الألماني كانط إلا القدرة على استخدام عقولنا والتفكير بحرية وباستقلال عن سلطة الآخرين. فالتنوير بنظر الكاتب يسبق التحرير، بمعنى أن نهضة الفكر تكون سابقة على التقدم السياسي والمادي الذي لا يأتي من فراغ وإنما يفترض وجود حاضنة فكرية تشكل نواة له.
والحال أنه إذا كان أصوليو أوروبا قد سعوا إلى تأكيد ذاتهم في مواجهة أنوار الحداثة عن طريق الإستنجاد بسلطة الماضي، فإن الحداثة سعت إلى فرض وجودها بالإستناد إلى شرعية الإنجاز والإيمان بفكرة التقدم والوعد بمستقبل أفضل يضمن الرفاه والسعادة للبشرية جمعاء. والواقع أنه لا يمكن الفصل بين التقدم المادي والتقدم الفكري كما يقول فولتير، ذلك أن الأفكار المستنيرة ما تلبث أن تنتشر في سياق تقدم الحياة الصناعية والتجارية (لا يفوتنا التنويه هنا بأن فلاسفة التنوير قدموا عمليا للبورجوازية الصاعدة أيديولوجية تمدها بأسباب وجودها وبقاءها)، هذا في حين أن أخلاقيات الزهد والتعفف والتواكل التي شجعت عليها الكنيسة كانت تتلاءم على وجه الخصوص مع أوضاع التخلف الإجتماعي التي كانت سائدة (فقر، جهل، أمية، أمراض، أوبئة…).
وإذا كان فلاسفة أوروبا في القرن 18 قد انصرف همهم الأساسي إلى نقد وهدم العقائد القديمة كمدخل ضروري لولوج عصر الحداثة، فإن تنويريي القرن 19 وفي مقدمتهم “سان سيمون” الذي ينظر إليه على أنه مؤسس العلوم الإنسانية وتلميذه “أوغست كونت” قد اعتبروا بأنه آن الأوان لكي نترك مرحلة النقد والتفكيك خلف ظهورنا وندشن مرحلة البناء والتنظيم من خلال العمل على إرساء أسس نظام اجتماعي واقتصادي جديد قائم على الإيمان الأعمى والمطلق بممكنات وآفاق العلم والصناعة لكي ينهض على أنقاض النظام الإقطاعي الزراعي القديم الذي كان علامة على تخلف أوروبا، وهذا هو جوهر الفلسفة الوضعية لرائدها أوغست كونت والذي يعد أيضا مؤسس السوسيولوجيا أو علم الإجتماع الحديث.
والحال أن الدفع بـ الفلسفة الوضعية المجردة من أي مضمون عاطفي أو وجداني إلى حدودها القصوى هو الذي أفضى إلى حدوث تشوهات في مبادئ التنوير الأصلية وحرفها عن جوهرها، بحيث أمعنت الحضارة الغربية الحديثة في النزعة المادية الإستهلاكية المحضة من دون أن تنطوي على أي مضمون إنساني أو روحي، وهو ما أفضى لاحقا إلى ظهور نظرية ما بعد الحداثة أو نقد الحداثة في منتصف القرن 20 كمحاولة لتصويب وتقويم الإنحرافات التي حصلت في مسار الحداثة وإضفاء بعد أخلاقي وإنساني عليها.
وبالرغم من أن الكاتب يعتبر بأن نقد الحداثة أو بالأحرى الإنحرافات التي شابت مسارها يعد ضرورة تاريخية في الغرب الصناعي لضمان التوازن بين التقدم المادي والجانب القيمي والروحي الذي لا يقل أهمية عن سابقه، فإنه يحذر في الوقت نفسه من نقل نظريات ما بعد الحداثة إلى البيئة العربية لكونها غير مهيأة بعد لاستقبالها واستيعابها، ذلك أن عملية النقد والتفكيك وإعادة التركيب تكون لاحقة للتجربة والممارسة العملية وليس العكس، والحال أن عالمنا العربي والإسلامي لم يدخل بعد غمار التحديث ولازلنا نعيش مرحلة ما قبل الحداثة.











