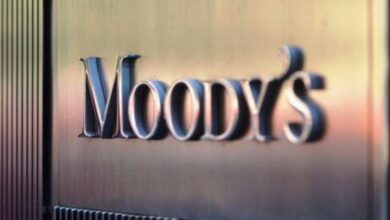حِينَ تَفقُدُ الشعاراتُ معناها: من النضالِ إلى الطقوسِ المُطَمئِنَة | بقلم د. بيار الخوري
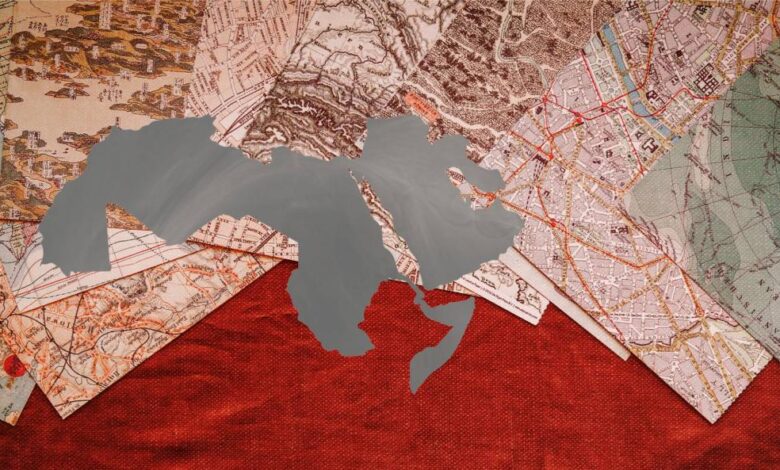
غالبًا ما بتنا نُصاب، نحن العرب، بالإرهاق عند مواجهة مصطلحات مثل “الوحدة” و”الصمود” و”العروبة” و”الاشتراكية” و”مناهضة الإمبريالية” وحتى “النصر”.
لقد استَخدَمَت الحركاتُ الثورية والجهادية والأنظمة العربية، التي اصطُلِحَ على تسميتها بالراديكالية، هذه الشعارات تقليديًا كرموز للنضال والاستنهاض، لكن ببعضِ التحفُّظِ يُمكِنُ النظرُ إليها الآن كطقوسٍ بلاغية تُرَدَّدُ في كافةِ الظروف والحالات والازمنة.
المُفارَقةُ المؤلمة أنَّ بعضَ هذه الشعارات، حين تُرفَعُ اليوم، تُطَمئِنُ الخصمَ أكثر مما تُقلقه. فالتاريخ القريب والبعيد أظهر، بما يكفي من الأدلّة، أنَّ كثرةَ تردادِ هذه العبارات لا تعني بالضرورة قوّةً في الموقف، بل قد تكونُ غطاءً لضُعفٍ معرفي، أو تبريرًا لجمودٍ سياسي، أو حيلةً لإخفاءِ غيابِ الرؤية.
تظلُّ المبادئ الأساسية التي تقومُ عليها هذه القِيَم نبيلة، وإن بدا رفعها بشكلٍ مُستَقلٍ غير صحيح. بل على العكس تمامًا: فقد نشأت هذه الشعارات من قضايا مشروعة، وارتبطت بنضالاتٍ واقعية خلال المراحل المفصلية من التاريخ العربي.
تتضّحُ المشكلة عندما يَفقُدُ الشعارُ معناه الحقيقي، ويتحوّلُ إلى رمزٍ فارغ، يَنفَصِلُ عن الفعلِ الهادف، ويُستَخدَمُ لكبتِ التطوُّرِ الطبيعي للمجتمع.
شكلت هزيمة العام 1967 نقطةَ تحوُّلٍ مهمّة أظهرت بوادرَ هذا الانفصال. وُعِدَت الشعوبُ العربية بالحرية والكرامة، لكنها وجدت نفسها تُواجِهُ خسارةً فادحة كشفت عن واقعها الحقيقي. في تلك الحقبة، انتقدَ المُفَكّران صادق جلال العظم وياسين الحافظ الأداءَ السياسي والإطار الفكري الذي سانده، والمصطلحات الإيديولوجية التي غطّت تناقُضاته. وأكّدَ المُفكِّران أنَّ للهزيمةِ أبعادًا عسكرية وتداعياتٍ فكرية، لأنَّ الشعوبَ استساغت هذه الشعارات لتجنُّب مواجهة نفسها فيما استخدمتها القوى المُسَيطِرة لاعادةِ إنتاجِ شرعيتها.
شهدت الفترةُ، من سبعينيات القرن الماضي وحتى الآن، تحوّلاتٍ أكثر تعقيدًا. أصبحت القوى التي تعتمد تلك الشعارات أكثر مهارةً في استخدامِ هذه الشعارات للحفاظ على قوّتها الداخلية بدلًا من إلهام العمل على المهام الوطنية التاريخية. باسم “المعركة الكبرى”، سُحِقَت معارك أصغر: حرية التعبير، والعدالة الاجتماعية، وبناء الدولة. لقد أَجَّلَ السعي وراء “الأهداف الكبرى” العديدَ من التغييرات التي أدّى غيابُها إلى زعزعةِ أركانِ أوطانٍ بكاملها.
تتجلّى الفجوة القائمة بين الوعودِ المَنطوقة والنتائج الفعلية بوضوح في الفرق بين الشعارات والمآلات العملية للتشبُّث بها والوقوف عند حدودها حصرًا . لم يَعُد هناك وعدٌ مجتمعي مُحدّد يشتقُّ من التعبيرات القوية.
فهل تحوّلت الشعارات طقوسًا مُطَمئِنة تُعيدُ إنتاجَ العلاقة بين هذه القوى وجمهورها… والأنكى مُطَمئِنة لأعدائها، طالما أنها تُواجِهُ مجتمعاتٍ فقدت الديناميات اللازمة للتطوُّر؟
وهل تحوَّلَ الغرضُ الحقيقي من هذه الشعارات من توفيرِ عُمقٍ استراتيجي للتغيير إلى توفيرِ منطقةِ راحةٍ للمُتَمَسِّكين بلغة “تصلح” لكلِّ الظروف بدونِ وَعدٍ للمستقبل؟