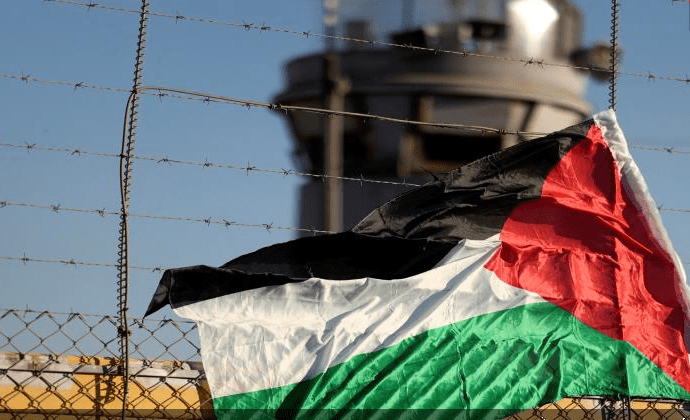
بينما يُرَكّزُ الاهتمامُ الدولي على الحَربِ في غزة، فإنَّ الضفةَ الغربية لا تزالُ غارقةً في عُنفٍ مُتَوَسِّع. الوَضعُ السياسي والأمني هناكَ يتدهورُ منذ سنوات عدّة، وبلغ ذروته في تموز (يوليو) بهجومٍ إسرائيلي كبير على الجماعات الفلسطينية المُسلّحة التي كانت مُتَحَصِّنةً في مخيّمِ جنين للاجئين. لكنَّ الهجومَ غير المسبوق الذي شنّته حركة “حماس” في السابع من تشرين الأول (أكتوبر) وما تلاه من ردودٍ إسرائيلية انتقامية تردّدت أصداؤه بعُمقٍ في الضفة الغربية، الأمرُ الذي أدّى إلى تعميقِ الغضب الشعبي الفلسطيني تجاه إسرائيل، وتفاقُمِ الدوافع القائمة لانعدامِ الأمنِ وعَدَمِ الاستقرار السياسي.
خلالَ الأشهُرِ الستة الماضية، قتلت إسرائيل 434 فلسطينيًا، من بينهم 106 أطفال على الأقل، في الضفة الغربية، بما فيها القدس الشرقية. وتمَّ اعتقالُ آلافٍ آخرين. وباسمِ الأمن، شدّدت إسرائيل القيودَ على الحركة، وأقامت العشرات من نقاط التفتيش الجديدة ومنعت الوصول إلى القرى. ألغت حكومة تل أبيب 200 ألف تصريح لتمكين سكان الضفة الغربية من العمل في إسرائيل، ما أدّى إلى زيادة معدّلات البطالة وتكبّدِ الاقتصاد الفلسطيني ما يُقَدَّر بنحو 2.3 ملياري دولار.
في الوقت نفسه، استخدمت حركة الاستيطان الإسرائيلية الصراعَ في غزة كغطاءٍ سياسي لتسريعِ وتوسيعِ ضَمِّ إسرائيل للأراضي الفلسطينية. ووفقًا لمنظّمةِ مُراقَبةِ الاستيطان الإسرائيلية، “السلام الآن”، فقد شهدَت الأشهر الماضية طفرةً غير مسبوقة في الأنشطة الاستيطانية، بما في ذلك بناء بؤرٍ استيطانية وطُرُقٍ وأسوارٍ وحواجز طُرُق. وقد قوبل ذلك بزيادةٍ حادةٍ في عملياتِ الإخلاءِ وارتفاعِ مُعدّل ومستوى العُنفِ ضد المجتمعات الفلسطينية الضعيفة من قبل المُستوطِنين. وردًّا على ذلك، فرضت الولايات المتحدة وأوروبا عقوباتٍ على عددٍ صغيرٍ من المُستَوطنين المُتَطرّفين.
إنَّ الإجراءاتَ الإسرائيلية المُستَفِزّة تدفعُ وتؤدّي إلى تنشيطِ الجماعات الفلسطينية المُسَلّحة في جميع أنحاء الضفة الغربية التي تتحدّى سيطرة السلطة الفلسطينية وتنخرِطُ في هجماتٍ مُنتَظِمة ضد القوات الإسرائيلية والمستَوطِنين. وترتبطُ أقوى هذه الجماعات ب”الجهاد الإسلامي”، و”كتائب شهداء الأقصى” التابعة لحركة “فتح” التي تستفيدُ من علاقاتٍ وثيقةٍ مع الأجهزةِ الأمنية التابعة للسلطة الفلسطينية. وبينما حَرّضَت “حماس” الفلسطينيين على الانتفاضة، فإنَّ وجودَ جناحها المُسَلَّح محدودٌ أكثر في الضفة الغربية بسببِ الحملات الأمنية القمعية المُستَمرّة التي تقوم بها إسرائيل والسلطة الفلسطينية ضدها. وغالبًا ما تعمل هذه الجماعات المسلّحة معًا، وتُوَسِّعُ وجودها على الأرض بفضلِ ارتفاعِ الدَعمِ الشعبي للمقاومة المسلحة على مدى السنوات القليلة الماضية والتهميش المُتزايد للسلطة الفلسطينية. وهي تُسيطرُ الآن على العديد من مخيمات اللاجئين في الضفة الغربية.
أدّت التوغّلات العسكرية الإسرائيلية الليلية في البلدات الفلسطينية ومُخيَّمات اللاجئين، بالتعاون مع قوات الأمن التابعة للسلطة الفلسطينية، إلى مقتلِ وإصابةِ عشراتِ المسلّحين. ولكن بعد مرور أكثر من عامين على شنِّ حملةٍ أمنيةٍ ضد الجماعات المسلّحة في جنين، أدّى استخدامُ إسرائيل غير المُتناسب للقوة، بما في ذلك الغارات الجوية والتدمير الغاشم للبُنية التحتية الفلسطينية، إلى زيادة الغضب الفلسطيني والتأكيد على عجز السلطة الفلسطينية عن حماية مواطنيها.
إنَّ أزمةَ شرعية السلطة الفلسطينية هي في جُزءٍ منها من صنعها. وبما أنها لم تُجرِ انتخابات منذ العام 2006، فإنَّ الفلسطينيين يعتبرونها بعيدةً من الواقع وفاسدةً وسلطوية. وفي غيابِ أيِّ أفُقٍ سياسي قابلٍ للتطبيق للاستقلال الفلسطيني، فإنَّ غالبية الفلسطينيين تعتبرها عبئًا على الحركة الوطنية الفلسطينية. يُريدُ الآن 93% من الفلسطينيين في الضفة الغربية، وهي أعلى نسبة على الإطلاق، استقالة الرئيس محمود عباس. وتؤدّي أزمةُ الموازنة المُتصاعدة الناجمة عن العقوبات الإسرائيلية والانخفاض الحاد في دعم المانحين إلى تفاقُمِ التحدّيات الداخلية التي تُواجهها السلطة الفلسطينية. ويأتي ذلك على خلفيةِ احتدامِ المُنافسة بين كبار شخصيات “فتح” لخلافة عباس البالغ من العمر 88 عامًا.
لقد استفادت “حماس” أكثر من غيرها من الخَلَلِ الوظيفي المُتزايِد في السلطة الفلسطينية، والخصومات الداخلية في “فتح”، وتصاعُدِ العُنفِ الإسرائيلي-الفلسطيني. وعلى الرُغمِ من جهودِ إسرائيل والسلطة الفلسطينية، لا تزال “حماس” راسخةً في الضفة الغربية، حيث وافق 71% من الفلسطينيين على قرارها بشنِّ هجومها على إسرائيل في 7 تشرين الأول (نوفمبر). وهي الآن الفصيل الفلسطيني الأكثر شعبية، مُتَقَدِّمة على منافستها “فتح”.
وتنظرُ معظم الدول، باستثناءِ إسرائيل، إلى عودة السلطة الفلسطينية إلى غزة باعتبارها المفتاح لتحقيقِ الاستقرارِ والتعافي في مرحلة ما بعد الصراع. وبوسعِ السلطة الفلسطينية أن تحشدَ سبعين ألفًا من موظّفي الخدمة المدنية وقوات الأمن التابعة ل”فتح” الذين ظلوا على قوائم رواتبها منذ طردتها “حماس” من غزة في العام 2007. وبوسعها أيضًا أن تُحاوِلَ استمالة عناصر من الهياكل الحاكمة ل”حماس”، بما في ذلك العديد من أعضاء “حماس” البالغ عددهم 45 ألفًا. موظَّفو الخدمة المدنية الذين تعاملوا مع كلِّ شيءٍ بدءًا من جمع النفايات إلى الشرطة المحلية منذ سيطرة الحركة على قطاع غزة في العام 2007، والذين سَبَقَ أن خضعوا للفحص والموافقة من قبل إسرائيل كجُزء من حُزَمِ الدعم المالي القطرية السابقة.
وبما أنَّ “حماس” تبدو حتى الآن قادرةً على الصمود في وجه الهجوم العسكري الإسرائيلي، فإنَّ السلطة الفلسطينية سوف تحتاج إلى قبولها للعودة إلى غزة. وفي غياب موافقة “حماس”، فإنَّ محاولة استعادة أمن السلطة الفلسطينية وحُكمها في غزة يمكن أن تؤدّي إلى حربٍ أهلية فلسطينية في الضفة الغربية. ومع ذلك، فإنَّ استعدادَ الحركة الإسلامية للتنازل عن سيطرتها على غزة للسلطة الفلسطينية التي تُهيمِن عليها “فتح” قد يتطلّبُ صفقةً أوسع لإصلاح منظمة التحرير الفلسطينية والسلطة الفلسطينية التي أنشأتها، وتوسيع التمثيل السياسي، وإجراء انتخابات وطنية في نهاية المطاف.
وتخشى الحكومات الغربية أن يؤدّي أيُّ اتفاقٍ بين “فتح” و”حماس”، ناهيك عن إجراءِ انتخاباتٍ حرّة ونزيهة، إلى زيادة تمكين الحركة الإسلامية، وخلق المزيد من الاضطرابات السياسية والأمنية. وبدلًا من ذلك، اتخذت واشنطن وشركاؤها الأوروبيون نظرةً أضيق للجهود الرامية إلى تنشيط السلطة الفلسطينية. كان العمود الفقري لذلك هو سعيهم إلى تشكيل حكومة تكنوقراط جديدة بقيادة رئيس الوزراء محمد مصطفى، وهو خبير اقتصادي تلقّى تعليمه في الولايات المتحدة وأحد المقربين من عبّاس. وكان الأخير عيَّنَ مصطفى رئيسًا للوزراء في آذار (مارس)، ثم وافق بعد ذلك على تشكيل حكومةٍ جديدة بموجبِ مرسومٍ رئاسي في 28 آذار (مارس).
وقد تنجح حكومة مصطفى، التي تضمُّ محترفين ووزراء أكفّاء، في تعزيز ثقة الغرب وتمويله، بل وربما تبدأ بعض إصلاحات الحُكم. ولكنها لا تستطيع بمفردها أن تَعمَلَ وتنجحَ في عَكسِ مسارِ عدم وجود الديموقراطية لدى السلطة الفلسطينية، ما أفقدها شرعيتها، بالإضافة إلى تراجع شعبيتها نتيجةً للاحتلال الإسرائيلي والتصرّفات التي اتخذها عباس لتعزيز سلطته وإقصاءِ خصومه السياسيين. ولا يبدو أنَّ هذا يُشيرُ إلى أيِّ تقارُبٍ وشيكٍ مع “حماس” يُمكِنُ أن يُمَهّدَ الطريق لعودة السلطة الفلسطينية إلى غزة. بدلًا من ذلك، رفضت “حماس” –جنبًا إلى جنب مع حركة “الجهاد الإسلامي”، والجبهة الشعبية لتحرير فلسطين، والمبادرة الوطنية الفلسطينية بقيادة مصطفى البرغوثي– الحكومة الجديدة، مُحذّرةً من أنها ستؤدّي إلى تعميق أزمة قيادة السلطة الفلسطينية.
مع ذلك، فقد انخَرَطَ بعضُ الشخصيات البارزة في “فتح” في محادثاتٍ مُنفَصلة خاصة مع “حماس”. كان أبرز هؤلاء محمّد دحلان، الناشط المخضرم في “فتح” والرئيس السابق لجهاز الأمن الداخلي التابع للسلطة الفلسطينية والذي تمَّ نفيه إلى أبو ظبي بعد خلافه مع عباس. وقد انضم إلى ناصر القدوة، وزير الخارجية الفلسطيني الأسبق وابن شقيق ياسر عرفات. وكلاهما يُعارِضان عبّاس ويُطالبان باستبداله بإطارِ قيادةٍ وطني مؤقت جديد لإعادةٍ حكومةٍ فلسطينية مُوَحَّدة وإصلاحيّة إلى غزّة.
يُمارِسُ دحلان والقدوة ضغوطًا على الحكومات الأجنبية للحصول على الدعم. لكنَّ شعبيتهما العامة محدودة. كما إنهما لم يحصلا حتى الآن على دَعمِ وسطاء السلطة المؤثّرين الآخرين، مثل الأمين العام لفتح جبريل الرجوب والأمين العام لمنظمة التحرير الفلسطينية حسين الشيخ، اللذين لديهما طموحات قيادية خاصة بهما. لكن موقف مروان البرغوثي سيكون الأكثر أهمية. وهو أحد قادة “فتح” المُخضرَمين يقضي حاليًا خمسة أحكام بالسجن مدى الحياة في سجنٍ إسرائيلي بسبب تورّطه المزعوم في أعمال العنف المسلح خلال الانتفاضة الثانية. وفي حين يظل البرغوثي الشخصية الفلسطينية الأكثر شعبية، وفقًا لاستطلاعات الرأي، فقد امتنعَ حتى الآن عن التدخّل في عملية إبرام الصفقات الداخلية ل”فتح” لخلافة عباس.
وفي ظلِّ احتمالاتٍ ضئيلة لنشوءِ قيادةٍ فلسطينية شاملة تحظى بدعمٍ شعبيٍّ واسع النطاق، وفي غيابِ آليةٍ لإدارة عملية خلافة عباس، فإنَّ النظامَ السياسي الفلسطيني يتجه نحو أزمة عميقة وقد تكون وجودية. وإلى جانبِ ارتفاعِ مستويات العنف وتفاقم حالة الطوارئ الاقتصادية، فإنَّ المسارَ المتدهور في الضفة الغربية سيزيدُ من تعقيد الجهود الرامية إلى التوصّلِ إلى وقفٍ دائمٍ لإطلاق النار في غزة وإحياءِ مسارٍ سياسي إسرائيلي-فلسطيني ذي معنى.











