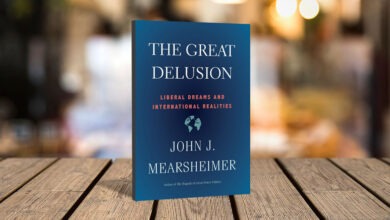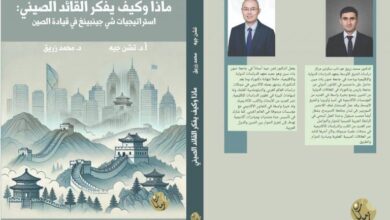نشرت مجلة “فورين أفيرز” الأميركية مقالًا للمؤرخ “تشارلز كينج” كتب في افتتاحيته أنه في 11 نوفمبر 1980، كانت سيارة مليئة بالكتاب تشق طريقها على طول طريق سريع ممطر إلى مؤتمر في مدريد. وكان موضوع الاجتماع يتمحور حول حركة حقوق الإنسان في الاتحاد السوفييتي، وفي السيارة كان بعض نشطاء الحركة الذين عانوا طويلًا: فلاديمير بوريسوف وفيكتور فاينبرغ، وكلاهما تعرضوا لإساءة المعاملة المروعة في مستشفى للأمراض النفسية في لينينغراد؛ الفنانة التتارية جيوزيل ماكودينوفا التي أمضت سنوات في المنفى الداخلي في صربيا. وزوجها، الكاتب أندريه أمالريك، الذي كان قد هرب إلى أوروبا الغربية بعد تعرضه لفترات من الاعتقال المتكرر.
يضيف الكاتب أن أمالريك كان يقود تلك السيارة. على بعد 40 ميلًا من العاصمة الإسبانية، انحرفت السيارة عن مسارها واصطدمت بشاحنة. نجا جميع الركاب باستثناء أمالريك، فعلى الأرجح فقد اخترقت قطعة معدنية في عمود التوجيه في المقود حلقه. وقت وفاة أمالريك كان عمره يناهز 42 عامًا، في حينها لم يكن أمالريك الأكثر شهرة من بين المنشقين في الاتحاد السوفييتي. وكان ألكسندر سولجنيتسين قد نشر كتاب “The Gulag Archipelago” “أرخبيل الغولاغ”، وفاز بجائزة نوبل في الأدب، وهاجر إلى الولايات المتحدة.
وكان أندريه ساخاروف قد حصل على جائزة نوبل للسلام التي أجبر على قبولها غيابيًا لأن الحكومة السوفييتية حرمته من تأشيرة الخروج. لكن احتل أمالريك من جهته مكانة خاصة في أوساط الناشطين ممن خضعوا للتحقيق وتعرّضوا للاعتقال والنفي.
يتابع الكاتب: بدءًا من منتصف الستينيات، تحرك المعارضون بعد حملة واسعة لاضطهاد الكتّاب والمؤرخين ومفكرين آخرين في عهد الزعيم السوفياتي ليونيد بريجنيف. بنظر عدد كبير من المراقبين في الغرب، بدت هذه الحركة الديمقراطية الناشئة تمهيدًا لتهدئة الحرب الباردة. وفي صيف عام 1968، قبل أسابيع فقط من دخول الدبابات السوفييتية إلى براغ، خصصت صحيفة نيويورك تايمز ثلاث صفحات لنشر مقال ساخاروف حول “التقدم والتعايش السلمي والحرية الفكرية”. وقال ساخاروف انه في عصر الاسلحة النووية لم يكن أمام الغرب والاتحاد السوفييتي خيار سوى التعاون لضمان بقاء البشرية. كان النظامان يشهدان بالفعل “تقاربًا”، على حد تعبيره. وعليهما تعلّم العيش معًا، وأن يتجاوزا أوجه التمييز الوطنية، وأن يتخذوا خطوات نحو الحكم على مستوى الكوكب.
يشير الكاتب إلى أن أمالريك عارض هذه الأفكار كلها. ففي خريف عام 1970، نجح في تهريب مقالة قصيرة من كتابته إلى خارج الاتحاد السوفييتي. ثم نشرت بعد فترة قصيرة في مجلة “سورفي” التي تصدر في لندن. وقال أمالريك إن الرأسمالية العالمية والشيوعية على الطريقة السوفييتية لم تتلاقى، بل كانتا في الواقع تزدادان تباعدًا. حتى العالم الشيوعي نفسه كان في خطر الانفصال. وقد زادت مظاهر عدم الثقة بين الاتحاد السوفييتي والصين، واتجها بشكل واضح نحو حرب كارثية. (قبل ذلك بعام، في عام 1969، بدأت مناوشات بين البلدين على طول الحدود المشتركة بينهما، مع وقوع خسائر كبيرة). لكن المشكلة الحقيقية مع ساخاروف، كما كتب أمالريك، هي أنه فشل في إدراك أن الدولة السوفييتية والنظام السوفييتي – البلد والشيوعية كنظام سياسي واقتصادي – كانا متجهين إلى التدمير الذاتي. ولتوضحي وجهة نظره، كتب مقالة بعنوان: “هل سيبقى الاتحاد السوفيتي حتى عام 1984؟”
كانت هذه القطعة عبارة عن صراع المناضل المعارض المضطهد لتشخيص الشعور المبكر بالضيق في أوائل عهد بريجينيف، ولكن أمالريك انتهى به الأمر إلى تحديد متلازمة سياسية أكثر عمومية: العملية التي تستسلم من خلالها قوة عظمى لوهم الذات. وبحلول الستينات، كانت الحكومة السوفييتية قد توصلت إلى دولة كان المواطنون في عهد لينين أو ستالين يعتقدون أنه مستحيل الوصول إليه. السلع الاستهلاكية، والشقق ذات الأسرة الواحدة، وبرنامج الفضاء، والأبطال الرياضيين الدوليين، وشركة طيران تغطي العالم – كانت نجاحات المجتمع السوفييتي معروضة بالكامل. ومع ذلك، فقد أدرك أمالريك، أكثر من أي مفكر آخر في ذلك الوقت، حقيقة أن البلدان لا تتحلل إلا في الماضي. فالدول القوية، فضلًا عن سكانها، تميل إلى أن تكون محافظة خلقية عندما يتعلق الأمر بمستقبلها. إن “عبادة الراحة”، كما سماها – الميل في المجتمعات التي تبدو مستقرة إلى الاعتقاد “بأن “العقل سيسود” وأن “كل شيء سيكون على ما يرام” – هي أمور مغرية. ونتيجة لذلك، عندما تأتي أزمة نهائية، فمن المرجح أن تكون غير متوقعة ومربكة وكارثية، مع الأسباب التي تبدو تافهة إلى هذا الحد، فإن العواقب التي يمكن إعادة تحديدها بسهولة إذا كان القادة السياسيون لن يفعلوا سوى الشيء الصحيح، بحيث لا يمكن لأحد أن يصدق تمامًا أنها وصلت إلى هذا الحد.
كما قدم أمالريك نوعًا من المخطط للاغتراب التحليلي. واقترح أنه من الممكن في الواقع أن تفكر في طريقك حتى نهاية الأيام. تتمثل الطريق في ممارسة العيش مع النتيجة الأكثر احتمالًا يمكنك فهمها ومن ثم العمل إلى الوراء، بشكل منهجي وبعناية شديدة. المهم ليس اختيار دليل واحد ليتناسب مع استنتاج معين. بل هو أن يهز نفسه من افتراض التغيير الخطي – أن ننظر، للحظة، كيف يمكن لبعض المؤرخين في المستقبل إعادة صياغة المخاوف غير القابلة للتصديق على أنها مخاوف حتمية.
وبالنظر إلى هذا العمل في عام 2020، أي بعد 50 عامًا من نشره بالضبط، فإن عمل أمالريك يتسم بحسن توقيت غريب. وكان قلقًا بشأن كيفية تعامل القوة العظمى مع الأزمات الداخلية المتعددة – وهي تعثر مؤسسات النظام الداخلي، وخداع السياسيين الفاسدين، والهزات الأولى التي تكشف انهيار الشرعية المنهجية للنظام القائم. في المحصلة أراد أمالريك أن يفهم المنطق الكامن وراء التفكك الاجتماعي والنتائج الكارثية للخيارات السياسية المتخبّطة. كان توقعه محدودًا من الناحية الزمنية ويُفترض أن ينتهي في عام 1984، لكن يسهل أن نسمع صداه اليوم. لمعرفة مسار انهيار القوى العظمى، لا شيء أفضل من دراسة آخر قوة عظمى انهارت في العالم.
بلد على شفير الهاوية:
بدأ أمالريك مقاله بتحديد بعض مؤهلاته لهذه المهمة. كطالب تاريخ، كان قد بحث في كيفية ظهور روسيا وأوكرانيا من إمارات في القرون الوسطى إلى دولة كروسيا وأوكرانيا في العصر الحديث، وعانى من بعض النتائج التي توصل إليها. وكان قد طرد من جامعة موسكو الحكومية لأنه يوحي بأن التجار والمستعمرين الإسكندنافية، وليس السلافيين، هم المؤسسون الحقيقيون للدولة الروسية – وهو ادعاء يقبله المؤرخون الآن على نطاق واسع ولكنه في ذلك الوقت يتعارض مع الكتابة الرسمية للتاريخ السوفييتي. وكان كمثقف وصديق للكتاب والصحفيين، قد ارتبط ارتباطًا وثيقًا بالحركة الديمقراطية في الاتحاد السوفييتي وعرف أهم لاعبيها.
وتابع أمالريك أنه كان من الخطأ الفادح الاعتقاد بأن المرء يمكن أن يقدم تنبؤات سياسية عن بلد ما من خلال مسح تياراته الأيديولوجية الرئيسة. قد يُدمج الناس أنفسهم في معسكرات منافسة أو يتم فرزهم من قبل خبراء خارجيين: اليساريون المتشددون والقوميون والليبراليون وما شابه ذلك. ولكن هذه المجموعات دائما غير متبلور. ولا يظهر ناخبوهم سوى القليل من الاتفاق الحقيقي فيما بينهم حول ما يشكل عقيدة أرثوذكسية أو برنامجًا سياسيًا متماسكًا.
كان يظن أمالريك أن أفضل طريقة لتقييم الانقسامات السياسية تقضي بتحديد أجزاء المجتمع التي تصبح مُهددة بفعل التغيير وتلك التي تحاول تسريع ذلك التغيير، وتوقّع ما ستفعله الدول للسيطرة على الاختلافات بين الطرفين. يريد البيروقراطيون والسياسيون الاحتفاظ بمناصبهم، ويريد العمال تحسين مستوى معيشتهم، ويشكك المفكرون من جهتهم بالحقائق القديمة المرتبطة بالهوية الوطنية. ويمكن لهذه الانقسامات أن تهدد بقاء مؤسسات الدولة. كتب أمالريك: “من الواضح أن الحفاظ على الذات هو المحرك الأساسي والدافع المهيمن. والشيء الوحيد الذي تريده “الحكومة” هو استمرار الوضع السابق: يجب الاعتراف بالسلطات القائمة، واسكات المثقفين، عدم زعزعة النظام عبر تطبيق إصلاحات خطيرة وغير مألوفة”. لكن ماذا يحصل في أوقات الاضطرابات السريعة، عندما يصبح استمرار وضع المراوحة مستحيلًا نتيجة التحولات الاقتصادية والتطور الاجتماعي والاختلافات بين الأجيال؟ يبقى القمع خيارًا دائمًا، لكن يستعمل الحكام الأذكياء نفوذهم بطريقة انتقائية، -فيضطهدون كاتبًا مثلًا أو يُقيلون مسؤولًا بارزًا لم يعد يرضخ للقيادة العليا. حتى ان السلطات الأكثر ذكاءً قد تحافظ على ذاتها “عبر إحداث تعديلات وإصلاحات تدريجية واستبدال النخبة البيروقراطية القديمة بمجموعة تتمتع بمستوى أعلى من الدهاء والمنطق”.
ولكن ينبغي للمرء أن يشك في مدى التزام الزعماء بتنفيذ الإصلاحات التي يطرحونها. وتجيد الحكومات الاعتراف بالأخطاء في أماكن وأوقات أخرى، ولكنها تعجز عن تحديد مظاهر الظلم في المؤسسات الخاصة. وهذا ما حصل بشكل خاص بالنسبة إلى القوى العظمى مثل الاتحاد السوفييتي، يعتقد أمالريك. وإذا استطاع بلد ما أن يبحر إلى أي مكان بلا رادع وأوصل البشر إلى الفضاء الخارجي، فإنه لا يملك حافزًا كبيرًا للنظر إلى مكامن الفساد الداخلي. واضاف ان “النظام يعتبر نفسه ذروة الكمال وبالتالي لا يرغب في تغيير طرقه لا بمحض رغبته، ولا حتى بتقديم تنازلات لأي شخص أو أي شيء”. في غضون ذلك، اعتُبرت أدوات القمع القديمة (أي الستالينية في الزمن السوفييتي) رجعية متخلفة وغير إنسانية وغير فاعلة في تلك الحقبة. لقد أصبح المجتمع أكثر تعقيدًا، وأكثر عصفًا بالاختلاف، وأكثر تطلبًا من الدولة، ولكنه أقل اقتناعًا بأن الدولة يمكن أن تحقق ذلك. ما تبقى هو نظام سياسي أضعف بكثير مما اعترف به المسؤولون – حتى أولئك الملتزمين بتجديده.
بالطبع، لا أحد يعتقد أن مجتمعه على شفير الهاوية. عندما تحدث إلى رفاقه، أفاد أمالريك أنهم يريدون فقط أن تهدأ الأمور قليلًا، دون أن يعرفوا حقًا كيف يمكن تحقيق ذلك. يميل المواطنون إلى اعتبار حكومتهم على أنها من المسلمات، كما لو لم يكن هناك بديل حقيقي للمؤسسات والعمليات التي كانوا يعرفونها دائمًا. غالبًا ما كان السخط العام، حيثما وجد، موجهًا ليس ضد الحكومة في حد ذاتها ولكن فقط ضد بعض عيوبها. وكتب أمالريك: “الجميع غاضبون من التفاوت الكبيرة في الثروة، وانخفاض الأجور، وظروف السكن التقشفية، ونقص السلع الاستهلاكية الأساسية”. وما دام الناس يعتقدون أن الأمور تتحسن إلى حد كبير، فإنهم يكتفون بالتمسك بأيديولوجية الإصلاح والأمل في التغيير التدريجي والإيجابي.
حتى هذه اللحظة، كان أمالريك يتبع خطًا تحليليًا مألوفًا بالنسبة إلى ساخاروف ومعارضين آخرين. ولم يكن الاستقرار يتماشى يومًا مع الإصلاح الداخلي. ينتقل أمالريك فجأةً إلى طرح سؤال بسيط: ما هي نقطة الانهيار؟ إلى متى يمكن للنظام السياسي أن يسعى إلى إعادة ترميم نفسه قبل حصول حدث من اثنين: ردة فعل كارثية من الفئات المعرّضة للخطر بسبب التغيير المرتقب، أو إدراك صانعي التغيير أن تحقيق أهدافهم لم يعد ممكنًا في ظل المؤسسات القائمة والأيديولوجيا التي يحملها النظام الحالي؟ في هذا السياق، حذّر أمالريك من ميل القوى العظمى إلى وهم الذات وعزل الدولة، ما يضعها في موقف أكثر صعوبة. فهي تفصل نفسها عن العالم، ولا تتعلم إلا القليل من التجارب البشرية المتراكمة. فهي تعتبر نفسها محصّنة ضد المشاكل التي تصيب أماكن وأنظمة أخرى. هذه النزعة قد تتسلل إلى المجتمع في حالات كثيرة. حتى ان الطبقات الاجتماعية المتنوعة قد تشعر بأنها معزولة عن نظامها ومنفصلة عن بعضها البعض. لهذا السبب، خلص أمالريك إلى أن “هذه العزلة تنتج صورة شبه سريالية عن العالم ومكانة الناس في مخيلة الجميع، -بدءًا من النخبة البيروقراطية وصولًا إلى أدنى الطبقات الاجتماعية-. لكن كلما سهّلت هذه الظروف استمرار وضع المراوحة، يصبح انهيار البلد سريعًا وقويًا عند مواجهة الواقع”.
ولم يكن هناك سبب للاعتقاد بأن مثل هذا الحساب لن تهدد سوى مجموعة معينة من النخب. وفي ضوء الظروف المناسبة، يمكن أن يكون البلد ككل هو الضحية النهائية. في مجتمعه، حدد أمالريك أربعة محركات لهذه العملية. يتعلق العامل الأول بـ “الارهاق الأخلاقي” الذي يشتق من سياسة خارجية توسعية تليها حرب لامتناهية. يرتبط العامل الثاني بالمصاعب الاقتصادية التي يسببها الصراع العسكري المطوّل (كان أمالريك يتوقع اندلاع حرب بين الاتحاد السوفييتي والصين). أما العامل الثالث، فيتعلق بعدم تحمّل الحكومة تعبير الناس عن استيائهم وميلها إلى قمع “مظاهر الغضب الشعبي المتقطعة أو أعمال الشغب المحلية” بطريقة عنيفة. وقال: تتخذ حملات القمع منحى وحشيًا على الأرجح حين يكون القامعون، أي الشرطة أو قوى الأمن الداخلي، من جنسية مختلفة عن الشعب الذي يرتكب أعمال الشغب، ما يؤدي إلى تأجيج العداوة بين مختلف الجنسيات.
ومع ذلك، كان هناك اتجاه رابع من شأنه أن يعني النهاية الحقيقية للاتحاد السوفياتي: ظنّ جزء كبير من النخبة السياسية أنه يستطيع أن يضمن مستقبله بأفضل طريقة عبر قطع علاقته مع العاصمة الوطنية. افترض أمالريك أن هذا الوضع قد يحصل بين الأقليات العرقية السوفييتية، “أولًا في منطقة البلطيق والقوقاز وأوكرانيا، ثم في آسيا الوسطى وعلى طول نهر الفولغا”. سرعان ما تبيّن أنه توقّع صائب تمامًا. بشكل عام، كان أمالريك يظن أن النخب المؤسسية تواجه مرحلة مفصلية في زمن الأزمات الحادة. في هذه الحالة، هل تتمسك بالنظام الذي يعطيها السلطة أم تعيد طرح نفسها كشخصيات حكيمة تدرك أن السفينة تغرق؟ حين يتّضح أن النظام بدأ يفقد سيطرته على البلد وأصبح منفصلًا عن الواقع، يميل القادة الحكماء على الهامش إلى الحفاظ على مكانتهم، فيتجاهلون بكل بساطة توجيهات القيادات العليا. يقول أمالريك أنه في هذه اللحظات الشائكة، يكون أي نوع من الهزائم الكبرى على سبيل المثال “استياء شعبي هائل في العاصمة على شكل إضرابات أو اشتباكات مسلحة” كافيًا لإسقاط النظام. وخلص إلى أن الاتحاد السوفييتي سينهار ما بين عامي 1980 و1985.
جميع الدول ستنهار:
وقد غاب عن أمالريك الموعد الدقيق لتفكك بلاده، فقد انهار الاتحاد السوفييتي بعد سبع سنوات من الفترة التي توقعها. أدت محاولات ميخائيل غورباتشوف إضفاء طابع ليبرالي وديمقراطي على الدولة إلى نشوء مجموعة من القوى التي جعلت الاتحاد السوفييتي يختفي على مدار عام 1991. في نهاية ذلك العام، تنحى غورباتشوف عن منصب الرئاسة وانهار البلد تحت أقدامه. لكن وفق التخمينات السياسية المبنية على الأحداث التاريخية حول العالم، يستحق أمالريك على الأرجح جائزة على دقة توقعاته. لقد كان محقًا في توصيفه للمشهد العام. في حالة الاتحاد السوفييتي، لم يكن الإصلاح يتماشى مع استمرارية الدولة بحد ذاتها.
لقد مات أمالريك في الوقت الذي بدأ الأكاديميون وخبراء السياسة الغربيون يكتبون تاريخ الأحداث في أواخر القرن الماضي: تحذير بول كينيدي من مخاطر التمدد الإمبراطوري المفرط، وكتاب فرانسيس فوكوياما الألفي عن الديمقراطية الليبرالية، وصراع الحضارات العنصري الجديد الذي كتبه صموئيل هنتنغتون. لكن في بداية التسعينيات، اتّضحت أهمية تحليلات أمالريك أخيرًا. كان يدرك على ما يبدو ما سيحصل بعد انهيار الاتحاد السوفييتي: نشوء مجموعة من الدول المستقلة، ظهور اتحاد جديد تطغى عليه روسيا، انتساب جمهوريات البلطيق إلى “اتحاد أوروبي جامع”، نشوء نسخة متجددة من النظام القديم في آسيا الوسطى تجمع بين الممارسات السوفييتية والاستبداد الداخلي. فيما استشهد المحافظين الأميركيين بتوقعاته. في حين كان دعاة العولمة ومعارضو الانتشار النووي يجاملون ساخاروف ويغذّون أوهامهم حول التعايش مع إمبراطورية مستبدة، كان يُفترض أن يتنبهوا إلى تحليلات أمالريك. لو فعلوا ذلك، كانوا ليطلقوا مواجهة مبكرة مع الدولة السوفييتية المترنحة ويسرّعوا عجلة انهيار الشيوعية.
يرى الكاتب بأنه يوجد أخطاء كثير في تحليلات أمالريك، كتلك المرتبطة باندلاع حرب سوفييتية صينية. حيث كانت هذه الفرضية من ركائز تحليله. (على الرغم من أن المرء قد يقول ان الصراع السوفييتي الأفغاني كان موفقًا: لقد بالغ في تقدير تداعيات أعمال العنف المرتبطة بانهيار الاتحاد السوفييتي. فقد تفكك هذا الكيان بطريقة سلمية لم يتوقعها أحد، خاصة في ظل الخلافات الحدودية الكبرى وتصادم الهويات القومية وتفاقم المنافسة بين النخب الحاكمة في أكبر بلد في العالم. في غضون ثلاثة عقود، أعادت روسيا كقوة عظمى لديها القدرة على القيام بشيء لم يتمكن الاتحاد السوفييتي من القيام به قط: فهم الانقسامات الاجتماعية الأساسية بين خصومها واستغلالها، بدءًا من الولايات المتحدة وصولًا إلى المملكة المتحدة، تزامنًا مع ترك الآثار السياسية والاستراتيجية المنشودة. فشل أمالريك أيضًا في توقع تلاقي الشرق والغرب بطريقة مختلفة، فقد نشأت طبقة أوليغارشية رأسمالية مهووسة بالمراقبة وغير متساوية بأي شكل، وهي تعمد إلى مراقبة حقوق الإنسان بطريقة انتقائية وتتكل على سلاسل الإمدادات العالمية وتبدو هشة تجاه تقلبات الأسواق والميكروبات. كان أمالريك ليتفاجأ على الأرجح حين يدرك أن “التعايش السلمي” الذي تكلم عنه ساخاروف اتخذ هذا الشكل تحديدًا، خلال فترة معينة على الأقل.
كتب أمالريك في نهاية مقالته الصادرة عام 1970: “لقد وصلت الصواريخ السوفييتية إلى كوكب الزهرة. لكنّ الناس في القرية التي أعيش فيها يزرعون البطاطا حتى الآن بيدهم”. وقد قام بلده باستثمارات كثيرة لمواكبة خصومه وبذل جهودًا كبرى لمنافسة الدول باعتباره قوة عظمى عالمية. لكنه لم يتعامل مع مسائل جوهرية أخرى. بقي المواطنون في هذا البلد عالقين على طريق التنمية الاقتصادية ولم يفهموا بعضهم البعض ولم يفهمهم حكامهم. في ظروف مماثلة، كان المستقبل المبني على إرساء الديمقراطية تدريجًا وإقامة تعاون مثمر مع الغرب مجرّد وهم برأي أمالريك. أمام سلسلة من الصدمات الخارجية والأزمات الداخلية التي تزامنت مع احتدام المنافسة مع جهات حيوية وقابلة للتكيف مع الظروف، كانت مظاهر الحياة في بلده ضئيلة بطريقة لم يدركها أحد في تلك الفترة.
يتابع: جميع البلدان لها نهاية، ويمرّ كل مجتمع بأسوأ الظروف في مرحلة معينة لكن تختفي المشاكل لفترة وراء مظاهر قاتمة أخرى قبل أن يصبح الانهيار وشيكًا. وقد كتب أمالريك بالفعل أنه في القرن السادس عشر كانت الماعز ترعى في المنتدى الروماني. وقد وضع نظريات ذات ظروف خاصة، ولطالما آمن بالقضاء والقدر على مستويات عدة. كان يظن أن الاتحاد السوفييتي يفتقر إلى الحنكة اللازمة لتطبيق إصلاحات قادرة على زعزعة النظام وضمان صموده في الوقت نفسه، وكان محقًا في رأيه. لكنه أراد أن يكشف للمواطنين في بلدان أخرى، حيث تختلف الهياكل الداخلية، المظاهر المقلقة التي تستحق الانتباه. لقد اقترح تقنية لتعليق أعمق الخرافات السياسية الشائعة وطرح أسئلة قد تبدو في الوقت الحاضر أشبه بنزوات عابرة.
اختتم الكاتب مقالته بالقول: “لن تكشف هذه المنهجية عن سر الخلود السياسي. لكن من خلال استكشاف الأسباب المحتملة لأسوأ النتائج التي يمكن تخيّلها، قد يصبح التعامل بذكاء مع الخيارات الصعبة والمُلحّة التي تستطيع تغيير طبيعة السلطة ممكنًا. إنها الخيارات التي تجعل السياسة أكثر تجاوبًا مع التغيير الاجتماعي وتزيد قيمة البلد التاريخية. أصحاب السلطة ليسوا معتادين على التفكير بهذه الطريقة. لكن في أوساط المعارضين والمنفيين في المراتب الأدنى المستوى، يضطر الناس لإتقان فن التحقيق الذاتي، فيتساءلون: إلى متى نستطيع البقاء في مكاننا؟ ماذا نضع في حقائبنا؟ كيف نصبح مفيدين هنا أو هناك؟ في الحياة، كما في السياسة، لا يُعتبر الأمل مضادًا لليأس بل التخطيط المدروس”.
المصدر: اضغط هنا