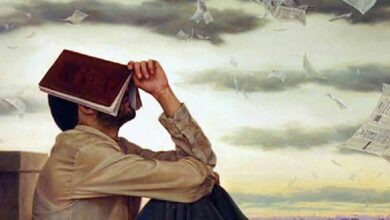يتشكّل الوعي الذاتي في عمق البنية العصبية للدماغ، من خلال تفاعل معقّد بين الإشارات العصبية والعمليات الإدراكية والعاطفية. هذا التفاعل لا يقدّم انعكاسًا دقيقًا للذات، بل يعكس تصورًا متذبذبًا يتأثر بالمحفزات الخارجية، والموروث الداخلي، والبيئة الاجتماعية.
وبهذا، يغدو الوعي نتيجة ديناميكية لتفاعل متداخل بين البُنى العصبية، التعبير الجيني، وسياق التجربة.
في هذا السياق، تبرز حالتان متضادتان توضحان حدود التمثيل الذاتي في الدماغ: “تأثير دانينغ-كروجر” و”متلازمة المحتال”. و يشير التمثيل الذاتي إلى الصورة التي يُكوِّنها الفرد عن نفسه داخليًا، وهو تصور يتشكل عبر عمليات عصبية وإدراكية متشابكة، وقد يبتعد كثيرًا عن الواقع الفعلي نتيجة للخبرة أو الخلل في التقييم.
في الأولى، يُفرط الفرد في الثقة بقدراته رغم تواضع أدائه الفعلي، نتيجة قصور في نشاط القشرة الجبهية الأمامية، المسؤولة عن التقييم الذاتي والتعلم من الأخطاء. ويُعرف “تأثير دانينغ-كروجر” بأنه انحياز إدراكي يجعل الأفراد ذوي الكفاءة المنخفضة يبالغون في تقدير قدراتهم بسبب عجزهم عن تقييم أدائهم بدقة.
في المقابل، يعاني المصاب بـ”متلازمة المحتال” من شك دائم في كفاءته، رغم أدلة الإنجاز، بفعل فرط نشاط في الفص الجبهي الأوسط والقشرة الحزامية الأمامية، ما يخلق حساسية مفرطة لتقييم الآخرين ويشوّه استقبال الإشارات الإيجابية. وهي حالة نفسية شائعة يشعر فيها الأفراد بأنهم لا يستحقون نجاحهم، ويُعزون إنجازاتهم إلى الحظ أو الخداع، رغم وجود كفاءة حقيقية.
كلتا الحالتين تعكسان خللًا في الميتامعرفة أي القدرة على تقييم الفكر ، وهي وظيفة عصبية مركزية تشرف عليها آليات دقيقة في الدماغ، ولا تقتصر على المعرفة بحد ذاتها، بل تشمل الوعي بكيفية المعرفة، وصلاحية التقييم الذاتي.
المثير أن هذه المفاهيم، وإن صيغت اليوم بلُغة علوم الأعصاب،فإنها تجد جذورها في التراث العربي الإسلامي. فقد أشار الإمام علي عليه السلام إلى غفلة التمثيل الذاتي بقوله: “هلك امرؤ لم يعرف قدر نفسه”.
وفي المقابل، عبّر الزهاد والعلماء عن خوف دائم من فخاخ النعم ،وأن يكون ما يظنونه نعمة إنما هو استدراج، ما يقارب شكّ العارف في ذاته رغم وضوح إنجازه. هذا التوتر بين الغفلة والشك هو جوهر ما سمّته كتب الحكمة بـ”معرفة النفس”.
في المنظور العرفاني، معرفة النفس ليست غاية في ذاتها، بل خطوة أولى نحو معرفة الله. وهنا يتجلى البعد الروحي لهذا الوعي: السير إلى الله لا يتم إلا عبر مجاهدة ذاتية شاقة، تتطلب الصدق مع النفس، والوعي بحدودها، ومحدودية زادها. وكما قال الإمام علي: “آه من قلّة الزاد، وطول الطريق، وبُعد السفر”. هذا الطريق لا يُقطع بالحركة المكانية، بل بتحول داخلي في البنية النفسية، يتطلب مراجعة دائمة وتأملًا نقديًا عميقًا.
يمتد هذا التفسير إلى أبعاد بيولوجية أعمق في ضوء علم التخلّق الجيني (Epigenetics). فالتجارب الحياتية لا تكتفي بترك أثر على الدماغ فقط، بل تترك بصمة على التعبير الجيني ذاته، فالعواطف، وأنماط التفكير، والعادات السلوكية يمكن أن تُنشّط أو تُثبّط جينات معينة، ما يؤثر بدوره على الوظائف العصبية والسمات النفسية للفرد. وثبت أن الوعي ليس محصورًا في الدماغ، بل هو مشروع بيولوجي يتفاعل مع الخبرة عبر الزمن.
من هنا تظهر أهمية “الناصية” في هذا السياق؛ وهي المنطقة الأمامية من الدماغ المرتبطة باتخاذ القرار وضبط السلوك، يشير النص القرآني إليها بوصفها : “ناصية كاذبة خاطئة ” (سورة العلق الآية 16) وهو توصيف يتسق مع الاكتشافات الحديثة التي تربط القشرة الجبهية الأمامية بقدرتنا على تقييم الأفعال وتقدير العواقب. التغيرات الجينية الناتجة عن الخبرة قد تعدّل من فعالية هذه المنطقة، بما يجعل الناصية نقطة التقاء بين السلوك، الأخلاق، والتعديل العصبي الجيني.
هذه القراءة تجمع بين الرؤية القرآنية والطرح العصبي المعاصر. من يسلك طريق التزكية يعيد برمجة ذاته على مستوى الدماغ والجينات معًا. وهكذا تُفهم “تزكية النفس” كما صاغها المتصوفة والفلاسفة، ليس فقط كمجرد مشروع روحي، بل كعملية عصبية/جينية واعية، تنبع من الممارسة اليومية والانضباط الداخلي.
يعبّر الجنيد، أحد رموز التصوف الإسلامي، عن هذا المسار بقوله : “سيروا إلى الله عرجًا ومكاسير، فإن انتظرتم الكمال لم تبرحوا أماكنكم”. هذه العبارة تختصر ما توصلت علوم الأعصاب اليه اليوم بأن بناء الوعي الذاتي لا يتم دفعة واحدة، والمغالطات في التقييم ليست أعطابًا عشوائية، بل مراحل ضرورية في مسار النمو.
وعليه، فإن استحضار مفاهيم مثل التزكية والمحاسبة والتواضع المعرفي، في ضوء علوم الأعصاب، لا يشكل إسقاطًا تأويليًا على التراث، بل يفتح جسرًا إبستمولوجيًا بين خطابين يتعاملان مع بنية الذات من زاويتين: الأولى روحية، تستند إلى مفاهيم النفس والنية والسلوك؛ والثانية علمية، تستند إلى النواقل العصبية والتعبير الجيني وتنظيم الدماغ.
كلا الخطابين يشتركان في هدف واحد: فهم الإنسان لنفسه. لماذا يخطئ؟ كيف يضل؟ وكيف يستعيد وضوح الرؤية تجاه ذاته؟ و يتقاطع النموذج الروحي مع النموذج العصبي الحديث في مفهوم “الميتامعرفة”: أن يعرف الإنسان كيف يعرف وهو لبّ “معرفة النفس” في التراث الصوفي ، ومركز الوعي التقييمي في علوم الدماغ.
الوسوم
الإدراك البيئة العلم الملف الإستراتيجي الوعي