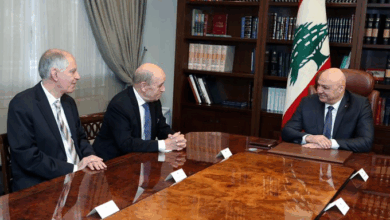مع عودة دونالد ترامب إلى الواجهة السياسية الأميركية، مستندًا إلى خطاب اقتصادي متشدد، يبدو أن العالم يدخل مرحلة جديدة من التوترات الجيوسياسية. سلسلة الإجراءات الاقتصادية التي أطلقها ترامب مؤخرًا، والمتمثلة في حزم من الرسوم الجمركية على السلع الصينية، وتقييد التبادلات مع أوروبا، وتلويحه بإعادة رسم العلاقات الاقتصادية مع دول حليفة، فتحت الباب واسعًا أمام تغييرات جذرية لا تمس الاقتصاد فحسب، بل تتجاوزه إلى السياسة والأمن والصراعات الجغرافية المحتملة.
أولاً: ما الجديد في إجراءات ترامب؟
عودة ترامب إلى النمط الشعبوي المعروف عنه لم تكن مجرد تكرار للماضي، بل جاءت أكثر حدة وتنظيمًا. ففي 9 نيسان 2025، أعلن عن فرض رسوم جمركية بنسبة 125% على الواردات الصينية، وهي نسبة غير مسبوقة منذ عقود، ما شكّل تصعيدًا خطيرًا في الحرب التجارية بين أكبر اقتصادين في العالم. في الأيام التالية، تم تعديل هذه الرسوم مرة أخرى، حيث أعلنت الإدارة الأمريكية أن الرسوم الجمركية على الصين ستصل إلى 145%. هذه الخطوة جاءت تتويجًا لتحذيرات أطلقها ترامب خلال حملته الانتخابية في شباط 2024، حين وعد بفرض رسوم جمركية قد تتجاوز 60% على السلع الصينية، وهو ما أثار في حينه جدلًا واسعًا في الأوساط الاقتصادية الدولية
إضافة إلى ذلك، قام ترامب بـ:
•فرض رسوم جمركية مؤقتة بنسبة 10% على جميع واردات الولايات المتحدة من مختلف الشركاء التجاريين حول العالم، وذلك ضمن فترة تعليق مدّتها 90 يومًا، كانت تهدف – وفق الخطاب الرسمي – إلى مراجعة شاملة للاتفاقيات التجارية القائمة. غير أن هذا القرار المؤقت أُدرج ضمن إجراءات استراتيجية حمائية أوسع، ما أثار قلقًا دوليًا من احتمال تحوله إلى سياسة دائمة، خاصةً مع تهديد بعض الدول باتخاذ خطوات تجارية انتقامية مقابلة.
•التهديد بفرض ضرائب على الشركات الأميركية التي تستثمر في الخارج.
•مراجعة أو الانسحاب من اتفاقيات التجارة الحرة، وعلى رأسها “نافتا” والاتفاقيات مع الاتحاد الأوروبي.
•تشجيع الصناعات الوطنية بإجراءات حمائية، رغم ما تحمله من مخاطر انتقام اقتصادي مضاد.
هذه الإجراءات، وإن بدت للوهلة الأولى “اقتصادية”، إلا أنها تحمل في طيّاتها مشروعًا أيديولوجيًا لإعادة تشكيل النظام العالمي بما يتلاءم مع تصور ترامب للهيمنة الأميركية.
ثانيًا: التداعيات الاقتصادية العالمية
الاقتصاد العالمي اليوم مترابط لدرجة أن أي اختلال في التوازن الأميركي يُحدث موجات صدمة عبر القارات. ومن أبرز التداعيات المتوقعة:
1.حرب تجارية مفتوحة مع الصين: ردت الصين سريعًا بزيادة رسومها الجمركية على السلع الأميركية من 34% إلى 84%، في مشهد يعيد إلى الأذهان أجواء الحرب التجارية بين البلدين في عهد ترامب الأول. هذه الموجة الثانية من التصعيد تسببت في اضطرابات كبيرة في أسواق المال العالمية. ثم قالت الصين إنها ستزيد الرسوم الجمركية على السلع الأميركية إلى 125%، مشيرة إلى أنها “ستتجاهل” أي رسوم إضافية قد تفرضها إدارة الرئيس الأميركي دونالد ترامب.
2. انكماش الأسواق الناشئة: تؤدي السياسات الحمائية إلى نزوح رؤوس الأموال من الأسواق الناشئة، ما يُضعف عملات تلك الدول ويزيد من عجز ميزانياتها.
3.تراجع النمو العالمي: تتوقع المؤسسات المالية الكبرى، مثل صندوق النقد الدولي، أن تؤدي هذه التوترات إلى تراجع معدل النمو العالمي بنحو 1.5% في 2025، وهو رقم مقلق في ظل التحديات المناخية والجيوسياسية.
4.تجزئة الاقتصاد العالمي: من المتوقع أن تنقسم الساحة الاقتصادية إلى كتل متنافسة – كتلة أميركية، وأخرى أوروبية، وثالثة آسيوية – كل منها تسعى لبناء شبكات تبادل مغلقة لتفادي تقلبات السياسات الأميركية.
5.اهتزاز ثقة المستثمرين: فقدان الثقة في استقرار السياسات الأميركية يؤثر بشكل مباشر على الاستثمارات بعيدة المدى، ما ينعكس على قطاعات كبرى مثل التكنولوجيا والطاقة.
ثالثًا: تغييرات في موازين القوة السياسية
السياسة لا تنفصل عن الاقتصاد، والتبدل في مراكز الثقل الاقتصادي يترافق عادةً مع تبدل في معادلات النفوذ الجيوسياسي:
1.تقارب صيني-روسي أكبر: الرد الصيني لم يقتصر على الرسوم الجمركية، بل تجلّى أيضًا في تعزيز التعاون مع روسيا في مجالات الطاقة، التقنية، والدفاع، بما يشبه إعادة تشكيل لمحور شرقي جديد.
2.توتر داخل المعسكر الغربي: أوروبا، التي كانت تعتمد على التنسيق مع واشنطن، بدأت تعيد تقييم تحالفاتها، وظهر تيار يدعو إلى الاستقلال الاستراتيجي عن الولايات المتحدة، خاصة في فرنسا وألمانيا.
3.إعادة تموضع آسيوي: دول مثل اليابان وكوريا الجنوبية والهند بدأت تسعى لبناء تحالفات ثنائية أو إقليمية بديلة، خوفًا من تكرار سيناريو الصدمة التجارية أو تخلٍّ أميركي في الأزمات.
وفي أواخر آذار 2025، عقد وزراء التجارة من اليابان، كوريا الجنوبية، والصين اجتماعًا ثلاثيًا في سيول، هو الأول من نوعه منذ خمس سنوات. اتفق الوزراء على تعزيز التعاون الاقتصادي والتجاري لمواجهة التحديات الناشئة، خاصةً في ظل السياسات التجارية الحمائية المتزايدة من قبل الولايات المتحدة. هذا التنسيق يهدف إلى تعزيز التجارة الإقليمية وتقوية الشراكات الاقتصادية بين الدول الثلاث.
بالإضافة إلى ذلك، أشارت التقارير إلى أن الصين تسعى إلى تنسيق الردود على الرسوم الجمركية الأمريكية مع اليابان وكوريا الجنوبية، في محاولة لتعزيز التعاون الإقليمي في مواجهة التحديات التجارية.
هذا التعاون بين الدول الثلاث يُظهر تحولًا نحو تعزيز العلاقات الاقتصادية الإقليمية في آسيا، في ظل التوترات التجارية العالمية المتزايدة
4.ضعف المنظمات الدولية: الشلل في منظمة التجارة العالمية، وتراجع الثقة في الأمم المتحدة والمؤسسات المالية الدولية، أصبح أكثر وضوحًا، ما يزيد من خطر الفوضى في النظام العالمي.
رابعًا: ارتدادات أمنية ومناطق صراع محتملة
التحولات الاقتصادية قد تؤدي إلى صراعات، خصوصًا عندما تكون مترافقة مع تصدع في التحالفات الأمنية:
1.تايوان: الصاعق الآسيوي
تصاعد التوتر مع الصين قد يدفع الأخيرة إلى خطوات أكثر جرأة تجاه تايوان، خاصة مع توتر علاقتها بواشنطن. تحركات بحرية وعسكرية متزايدة بدأت ترصد في بحر الصين الجنوبي، ما يجعل المنطقة على صفيح ساخن.
2.الشرق الأوسط: فراغ القوة؟
في حال انكفاء أميركي بسبب التركيز الداخلي، قد تُفسح الساحة لقوى إقليمية كإيران وتركيا لتوسيع نفوذها، ما قد يجر إلى اشتباكات جديدة، خصوصًا في العراق وسوريا واليمن.
3.أوروبا الشرقية: الطموح الروسي
روسيا قد تستغل تراجع الالتزام الأميركي تجاه الناتو، لتوسيع نفوذها في أوكرانيا وربما باتجاه دول البلطيق، مما يُعيد إحياء شبح الحرب الباردة.
4.الساحل الأفريقي: مع تنافس القوى الكبرى على الموارد والتأثير، قد تتجدد الصراعات العرقية والدينية، لا سيما في دول مثل السودان، النيجر، ومالي، وسط ضعف التغطية الدولية.
خامسًا: هل نحن أمام إعادة ترسيم للخرائط؟
حتى وإن لم تُرسم حدود جديدة بعد، فإن خارطة النفوذ العالمية تشهد تحولات جوهرية، تحمل في طياتها سيناريوهات متعددة:
•تفكك تحالفات كبرى: حلف الناتو والاتحاد الأوروبي قد يشهدان تصدعات داخلية، نتيجة تناقض المصالح وضعف القيادة الموحدة.
•نشوء كيانات جديدة: دول تعاني من توترات داخلية كإثيوبيا ونيجيريا وباكستان قد تواجه احتمالات التفكك.
•مناطق بلا سيادة واضحة: مثل ليبيا وشمال مالي، قد تتحول إلى مساحات تُدار بسلطات هجينة، من المليشيات المحلية إلى الشركات الأمنية العالمية.
سادسًا: استشراف مستقبل النظام العالمي
إذا استمر هذا الاتجاه التصادمي، فإن النظام العالمي الذي عرفناه لعقود سيدخل في طور جديد متعدد الأقطاب وأكثر اضطرابًا. ومن أبرز ملامح المستقبل:
1.تعدد الأقطاب وضعف المركز: الصين وروسيا والاتحاد الأوروبي والهند تسعى الآن إلى بناء منظومات أمنية واقتصادية موازية للنموذج الأميركي، مما يُنهي هيمنة القطب الأوحد.
2.اقتصاد بلا قواعد مركزية: قد تبرز العملات الرقمية والتبادلات عبر سلاسل البلوكشين كوسيلة لتجاوز هيمنة الدولار، ما يغيّر ملامح النظام المالي العالمي.
3.عودة السيادة والحدود: الخطابات القومية تتعاظم في كل مكان، والدول تعود لتغليب المصلحة الذاتية على التعاون الجماعي، ما يُضعف أدوات الحوكمة العالمية.
4.نهوض الشركات العابرة للحدود كلاعب سياسي: شركات التكنولوجيا، بخاصة، تمتلك من القوة والبيانات ما يجعلها تتجاوز دورها الاقتصادي، لتؤثر في قرارات سياسية وأمنية.
5.تهديدات مناخية تضاف للصراعات: الضغط البيئي الناتج عن السياسات غير المستدامة سيؤدي إلى هجرات ونقص غذائي وأزمات مائية، ما يزيد من احتمالات النزاع حول الموارد.
نحو عالم أكثر توترًا وتعقيدًا؟
قد تكون سياسات ترامب مجرد شرارة فجّرت ما كان يتراكم بصمت على مدى سنوات، لكنها ليست السبب الوحيد في التبدّل العالمي الجاري. ما نعيشه اليوم هو نتيجة مسار طويل من التحولات في موازين القوى، وتآكل الثقة بالمؤسسات الدولية، وتصاعد النزعات القومية، وصعود الفاعلين غير التقليديين في السياسة والاقتصاد.
السؤال المحوري الآن لم يعد: هل ينجح ترامب في فرض رؤيته؟ بل أصبح: هل يستطيع العالم أن يتكيّف مع هذه التحولات المتسارعة من دون الانزلاق إلى مواجهات كبرى؟ وهل ستنتج هذه “الفوضى المنظّمة” نظامًا عالميًا جديدًا أكثر توازنًا، أم سندخل في مرحلة طويلة من عدم الاستقرار؟
الجواب لم يُكتب بعد، لكن ما هو مؤكّد أن السنوات القادمة ستكون حاسمة في تحديد شكل العالم لعقود مقبلة. فإما أن تتقدّم الدول نحو التعاون والمرونة، أو أن تُساق إلى صراعات تعيد تشكيل كل شيء، من التحالفات إلى الحدود، ومن النفوذ إلى الهويات.