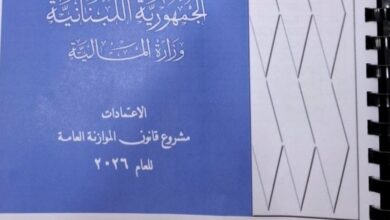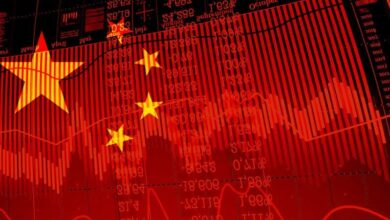تأتي الذكرى الخامسة والخمسين لحرق المسجد الأقصى هذا العام مترافقة مع معركة طوفان الأقصى التي تُعتبر مرحلة مفصليّة وتاريخيّة في حياة الشعب الفلسطينيّ ومستقبله، وفي وقت مهم من تاريخ القضيّة الفلسطينيّة، ذلك أنّ الأمة تمرّ بمأزق كبير، حيث كان يجهد العالم المستكبر لتوجيه ضربة قاضية لهذه القضيّة الإنسانيّة من خلال التغاضي عن الإستيطان والتهويد في الضفة الغربيّة والقدس الشرقيّة ويتعامى عن تمنّع اليمين الإسرائيليّ الحاكم الإعتراف بحق الدولة الفلسطينيّة بالوجود وبحق اللاجئين الفلسطينيّين بالعودة إلى ديارهم. وفيما احتفل رئيس اليمين «الإسرائيليّ» نتنياهو بـتحرير القدس من «الغزاة» على حد قوله، بمناسبة الذكرى السابعة والخمسين لاحتلال وتوحيد الجزأيْن الشّرقي والغربي من مدينة القدس في حزيران 1967، وهو ما يُعرف لدينا بذكرى النكسة، ترى بعض اللبنانيّين والعرب منشغلين عن الإبادة الجماعيّة في غزة، إمّا بسبب مشاريعهم الاقتصاديّة والتجارية، وإمّا بسبب سفراتهم السياحيّة، وإمّا بسبب نشاطاتهم الاستثماريّة ومشاريعهم الاستجماميّة.
وفيما أطلق وزير الأمن القوميّ المتطرّف «الإسرائيليّ» إيتمار بن غفير «عاصفة جديدة» لاستقطاب يهود العالم بأكملهم لعاصمتهم الأبديّة «أورشليم» حَسَب تعبيره، وصمّم «جبل الهيكل» الذي سيبنيه على أنقاض مسرى النبيّ محمد صلى الله عليه وسلّم، بعد إحضاره البقرات الحمراء لحرقها، وذرّ رمادها كإعلان عمليّ لهدم الأقصى وبناء معبده المزعوم، تأسف أنّك ترى البعض من الأشّقاء العرب والمسلمين في المقابل يُهروِلون للتطبيع أو استكماله مع العدو، ويُهروِلون من أجل فصل ارتباطهم بفلسطين وشعبها وقضيّتها تحقيقاً لمصالحهم الشخصيّة الضيقة، رغم إدراكهم وعلمهم بأنّ الصهيونيّة تمثّل أبشع أنواع الإحتلالات وأكثرها عنفاً ودمويّة.
وفيما يستمرّ الإحتلال بشكل يوميّ باقتحام باحات حرم الأقصى، وتدنيس قداسة المسجد بأحذيتهم والإعتداء على المرابطين والمرابطات بالضرب والسحل مراراً وتكراراً، ولا يستثنون الشيوخ الكبار أو الأطفال أو النساء مردّدين عبارتهم المشهورة: «جبل الهيكل بأيدينا» وذلك أثناء أداء مستوطنيهم الطقوس والصلوات التلموديّة، لابسين ثياب الكهنة ونافخين بأبواقهم داخل الحرم الشريف بعد تمزيقهم للمصاحف وعربدتهم من خلال إصرارهم على إدخال الكلاب معهم.
فكيف يتغاضى البعض من أشقائنا العرب والمسلمين عن كل ما يجري؟ وكيف يرضون لمقدّساتهم أن تُنتهك ولأعراضهم أن تُغتصب ولأبناء أمتّهم أن يُؤسروا، ويُمارس ضدهم أبشع أساليب القهر والتعذيب والتنكيل؟ وألا يُفترض بأنّهم معنيّين على الأقل بتحرير مقدّساتهم ومنعها من التدمير؟ أم أنّهم لا يرون كل الحفريات التي تُجرى منذ عشرات السنين أسفل الأقصى بهدف زعزعة أساساته ودفعه للإنهيار؟
وعموماً، لا أحد ينسى ما حصل في العام 1967 حين دخل الجنرال “موردخ أيجور” المسجد الأقصى المبارك هو وجنوده ورفعوا العلم «الإسرائيليّ» على قبة الصخرة، وحرقوا المصاحف، ومنعوا المُصلّين من أداء الصلاة فيه، وصادروا مفاتيح أبوابه، وأغلقوه على مدى أسبوع كامل، ومنعوا حينها حتى الآذان.
كذلك، لا أحد يجهل ما حصل في 21 آب 1969، عندما اقتحمت القوات «الإسرائيليّة» باللباس المدنيّ المسجد الأقصى من باب المغاربة مع المستوطنين، ودخلوا المصلّى القبليّ حتى وصلوا إلى منطقة المحراب ومنبر “نور الدين زنكي”، المعروف أيضاً بمنبر “صلاح الدين”، وسكبوا مادة حارقة وشديدة الإشتعال هناك، ليُضرموا النيران بالمسجد الشريف. وحينما تصاعدت ردود الفعل الدوليّة والإقليميّة، نسب الإحتلال الأمر كلّه لشخص عديم الأهليّة، أبعدوه من البلاد ومن ثم توفيّ في الخارج. إلّا أنّه من المؤسف أنّ ردود الفعل العربيّة، حتى في ذلك الوقت، اقتصرت على الإستنكار والشجب رغم تشكيلهم لمنظّمة المؤتمر الإسلاميّ، وهو ما دفع برئيسة وزراء الإحتلال آنذاك “غولدامئير” للقول: «عندما حُرق الأقصى لم أبت تلك الليلة، واعتقدت أنّ إسرائيل ستُسحق، لكن عندما حلَّ الصباح أدركت أنّ العرب في سُبات عميق».
أمّا اليوم فيمَا تُباد غزة جماعيّاً على مرمى ومسمع أكثر من مليارَيْ مسلم، وتضج سجون الإحتلال بالأسرى، ويتمّ تجويع الأطفال والنساء والشيوخ الفلسطينيّين وتعطيشهم، لا تكاد تجد مَن يكترث لحالهم سوى مِحور المقاومة. ولولا دعم سماحة الإمام السيد “علي خامنئي” وسماحة السيد “حسن نصر الله” والسيد “عبد الملك الحوثي”، حفظهم الله وأطال بعمرهم، لما وجد أهل غزة لهم من مُعين سوى الله جل جلاله. في حين أنّه من واجب جميع الحكام، العرب والمسلمين، الدينيّ والأخلاقيّ والإنسانيّ، أن ينهضوا لنجدة أشقائهم العرب والمسلمين في غزة ويتحدّوا جبروت الظلام لإغاثتهم من طغيانهم وعدوانهم وجرائمهم ضد الإنسانيّة.
ولكننا للأسف نجدهم يُهرولون للتطبيع مع «إسرائيل» وللمساعدة في تحرير أسرى أصدقائهم «الإسرائيليّين» حتى في الذكرى الخامسة والخمسين لحرق الأقصى، ويكاد لا يتجرّأ أحد منهم على قطع علاقاتهم الدبلوماسيّة والسياسيّة بالدولة الإسرائيليّة. أو حتى على الأقل على قطع علاقتهم التجاريّة بعدو أمّتهم «الإسرائيليّ».
وكيف تناسى هؤلاء ما تقوم به الحكومة «الإسرائيليّة» منذ سنوات أثناء حفر قوّاتها أسفل المسجد الأقصى؟
كيف أذابت أساساته بالمواد الكيميائيّة، وبالتحديد في النفق الذي وصفته بأنّه يصل بين شمالي سلوان ومكان جبل الهيكل المزعوم، على حد زعمها.
وهنا أقف بدهشة أمام ما يصدر عن بعض المسؤولين اللبنانيّين والعرب من كلمات معسولة للطاغوت الدوليّ، وأصحاب مشاريع الإستسلام في الشرق الأوسط، وأكاد لا أجد تعليلاً واحداً من باب تعزية النفس عن السبب الذي يتيح لبعض الحكام بالإستمرار بالخضوع والخنوع للدولة العظمى الأميركيّة، راعية الكيان الغاصب الصهيونيّ، في ظل كل ما يُحاك ضد أمّتنا إقليميّاً ودوليّاً من مؤامرات تهدف لقتلنا وتشريدنا وإذلالنا.
أمّا على الصعيد الدوليّ، فلا أحد من دول الغرب يكترث حقيقة لردع إسرائيل عن استكمالها للهولوكوست الغزاويّ الذي تُشاهده كل يوم بأم أعينها على شاشات التلفزة ووسائل التواصل الاجتماعيّ. وبذلك، فألا يقع على كل صاحب ضمير حي واجب نصرة المستضعفين من المسلمين، وواجب مواجهة المشاريع التي تهدف لتحويل المنطقة إلى مستعمرة أميركيّة كبرى؟ وعلى ما يتلطّى البعض وراء شعارات مزيّفة كالحياد أو الإزدهار الاقتصاديّ أو دولنا أولًا؟ فيما لو انتصر المشروع الإسرائيليّ، لن يكتفي العدو بحرق المسجد الأقصى المأسور منذ حوالى ستة وسبعون سنة، وإنّما سيهدمه حتماً ليُقيم هيكله المزعوم «هيكل سليمان». وأوليست هذه قضيّة مقدّسات دينيّة حقيقيّة، يجب على الحكّام أن يُدافعوا عنها؟ وألا يجدر بها أن تجمع الشرفاء ولا تُفرّق شملهم؟ وأوليست الأجدر بأن تُبذل الدماء المؤمنة الطاهرة من أجلها؟ ولكن برأيّي الشخصيّ، فالشعب في الوطن العربيّ والإسلاميّ يعيش إفلاساّ سياسيّاً وأخلاقيّاً ودينيّاً، حيث بلغ بعض نجوم الساحة العربيّة حالة الخيانة المطبّقة. وأولى علامات إفلاسهم، التخلّيّ عن قضيّة أمّتهم الجامعة، فلسطين والقدس والمقدّسات. أمّا ثاني علامات إفلاسهم، فهي ترويج البعض منهم لمشاريع دينيّة وصفقات سلام مزيّفة، كالمشروع الإبراهيميّ وصفقة القرن وأشباهها. فيمَا يبقى مستقبل الأخوان الفلسطينيّين مجهولاً وقاتماً وأسوداً، حيث كانت البداية غزة. والخوف كل الخوف أن يكون استقلال لبنان وسيادته وحرية جنوبه وبقاعه هو النهاية.