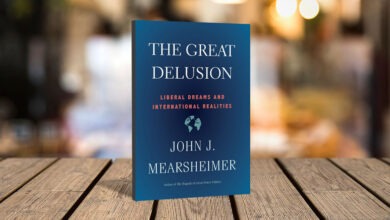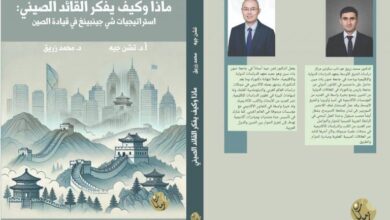لم تخفِ إدارة الرئيس الأمريكي “جو بايدن” رغبتها في إخراج الولايات المتحدة من الشرق الأوسط. وقال وزير الخارجية “أنتوني بلينكين”، في مقابلة قبل توليه منصبه، إنه يتصور أن إدارة “بايدن” ستنخرط بشكل “أقل وليس أكثر” في المنطقة. وقال مسؤول أمريكي كبير بالمثل إن إدارة “أوباما” لم تتابع ما يسمى سياسة التوجه نحو آسيا، ولكن “سنفعل نحن ذلك هذه المرة”.
وتهيمن “المنافسة الاستراتيجية” بين الولايات المتحدة والصين حاليا على نقاشات السياسة الخارجية الأمريكية، وتعد هذه القضية محل إجماع من الحزبين في واشنطن التي تشهد انقساما بشأن الموضوعات الأخرى. ولكن بالرغم من كل الحديث عن الانسحاب من الشرق الأوسط والقلق الإقليمي الحقيقي بشأن تخلي الولايات المتحدة عن المنطقة في أعقاب الانسحاب من أفغانستان، فإن الواقع على الأرض يشير إلى خلاف ذلك.
فلا تزال واشنطن تحتفظ بشبكة مترامية الأطراف من القواعد العسكرية، وقد أثبتت استعدادا أكبر لاحتضان شركاء بغيضين باسم تعزيز الأمن الإقليمي. علاوة على ذلك، من المرجح أن تؤدي الديناميكيات الإقليمية إلى مزيد من عدم الاستقرار والعنف، ما يغذي الطلب على استمرار الوجود الأمريكي.
ومن المؤكد أن الولايات المتحدة لم تعد اللاعب العالمي الوحيد في الشرق الأوسط، فقد نمت الاستثمارات الاقتصادية والتكنولوجية الصينية والنفوذ العسكري الروسي خلال العقد الماضي. وبهذا المعنى، انتهت لحظة الفخر الأمريكية.
العمل كالمعتاد
وبالرغم من كل المخاوف في العواصم العربية من تراجع الالتزام الأمريكي بالشرق الأوسط، فإن المشاركة العسكرية الأمريكية تظهر استمرارية أكثر مما هو معترف به بشكل عام. وبالرغم من الوعد بمراجعة بيع أسلحة بقيمة 23 مليار دولار للإمارات مع التركيز بشكل أكبر على حقوق الإنسان، قررت إدارة “بايدن” المضي قدما في عملية البيع.
ولم تؤد وعود “بايدن” بـ”إعادة تقييم” العلاقات مع السعودية أيضا إلى تغيير كبير في السياسة؛ فقد حضر وزير الدفاع السعودي “خالد بن سلمان” اجتماعات رفيعة المستوى مع كبار المسؤولين الأمريكيين خلال زيارة إلى واشنطن في يوليو/تموز، بالرغم من صدور تقرير استخباراتي أمريكي يشير إلى تورط ولي العهد في عملية قتل الصحفي السعودي “جمال خاشقجي”.
والتقى مستشار الأمن القومي الأمريكي “جيك سوليفان” مباشرة مع ولي العهد في الرياض في سبتمبر/أيلول 2021. وبعد ذلك دفعت الإدارة الأمريكية تجاه بيع أسلحة جديدة بقيمة 650 مليون دولار إلى السعودية.
ولا يشير ذلك إلى أن الإدارة تدير ظهرها لشركاء الولايات المتحدة التقليديين أو “تضع حقوق الإنسان في قلب” سياستها الخارجية. ويمتد هذا النمط إلى ما وراء شركاء الولايات المتحدة الأثرياء في الخليج؛ فبالرغم أن فريق “بايدن” قرر حجب 130 مليون دولار مؤقتا من المساعدات العسكرية لمصر، إلا أن قراره لم يرق إلى مستوى توقعات منظمات حقوق الإنسان التي كانت تريد دعم تشريعات الكونجرس التي تنص على تجميد 300 مليون دولار من المساعدات العسكرية حتى إحراز تقدم ملموس في سيادة القانون وإجراءات الإصلاح.
ومع حصولها على 1.3 مليار دولار سنويا من خلال برنامج التمويل العسكري الخارجي الأمريكي، تظل مصر من بين أكبر 3 متلقين للمساعدات العسكرية الأمريكية على مستوى العالم، بالرغم من حملة الرئيس “عبدالفتاح السيسي” ضد المعارضة السياسية والمجتمع المدني.
في غضون ذلك، أشارت إدارة “بايدن” بالفعل إلى إعادة تنظيم موقفها العسكري من خلال الإعلان عن خفض أنظمتها المضادة للصواريخ في المنطقة في الوقت الذي تعيد فيه التركيز على التحدي الذي تمثله روسيا والصين. وعززت إزالة هذه الأنظمة من السعودية في سبتمبر/أيلول شعور الرياض بتخلي الولايات المتحدة عنها في الوقت الذي يستمر فيه الحوثيون في شن هجمات صاروخية على الأراضي السعودية.
وتشارك وزارة الدفاع الأمريكية حاليا أيضا في مراجعة رئيسية لوضع القوة العالمية، ومن المحتمل أن تؤثر هذه المراجعة على البصمة العسكرية الأمريكية في الشرق الأوسط؛ حيث تعطي الولايات المتحدة الأولوية للتهديدات في منطقة المحيطين الهندي والهادئ. لكن لا يزال من المشكوك فيه أن يحدث تخفيض جذري لعشرات الآلاف من القوات الأمريكية في وقت قريب، ولا يبدو أن واشنطن مستعدة لتجاهل الاحتياجات الأمنية المتصورة لشركائها الإقليميين الرئيسيين.
قاعدة الدعم
وتعد الحجة الاستراتيجية لتقليص الوجود الأمريكي في الشرق الأوسط واضحة ومباشرة. وبالإضافة إلى الحاجة إلى تحويل الموارد إلى آسيا نظرا للظروف الجيوستراتيجية المتغيرة، فقد انخفض اعتماد الولايات المتحدة على نفط الشرق الأوسط بشكل كبير.
وكان هناك أيضا إعدة تقييم حول ما إذا كانت القواعد الكبيرة فعالة لمهام مكافحة الإرهاب، وما إذا كانت هذه القواعد قد تثير المزيد من الهجمات من إيران بدلا من ردعها. ويرى بعض المحللين أنه يجب على الولايات المتحدة إعادة جميع القوات إلى الوطن، بينما يدافع آخرون عن موقف إقليمي أكثر توازنا باستخدام قواعد أصغر.
ومن شأن هذا أن يجعل الولايات المتحدة أقل اعتمادا على قواعد العمليات الكبيرة مثل قاعدة “العديد” الجوية في قطر أو معسكر “عريفجان” في الكويت، التي قد تصبح أكثر عرضة للهجمات الإيرانية مع تقدم قدرات طهران الصاروخية وأسرابها من الطائرات بدون طيار.
وتعد هذه الحجج مقنعة. لكن الاعتبارات السياسية، والجمود البيروقراطي، واستمرار تعرض الولايات المتحدة لصدمات سوق النفط العالمية، والمصالح الاقتصادية لصناعة الدفاع الأمريكية، تجعل من الصعب إحداث تغيير سريع للمسار بغض النظر عن المنطق الاستراتيجي.
ويريد شركاء الولايات المتحدة في الخليج بقاء القوات الأمريكية، معتبرين القواعد العسكرية علامة على التزام واشنطن بأمنهم. وبعد أن لعبت قطر ودول الخليج الأخرى دورا مهما في الجسر الجوي للأفغان بعد الانسحاب الأمريكي من البلاد، فهل من المرجح أن تغلق إدارة “بايدن” قاعدة “العديد”؟ قد يكون تقليصها ممكنا، لكن الإغلاق الكامل غير مرجح.
وسيعمل استمرار تركيز الحزبين على إيران أيضا لصالح وجود عسكري أمريكي كبير. وتشمل التدريبات البحرية المشتركة، التي تجري الآن بهدف احتواء إيران، كلا من الولايات المتحدة وإسرائيل والإمارات والبحرين. كما أنه من غير الواضح إذا كانت القواعد الأمريكية الكبيرة معرضة للهجمات الإيرانية كما يخشى البعض؛ فقطر والكويت، الدولتان اللتان تستضيفان آلاف الأفراد الأمريكيين، تحافظان على علاقات ودية مع طهران. وبالتالي، فإن فوائد تقليص الوجود الأمريكي في المنطقة قد تفوقها التكاليف السياسية للتخلي عن الشركاء الخليجيين.
ويعد تناوب أنظمة الدفاع الصاروخي وحاملات الطائرات خارج الشرق الأوسط علامة على تراجع التركيز الأمريكي في المنطقة، ومن المرجح أن يصبح أكثر تواترا مع تحول الموارد إلى آسيا. ولا يرغب الشركاء الإقليميون في ذلك، لكنهم سيتعلمون كيفية التعايش معه. لكن إغلاق البنية التحتية العسكرية الضخمة هو أمر آخر تماما.
حرب الظل مع إيران
ترى إيران أن استمرار الوجود العسكري الأمريكي في المنطقة يمثل تهديدا لمصالحها. وفي الوقت الذي تسعى فيه طهران إلى تعزيز ردعها، قد تفضل ضرب أعداد محدودة من القوات الأمريكية في مناطق الصراع بدلا من القواعد الأمريكية الكبيرة في الخليج.
وألقى مسؤولون أمريكيون وإسرائيليون باللوم على إيران في شن هجوم بطائرة بدون طيار على قاعدة التنف الأمريكية في سوريا في أكتوبر/تشرين الأول، ربما كرد انتقامي على الضربات الجوية الإسرائيلية في سوريا. كما تراجع عدد القوات الأمريكية في العراق إلى عدة آلاف فقط لكنهم ما زالوا عرضة لهجمات الميليشيات المدعومة من إيران.
وقد أصبح العداء بين الولايات المتحدة وإيران متجذرا بعمق داخل مؤسسات البلدين، لا سيما أن المتشددين عززوا سيطرتهم في طهران، ما يجعل محاولات إعادة ضبط العلاقة أمر غير مرجح في الأعوام المقبلة.
وأدى قرار إدارة “ترامب” بالانسحاب من الاتفاق النووي واعتماد سياسة “أقصى ضغط” المصممة لعزل إيران دبلوماسيا واقتصاديا إلى جعل إيران أكثر عدوانية. وبعد اغتيال الولايات المتحدة للجنرال الإيراني “قاسم سليماني” في يناير/كانون الثاني 2020، انخرط البلدان في صراع عسكري مباشر للمرة الأولى منذ الثمانينات. وحتى إذا تمكن صانعو السياسة الأمريكيون من تجنب حرب شاملة مع إيران واحتواء طموحاتها النووية، فمن المحتمل أن يجدوا أنفسهم في صراع منخفض المستوى مع طهران على النفوذ الإقليمي.
وبالرغم أن إيران حافظت في البداية على امتثالها للاتفاق النووي رغم الانسحاب الأمريكي، إلا أنها وسعت برنامجها بشكل كبير خلال العام الماضي. وقد زادت من تخصيب اليورانيوم إلى ما هو أبعد من قيود الاتفاقية، ما جعلها أقرب إلى مستويات صنع سلاح نووي. ولم يعد المفتشون النوويون يتمتعون بالمزايا التي كانت تنص عليها الاتفاقية. وقد جلبت كل هذه الخطوات مصدر توتر آخر في علاقات إيران مع الولايات المتحدة والمجتمع الدولي.
ولم يكن المسؤولون الإيرانيون في عجلة من أمرهم للعودة إلى محادثات فيينا بعد انتخاب “إبراهيم رئيسي” في يونيو/حزيران 2021. وبالرغم أنهم وافقوا أخيرا على العودة إلى المفاوضات في أواخر نوفمبر/تشرين الثاني، إلا أنه ليس من الواضح إذا كانت إدارة “بايدن” سيكون لديها الرغبة السياسية اللازمة لتخفيف العقوبات من أجل استعادة الاتفاقية أو أن إيران ستوافق على التراجع النووي المطلوب. ومن شبه المؤكد أن إسرائيل لن تدعم التنازلات لإيران.
ويجري المسؤولون الأمريكيون بالفعل مناقشات مع نظرائهم الإسرائيليين حول “الخطة ب” في حالة فشل المحادثات. وستشمل هذه الاستراتيجية المزيد من الضغوط الاقتصادية وربما الخيارات العسكرية. ومن غير الواضح كيف ستؤدي المحادثات إلى اتفاق نووي جديد، لا سيما في غياب الدعم الدولي الذي كان متوفرا قبل اتفاقية 2015.
ومن الصعب تصور توقيع الصين على ضغط اقتصادي جديد على إيران، في ظل تصاعد التوترات بين بكين وواشنطن. وفي الواقع، أعربت الصين مؤخرا عن مواقف أكثر تعاطفا بشأن حق إيران في تخصيب اليورانيوم وذلك في أعقاب قرار الولايات المتحدة والمملكة المتحدة بيع غواصات نووية لأستراليا، الأمر الذي تعتبره بكين يثير خطر انتشار الأسلحة النووية.
وفي حال فشل مساعي إحياء الاتفاق النووي، من المرجح أن نري تكرارا لرد إيران على سياسات اقصى ضغط من قبل إدارة “ترامب”؛ أي تسريع الضربات العسكرية في جميع أنحاء المنطقة بما في ذلك ضد القوات الأمريكية.
وإذا انهار الاتفاق، فسيكون من الصعب على الولايات المتحدة تقليص وجودها في الشرق الأوسط وتحويل تركيزها إلى مكان آخر. ومن المؤكد أن الإسرائيليين لن يقفوا موقف المتفرج. وقد توسعت “حرب الظل” بين تل أبيب وإيران بشكل كبير بالفعل؛ وانتقلت إلى ما وراء المسرح السوري إلى مواجهة بحرية نشطة.
كما تواصلت حملة الاغتيالات التي استهدفت كبار العلماء النوويين الإيرانيين والهجمات المباشرة على البنية التحتية النووية في إيران، بما في ذلك انفجار منشأة “نطنز” النووية الإيرانية في أبريل/نيسان مع بدء الجهود الدبلوماسية في فيينا. كما امتدت الحرب السيبرانية بين إسرائيل وإيران حتى إلى أهداف مدنية.
وتجنب رئيس الوزراء الإسرائيلي “نفتالي بينيت” حتى الآن الخلاف العلني مع واشنطن بشأن الملف الإيراني. لكن بالرغم من أن أسلوبه قد يختلف عن نهج المواجهة الذي اتبعه رئيس الوزراء الإسرائيلي السابق “بنيامين نتنياهو”، فإن سياساته لا تبدو مختلفة بشكل ملحوظ.
وحافظ “بينيت” على الحملة العسكرية الإسرائيلية السرية ضد البرنامج النووي الإيراني. وأدلى قادة إسرائيليون آخرون بتصريحات علنية يعيدون فيها تأكيد حق إسرائيل في الدفاع عن نفسها ضد إيران، وهو ما يفهم على نطاق واسع على أنه إعلان من إسرائيل بشأن احتمال اللجوء إلى الخيارات العسكرية.
ولا تعد إسرائيل حليفا في معاهدة مع الولايات المتحدة، لكن الالتزام السياسي الأمريكي بأمن إسرائيل عميق جدا بحيث يصعب على واشنطن البقاء على الهامش في حالة نشوب صراع شامل بين إيران وإسرائيل.
وأظهرت حرب غزة الأخيرة في مايو/أيار أن الولايات المتحدة يمكن أن تعمل خلف الكواليس لاحتواء الصراع، لكنها لا تستطيع تجاهله. ويعد التطبيع بين إسرائيل والدول العربية تطور إقليمي مرحب به أمريكيا، لكنه لا يمكن أن يحل محل التسوية بين أطراف في حالة حرب بالفعل.
أن تصبح جزءًا من الحل
ومع كل هذه المطالبات، لن تتخلى الولايات المتحدة عن الشرق الأوسط. وفي الواقع، قد تواجه مشكلة مختلفة، ليس أن تغادر، بل أن تبقى في الأماكن الخطأ.
ويبدو أن إدارة “بايدن” تضاعف من التزاماتها العسكرية لطمأنة شركائها الذين ما زالوا متشككين بشأن مسار سياستها الخارجية. وتعد مبيعات الأسلحة إلى السعودية والإمارات دليلا على أن واشنطن لا تزال تعطي الأولوية لشراكاتها العسكرية في المنطقة. لكن هذه الجهود يمكن أن تؤجج الصراعات الإقليمية والقمع.
وتستثمر الولايات المتحدة حاليا سنويا في المساعدة العسكرية لمصر بقدر ما تستثمره في مساعدات التنمية الاقتصادية للمنطقة بأكملها. وهذه وصفة لأزمة دائمة ستجبر الولايات المتحدة على اتخاذ خطوات مكلفة لاحتواء أشكال جديدة من التطرف والعنف.
وتتمثل أفضل طريقة للمضي قدما في استغلال فرصة إعادة التوازن الإقليمي لتقليص الالتزامات العسكرية وزيادة المساعدة الاقتصادية والإنمائية. وتحتاج الولايات المتحدة إلى إعادة تركيز انتباهها ومواردها على التحديات التي تؤثر على الحياة اليومية للناس. ويعد بناء القدرة على الصمود في مواجهة تغير المناخ في منطقة تعاني بالفعل من ضعف البنية التحتية، وتوسيع الفرص للشباب، من القضايا المهمة التي يجب أن تتصدر جدول الأعمال عندما يزور المسؤولون الأمريكيون الشرق الأوسط.
وفي هذه اللحظة من التغيرات الاستراتيجية، لدى الولايات المتحدة فرصة للقيام بالأشياء بشكل مختلف. وبدلا من الاستثمارات العسكرية الضخمة، يمكنها الاستثمار في حلول للتحديات الاجتماعية والاقتصادية والحوكمة التي تمنح مواطني المنطقة حياة أفضل وبالتالي تقلل احتمالات الاضطراب والتطرف الذي يغذي الصراعات.
ويمكن للولايات المتحدة، إلى جانب حلفائها الأثرياء، مساعدة الشركاء الذين يريدون تحويل المنطقة من مجموعة من المشاكل إلى مجموعة من السيناريوهات الإيجابية. وفي كل الأحوال، لن تنفصل الولايات المتحدة عن الشرق الأوسط، لكن على واشنطن أن تغتنم الفرصة لتكون جزءا من الحل وليس جزءا من المشكلة.
المقال من اختيار مشرف الصفحة الدولية الاستاذ مجدي منصور
رابط الموضوع: اضغط هنا