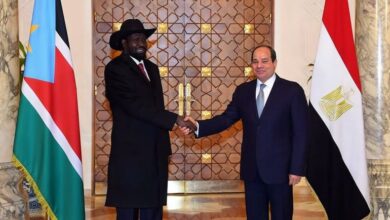أي مستقبل ينتظر السودان في عشريته القادمة؟ | كتب د. محمد حسب الرسول
قراءة في معطيات المسرح السوداني واستشراف مشاهده المستقبلية

مدخل:
السودان دولة ذات تاريخ ضارب في القدم، وهي من أهدت البشرية حضارة وادي النيل التي تعد واحدة من أهم وأقدم الحضارات في العالم، تلك الحضارة التي عبّرت عن مجتمع وادي النيل وعن ممالكه المختلفة التي أسست مع رصيفاتها في بابل والصين واليونان للانتقالات الحضارية الكبرى التي شهدتها المعمورة منذ آلاف السنين وحتى يومنا هذا.
إن جغرافيا السودان، كما هو تاريخه وحضارته، صنعت أهميّته ومكانتة ودوره الاستثنائي على المستويين الاقليمي والدولي، فالسودان يقع على ساحل البحر الأحمر بامتداد يبلغ نحو 800 كيلومتر، هذا الساحل الطويل جعله على تماس وتفاعل مع الحركة التي تمر جيئة وذهاباً فوق مياه هذا البحر العربي ذو الأهمية الاستثنائية التي اكتسبها من الأنشطة التجارية والثقافية والعسكرية وغيرها من الأنشطة التي تحفل بها مياهه وسواحله، وقد أهلّه موقعه على شاطئ هذا البحر ليكون حلقة الوصل بين ساحله وبين الساحل الشرقي للمحيط الأطلسي، وهو بذلك يربط شرق الدنيا بغربها، ويسهم السهل الثقافي والتاريخي الموصول بين السودان وبين دول غرب أفريقا في تعزيز هذا الربط، وتلك الصلات، ويعزز ذلك، جريان نهر النيل شمالاً نحو مصر والبحر الأبيض ليجعل أواصر الصلات بين شرق ووسط أفريقيا وشمالها حقيقة قائمة وماثلة.
إنّ حقائق الجغرافيا والتاريخ قد جعلت للسودان أهمّية كبيرة على المسرح الاقليمي والدولي، وفي إفادة وزير الأمن الصهيوني الأسبق آفي ديختر في محاضرته التي ألقاها في شهر آب/أغسطس 2008، في معهد أبحاث الأمن القومي الإسرائيلي عن الاستراتيجية الإسرائيلية في المنطقة إعترافاً بمكانة السودان ودوره ورسالته التاريخية.
في تلك المحاضرة تناول ديختر الرؤية الاستراتيجية للكيان الصهيوني تجاه 7 دول، هي فلسطين ولبنان وسوريا والعراق وإيران ومصر والسودان، ولخّص الرؤية الاستراتيجية الصهيونية تجاه هذه الدول في مقولته: “إن إضعاف تلك الدول واستنزاف طاقاتها وقدرتها هو واجب وضرورة من أجل تعظيم قوة إسرائيل، وترسيخ منعتها في مواجهة الأعداء، وهو ما يحتم عليها استخدام الحديد والنار تارة، والدبلوماسية ووسائل الحرب الخفية تارة أخرى”.
وقال ديختر إن السودان بموارده الكبيرة وبمساحته الشاسعة، من الممكن أن يصبح دولة إقليمية قوية منافسة لدول مثل مصر والعراق والسعودية، وإنه يشكل عمقاً استراتيجياً لمصر، وهو ما تجسّد بعد حرب 1967، عندما تحول إلى قواعد تدريب وإيواء لسلاح الجو المصري والقوات الليبية، كما أنه أرسل قوات مساندة لمصر في حرب الاستنزاف عام 1968. وبناء عليه، وبحسب ديختر فإنه:
– لا يجب السماح لهذا البلد بأن يُصبح قوةً مضافةً إلى قوة العرب.
– لا بدَّ من العمل على إضعافه وانتزاع المبادرة منه لمنع بناء دولة قوية موحدة فيه.
– يلزم إضعافه، فسودان ضعيف ومجزأ وهشّ أفضل من سودان قوي وموحّد وفاعل.
ويلخص هذا الحديث التوجه والمنظور الاستراتيجي الصهيوني للسودان، كما يعبر كذلك، عن التوجه الغربي تجاه السودان، هذا التوجه الذي تقتضيه ضرورات الأمن القومي الإسرائيلي. في ذات الوقت، يقدم هذا التلخيص مادة مهمّة لا غنى عنها في قراءة المشاهد السياسية في السودان في حقبه المختلفة وبخاصة هذه الحقبة التي بدأت قبل سقوط نظام البشير وامتدت خلال الفترة الانتقالية التي أعقبت ذلك السقوط.
إنّ السودان بموقعه الجيوستراتيجي، وبتاريخه الحضاري والسياسي، وبمكنوناته وثرواته، وبقدرته على التأثير في محيطه الحيوي، يشكل حالة خاصة بمعايير القوة الاستراتيجية، فقدراته المكتشفة والكامنة، المادية منها والمعنوية، تشكل عناصر قوة استراتيجية كبيرة، وقد خلص الكيان الصهيوني إلى ذلك وأدركه، ولهذا فإنّ قراءة حاضر السودان ومستقبله تتطلب استصحاب كل ذلك، كما تتطلب الإحاطة الدقيقة بمعطيات الحاضر، للاستفادة من ذلك في تقديم قراءة استشرافية لمستقبل السودان خلال العشرية القادمة من عمره، ويشكل ذلك هدفاً لهذا المقال الذي يتوسل بمنهج دراسة المستقبلات ومنهج بناء المشاهد، ليقدم قراءة منهجية لما ينتظره من مستقبل.
معطيات المشهد السوداني بعد تغيير 2019
عرف السودان قبل غيره من دول الاقليم، تغيير نظم الحكم فيه، عبر الحراك الشعبي الذي حمل اسم ثورة حيناً، ومسمى انتفاضة حينا آخر، ولقد أحدث الحراك الشعبي تغييراً لنظام الفريق إبراهيم عبود في 21 أكتوبر/ تشرين أول 1964، وصنع تغييراً أطاح فيه بنظام المشير جعفر نميري في 6 أبريل/ نيسان 1985، ثم أحدث تغييراً في 11أبريل/ نيسان 2019 أطاح فيه بنظام المشير عمر البشير.
أعقب كل تغيير حدث في السودان فترة إنتقالية قصيرة، يحتدم فيها الصراع بين الأحزاب السياسية، ويبلغ فيها التنافس أعلى درجاته، وترتفع خلالها مستويات التعبير عن خطاب الاقصاء والكراهية، ومع كل ذلك البؤس السياسي والحزبي، فإنّ حالات الاستنصار بالخارج على شركاء الوطن لم تكن حاضرة، فقد كان “عيباً” معروفاً تجتنبه الأحزاب، ويتحاشاه الساسة، غير انّ الفترة الانتقالية التي يعيشها السودان منذ نحو أربع سنوات قد فاجأت الوطن وفجعته بمستوى الحضور والنفوذ الخارجي الذي ميّز هذه الفترة عن غيرها من فترات الانتقال التي سبقت.
لقد شكل التدخل الخارجي أعلى درجات الخطر على السودان، وعلى أمنه، واستقراره، وعلى استقلاله الوطني، حتى فقدت البلاد ذلك الاستقلال أو كادت، وقد فتحت الشراكات التي قامت بين بعض الفاعلين على المسرح السياسي وبين المشروع الغربي في امتداه العربي وعمقه الغربي، فتحت أبواب السودان على مصراعها أمام التدخل الخارجي، فبات الخطر الأبرز الذي يتهدد البلاد ضمن قائمة معطيات هذه المرحلة التي يمكن إبراز بعضها في ما يأتي:-
أولاً: التدخل الخارجي
التدخل الخارجي هو أول معطيات مشهد الفترة الانتقالية في السودان وأكثرها تعقيداً، ومن شواهد هذا التدخل:-
1) تدخل الدول الاقليمية والغربية
– تخلي بعض دول الخليج عن نظام الرئيس السابق عمر البشير، الذي ناصرها في مشروعاتها الاقليمية، وشاركها في مواقفها وحروبها، وبشكل خاص في حرب اليمن، وقيامها باستكمال حلقات الحصار علي السودان، وبخاصة في الجانب الاقتصادي، الأمر الذي أفقد ذلك النظام ما تبقى عنده من قدرة يقابل بها التحديات الاقتصادية التي كانت سبباً مباشراً من أسباب الرفض الشعبي لذلك النظام وسبباً مباشراً في الاطاحة به.
– رعاية بعض الدول لبعض معارضي النظام السابق، وتوفير الدعم السياسي والاعلامي والمادي لهم، وتنسيق جهودهم مع بعض القادة العسكريين الذين ربطتهم صلات بهذه الدول، وتنسيق جهود مدنيين وعسكريين مع الحلفاء الغربيين، وبخاصة في أوروبا.
– رعاية بعض دول الاقليم وبعض الدول الأوروبية للتحالف المدني العسكري، وإشرافها على تشكيل السلطة الانتقالية وإشرافها على إعداد الوثيقتين السياسية والدستورية اللتّان تأسست عليهما السلطة الانتقالية ومؤسستيها الرئيستين، مجلس السيادة ومجلس الوزراء.
– رعاية هذه الدول لمسيرة السلطة الانتقالية، وتدخلاتها المباشرة في تذليل بعض الصعاب المالية التي واجهتها، والمساهمة في تعزيز علاقات السلطة الانتقالية بالدول الغربية وبالمنظومات الدولية، ومساهماتها في إعادة هندسة الأوضاع في مؤسسات الدولة عامة، وفي مؤسساتها ذات الطابع السيادي بصفة خاصة.
– رعاية رئاسة مجلس الوزراء، وتوفير السند اللوجستي والفني لها، وتكفل منظمات أوروبية بدفع مرتبات رئيس الوزراء عبد الله حمدوك وكبار مستشاريه ومعاونية (على النحو الذي نشرته مؤسسات اعلامية)، في مخالفة لكل قواعد السيادة ومقتضيات الأمن القومي للدول.
– مساعي دولة اقليمية، وسعيها المتكرر للسيطرة على الساحل السوداني على البحر الأحمر، وعلى الموانئ القائمة عليه والتي يخطط لبنائها، ومساعيها الدؤوبة لوضع يدها على واحدة من أخصب الأراضي الزراعية في السودان تقع في شرق السودان، وتتجاوز مساحتها مليون فدان، وتتمتع هذه المنطقة باهتمام صهيوني كبير لأسباب تتعلق بموقعها الجغرافي، وكبر مساحتها الجغرافية، وخصوبة أرضها، وتوفر المياه بها، ولأسباب دينية تتصل بالمثيولوجيا الصهيونية.
2) التطبيع مع الكيان الصهيوني
تبني رئيس مجلس السيادة الفريق أول عبد الفتاح البرهان ونائبه محمد حمدان حميدتي، ورئيس الوزراء عبد الله حمدوك لمشروع التطبيع، ثم تنافسهم عليه، فبعد مقابلة برهان لنتنياهو في يوغندا بدأت مظاهر التنافس حول التطبيع بين ثلاثتهم، ومن مشاهد هذا التنافس:-
– بادر مجلس الوزراء برئاسة عبد الله حمدوك إلى اتخاذ بعض الخطوات التطبيعية الكبيرة، حيث استصدر قراراً من مجلس الوزراء ألغى بموجبه قانون مقاطعة “إسرائيل” لعام 1968، ثم قرر التوقيع على اتفاقية ابراهام وفوض وزير العدل الذي وقع على الاتفاقية، وصاحب ذلك قيام مجلس الوزراء بتغيير المناهج الدراسية لتتماشى مع مطلوبات التطبيع، فحُذِفت منها كل ماله صلة بالقضية الفلسطينية، بل حذفت كل مادة ذات صلة بالتحرر والاستقلال الوطني، وبلغ الحال حد حذف المقررات الدراسية الخاصة بالثورة المهدية التي صنعت استقلال السودان الأول في القرن التاسع عشر.
– مشاركة رئيس مجلس الوزراء ، ورئيس مجلس السيادة في القمة الرباعية التي جمعتهما برئيس الوزراء الصهيوني والرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب في آواخر حقبة حكمه.
– أوفد قائد الدعم السريع أخيه إلى تل أبيب لفتح آفاق تعاون ثنائي بين قواته والكيان الصهيوني، وسعي الطرفين إلى تأسيس علاقات متعددة الأوجه بينهما، مع إعطاء خصوصية للعمل المشترك في المجال الزراعي حيث دار الحديث حول طرح مشروع ضخم يقع غرب نهر النيل للاستثمار المشترك.
3) البعثة الأممية للسودان “يونتامس”
بتاريخ 28 يناير/كانون الثاني 2020، بعث عبد الله حمدوك رسالة مكتوبة إلى الأمين العام للأمم المتحدة طالباً فيها التالي:
– تشكيل بعثة سياسية خاصة للسودان، تضم عنصراً قوياً، وتشمل ولايتها الجغرافية كامل أراضي السودان، ويمتد نطاقها الزمني حتى يحقق السودان أهداف التنمية المستدامة بحلول 2030، على أن تكون ذات نهج مبتكر ومنسق ويتسم بالمرونة والسلاسة، وينبغي استخدام عناصر أساسية وإتباع نهج نموذجي من هذا القبيل عند تصميم تواجد الأمم المتحدة، وأن يوسع فريق هذه البعثة عملياته من حيث الحجم والنطاق ليكون على مستوى الغرض المنشود، وأن يكون تواجد الأمم المتحدة في السودان متكاملاً، ومتوائماً من الناحية الاستراتيجية وتحت قيادة واحدة، وأن يجري الأمين العام إصلاحات لركائز البعثة .
– أن يكون من مهام البعثة: دعم تنفيذ الإعلان الدستوري “الدستور الانتقالي”، والرصد المنتظم لتنفيذ نقاطها المرجعية الرئيسية؛ الاضطلاع بعمليات الاصلاح القانوني والقضائي، اصلاح قطاع الأمن “الجيش، والشرطة، والأمن”، إصلاح الخدمة المدنية، وضع الدستور الدائم، ودعم جهود السلام و دعم إعادة المشردين داخلياً واللاجئين إلى أوطانهم وإعادة دمجهم.
استجاب الأمين العام للأمم المتحدة إلى طلب رئيس الوزراء الانتقالي، وشكل مجلس الأمن الدولي بناءً على هذا الطلب بعثة سياسية أممية للسودان حملت الاسم المختصر “يونتامس”، وذلك في 4 يونيو/ حزيران 2020، بالقرار رقم2524، ثم عين الألماني فولكر بيرتس الذي عمل مع بول بريمر في العراق إبان الإحتلال الأمريكي له، ثم عمل مستشاراً لمبعوث الأمين العام للأمم المتّحدة لسورية خلال الفترة 2015- 2018، كما عمل أستاذاً بجامعة هومبولت ببرلين، وأستاذاً مساعداً في الجامعة الأميركية في بيروت من 1991- 1993، وترأس مجموعة أبحاث الشرق الأوسط وأفريقيا حتى أبريل/ نيسان 2005، وعمل مديراً للمعهد الألماني للسياسة الدولية والأمن، وله كتاب بعنوان “نهاية الشرق الأوسط الذي نعرفه”، ولعل في السيرة الذاتية لرئيس البعثة الأممية بخبراته في العراق وسورية، وخبراته الأخرى عنواناً لطبيعة المهمة التي اختير لها في مهمته الجديدة في السودان.
أخفى رئيس الوزراء هذه الرسالة عن مجلس السيادة، وأحاطها بقدر عال من السرية، وتبين لاحقاً ان بريطانيا هي صاحبة مشروع البعثة، وأن السفير البريطاني في السودان هو من صاغ الرسالة، وأنه قد طلب من رئيس الوزراء الذي يحمل الجنسية البريطانية إرسالها بتوقيعه إلى أمين عام الأمم المتحدة وقد أعلن السفير ذلك. وقد روج مناصري رئيس الوزراء من الساسة ومن بعض الدبلوماسيين الغربيين أن هذه البعثة ستحقق أهدافاً كبيرة، من بينها تقليم أظافر المؤسسة العسكرية، وصناعة معادلة جديدة لصالح رئيس الحكومة وحاضنته السياسية، ولهذا لم ترفض الحاضنة السياسية هذه البعثة بكل ما يحمله وجودها ومهامها من مخاطر كبيرة تستهدف سيادة البلد واستقلاله.
يتضح من طبيعة البعثة التي جاء تفصيلها في رسالة رئيس الوزراء، أنّها بعثة سياسية وشاملة من حيث التكوين، وأن لها قيادة واحدة تجتمع تحت امرتها كل المؤسسات الأممية، وأن نطاق ولايتها يشمل كل السودان، وأن أجلها الزمني يمتد لعشر سنوات هي عدد سنوات الفترة الانتقالية المقترحة من تحالف الحرية والتغيير الذي كان حاكماً في الفترة من 2019 إلى 2021، وأن الرسالة قد منحت الأمين العام للأمم المتحدة تفويضاً لتطوير البعثة تحت مسمى الإصلاح، كما ان البند الأول في مهام هذه البعثة الوراد تحت صيغة دعم تنفيذ الاعلان الدستوري قد وضع البعثة في مرتبة أعلى من كل مؤسسات الفترة الانتقالية وبخاصة مجلسي السيادة والوزراء، حيث منح هذا البند الحق للبعثة في مراقبة أداء المجلسين، وومارسة عمليات المتابعة والتقييم لأعمالهما، وتصويب تلك الأعمال من موقع الوصاية المسنودة بقرار أممي.
بالنظر لمهام البعثة وفق رسالة عبد الله حمدوك والتي اعتمدها القرار الأممي المنشئ للبعثة، فإنّ تلك المهام تُمكن البعثة وبشكل كامل من ممارسة الوصاية والإنتداب على السودان، وهذا الذي ثبت إلى حد كبير خلال فترة عملها، ومن خلال ممارساتها العملية، كما ان مهام البعثة تشمل بشكل مباشر إعادة هندسة أوضاع الدولة تحت مظلة إصلاح مؤسساتها التي وردت ضمن المهام، وهو الذي تمت ترجمته بشكل عملي من خلال تفكيك بعض مؤسسات الدولة، وعبر إضعاف المؤسسات التي لم يطالها التفكيك، ومن خلال عمليات الإحلال والإبدال التي طالت كوادرها، حيث شهدت فترة حكومة عبد الله حمدوك الأولى والثانية فصل وتشريد آلاف الكفاءات الوطنية التي تمرست في العمل، وتشبعت بقيمه وتقاليده، واكتسبت وراكمت عبر عقود من الزمن خبرات كبيرة تم استبدالها بأصحاب الولاء السياسي وببعض الذين جاء بهم التغيير من خارج الحدود.
لم تكن مهام البعثة التي جاءت في رسالة رئيس الوزراء وتضمنها قرار مجلس الأمن الذي أنشأ هذه البعثة، مصوبة فقط نحو إعادة تشكيل مؤسسات الدولة على نحو جديد يخدم هدف صناعة حاضر جديد للدولة السودانية تحت قيادة البعثة الأممية من خلال عمليات الفك والتركيب التي طالت المؤسسات، إنما مكّنت هذه المهام البعثة من صناعة مستقبل السودان عبر وضع الدستور الدائم للبلاد، وسن قوانيين جديدة بعيداً عن الإرادة الوطنية، وبمنأى عن تطلعات المواطنيين ووجدانهم وهويتهم التاريخية والحضارية، علماً بأن للسودان خبرات وتجارب دستورية غنية جداً استفاد منها الاقليم بأثره، حيث كتب بعض الخبراء السودانيين كل الدساتير التي حكمت بلادهم منذ عام 1953 وحتى دستور 2005 الذي تم تعليق العمل به في 11 أبريل/ نيسان/ 2019، وأن بعض خبرائه قد كتبوا دساتير دول عربية وآسيوية، وان القانونيين من أبنائه قد أسسوا عدداً من المنظومات العدلية، وصاغوا قوانيين دول كثيرة سيما في دول الخليج، وأن أساتذة القانون السودانيين قد درسوا في جامعات كثيرة في محيط السودان العربي والافريقي وتخرجت على أيديهم أعداداً كبيرة من دارسي القانون.
إنّ التدخل الخارجي في الشأن السوداني خلال هذه الفترة الانتقالية قد أفضى إلى تحويل طبيعة الصراع السياسي في السودان إلى صراع بين مشروع الاستقلال الوطني ومشروع الهيمنة الغربية على البلاد، وأعاد البلاد إلى مرحلة ما قبل الأول من يناير/ كانون أول/ 1956 تاريخ استقلال السودان، الأمر الذي أدركه المجتمع وبدأ في حشد طاقاته لمقابلة هذا التحدي الذي استجد.
إنّ “الاستعمار” كما هو عهده وتاريخه، ليس حريصاً على الديموقراطية في “مستعمراته”، فطفق عبر تاريخه الطويل في تنصيب الحكام وفي فرض الأنظمة، متجاوزاً حق الشعوب في اختيار حكامها، وفي بناء نظم الحكم، ضارباً عرض الحائط بحقوقها المشروعة في الحكم الديموقراطي الذي يتأسس على الانتخاب والاختيار الحر، والذي يؤسس في الآن عينه لتداول سلمي للسلطة. وكما سعى في تاريخه إلى فرض قيادات على شعوبها طوال الحقبة الكولنيالية، فإنه لم يدرك بعد خطل ذلك الصنيع، ويريد أن يستمر في استدامة ذلك النموذج في غير قُطر، وعمل وما يزال منذ بداية الفترة الانتقالية وحتى الآن على فرض قيادة وتنصيب حكام يخدمون مصالحه، ويخاطبون أجندته، ويخطبون وده، ويستوى في ذلك عنده المدني والعسكري حين يتوفر الولاء، وهذا الذي أطال أمد الفترة الانتقالية، وأضعف الدولة، وقسم المجتمع، وجعل الاستحقاق الانتخابي استحقاقاً صعب المنال.
ثانياً: تفكيك مؤسسات الدولة
ثمة تشابه بين حال السودان في هذه الفترة الانتقالية، وبين حال العراق بعد احتلاله في عام 2003، ويُعدُ تفكيك الدولة والمجتمع، وممارسة الهيمنة والوصاية الأجنبية من أهمّ أوجه الشبه بين البلدين، ومثلما فكك الاحتلال الأمريكي مؤسسات الدولة العراقية في عهد بول بريمر، فإنّ مؤسسات الدولة في السودان المدنية منها والعسكرية قد تعرضت إلى التفكيك والاضعاف من قبل السلطة الانتقالية في عهد رئيس البعثة الأممية إلى السودان فولكر بيرتس كما جاء ذكره آنفا.
لم تكن الخدمة المدنية وحدها التي طالها العبث والاضعاف والتفكيك، إنما طال كذلك مؤسسة الجيش، ومؤسسة الشرطة، وبقية المؤسسات النظامية، التي فصل منها آلاف الضباط، وأطلقت الحملات الاعلامية والسياسية لتفكيكها واستبدالها بالمكونات العسكرية للحركات المسلحة، وقد نالت تلك الحملات من معنويات هذه المؤسسات وأثرت سلباً على أدائها، فتراجعت درجات الأمن والأمان في معظم أنحاء البلاد، وأصيب الأمن القومي في منعته وقوته.
لقد برزت إلى السطح ظاهرة إعادة رسم خريطة السودان على نحو جديد، بعد أن وقعت السلطة الانتقالية بشقيها المدني والعسكري على اتفاقية جوبا للسلام مع الحركات المتمردة في دارفور والنيل الأزرق في اكتوبر/ تشرين أول 2020، حيث ابتدعت ولأول مرة ما عُرف في هذه الاتفاقية بالمسارات الخمس، التي قسمت السودان إلى خمسة أقاليم ومنحت كل إقليم/مسار نصيباً من السلطة والثروة على المستويين الاتحادي والاقليمي، وهو ما يؤشر إلى مستقبل جديد للسودان عنوانه الأبرز هو التفكيك، ويعد ذلك من أخطر ما تضمنته الاتفاقية.
وبالتزامن مع ذلك تزايدت وتيرة المطالبة بانفصال أجزاء من السودان، حيث تعالت دعوات انفصال في شرق السودان، وفي شماله، وفي أنحاء أخرى من السودان، كما تعالت أصوات تنادي بفصل أجزاء من السودان إلتحق بعضها به في مطلع القرن العشرين، وأجزاء أخرى شعر أصحاب الدعاوى أنها تمثل تهديداً لاستقرار السودان، وتتضمن هذه الدعاوى مشروعاً جديداً يحصر حدود الدولة بين النهر والبحر في إشارة إلى المنطقة الواقعة بين نهر النيل والأنهر التي تصب فيه وبين البحر الأحمر.
لقد منحت اتفاقية جوبا كذلك هذه الحركات حق الاحتفاظ بجيوشها لعشر سنوات قادمة، وحق اقامة قواعد عسكرية لها في الخرطوم وعدد من العواصم والمدن الولائية، الأمر الذي جعل ظاهرة تعدد الحركات المسلحة أكبر مهدد للأمن القومي السوداني، وأخطر مهدد لأمن المواطنيين في معظم أنحاء السودان.
إن خلاصة عمليات التفكيك قد بدت أكثر وضوحاً في انقسام الرأي العام حول قضية الوحدة والتفكيك وما يتصل بها من رؤى لتشكيل كيانات سياسية جديدة على أنقاض الدولة الموحدة، وتجلت آثار التفكيك في العجز الذي أصبح سمة من سمات مؤسسات الدولة المختلفة التي باتت عاجزة عن القيام بأدوراها الطبيعية، فانعدم الأمن أو كاد في العاصمة والولايات، وتردى مستوى خدمات الصحة والمياه والكهرباء، وتدهورت خدمات التعليم العام، وتوقفت خدمة التعليم العالي، حيث ظلت الجامعات الحكومية مغلقة منذ أن شكل عبد الله حمدوك وحاضنته السياسية الحكومة الانتقالية الأولى في عام 2019، واستمرت مغلقة حتى قيام المفاصلة بين شركاء السلطة الانتقالية في 25/أكتوبر/تشرين أول/2021، ففقد طلاب الجامعات 3 سنوات من عمرهم بسبب عجز السلطة الانتقالية، والأدهى والأمر هو حل المحكمة الدستورية التي صنع الفراغ الذي تركته ضياعاً لحقوق الناس واهداراً لكرامتهم الانسانية، وأصاب العدالة بالشلل.
ثالثاً: الإنهاك الاقتصادي
تبنت السلطة الانتقالية ممثلة في مجلس الوزراء والحاضنة السياسية المشروع النيولبرالي بكل أبعاده، كما تبنت وصفات المؤسسات المالية الدولية ممثلة في البنك الدولي وفي صندوق النقد الدولي، فاستكملت السلطة الانتقالية دون رحمة، عملية تحرير الاقتصاد، فألغت الحكومة الدعم الذي كان قائماً في قطاعات الصحة والتعليم، الكهرباء، المياه، الغذاء، والمحروقات، وخفضت قيمة العملة الوطنية، فأصبحت قيمة الدولار الأمريكي تساوي نحو 600 جنيه بعد أن كان يساوي نحو 60 جنيهاً، وارتفع التضخم إلى عشرة أضعاف ما كان عليه، وأصبحت الحياة قاسية إن لم تكن مستحيلة. وقد أسهم تدهور الأوضاع الاقتصادية في زيادة النفوذ الخارجي، وفي زيادة مستوى تأثيره على القرار الوطني، حتى بات السودان دولة بلا سيادة وبلا استقلال، كما أسهمت هذه الأزمة الاقتصادية في دفع خطى تنفيذ مشروع التغيير الاجتماعي والقيمي، وزادت نسب الطلاق والتفكك الأسري، وازدادت معدلات الانحلال الأخلاقي، ودخلت أنماط ثقافية جديدة لم يعرفها المجتمع السوداني من قبل، وزادت معدلات الاخلال بالأمن.
رابعاً: الانقسام والتهافت السياسي
شهدت هذه الفترة حالة من الانقسام العمودي بين القوى السياسية، وتبلور هذا الانقسام في بروز تحالف سياسي يرى أن معالجة أوضاع السودان لا تتم دون معالجة علاقاته مع الغرب، وان الأمل في نهوض الدولة لا يتحقق دون علاقة مميزة مع الغرب، وأن الطريق إلى المستقبل يمر عبر الغرب، وأن الحل يكمن في اتباع النموذج الغربي، في الثقافة والسياسة و الاقتصاد والتعليم والقانون والاجتماع والفنون، وان استدامة النماء والنهوض لا تتأتى إلا بغرس النموذج الغربي في التربة السودانية، ولهذا يعول هذا التحالف -الذي انفرد بحكم السودان خلال الفترة الانتقالية- على الشراكة بينه وبين الغرب وشركائه في بعض دول الخليج، وهنا تجدر الاشارة إلى أمرين، أولهما أن هذا التحالف المكون من 4 أحزاب قد استلفت أحزابه من قبل النموذج اللائكي من الغرب وتبنته، والأمر الثاني أن نظرية هذه الأحزاب الاقتصادية تأسست على الفلسفة الاشتراكية التي هي نقيض لفلسفة الغرب الرأسمالي، وفي تجربة حكمها تبنت فلسفة الغرب الاقتصادية ضمن تبنيها للمشروع النيولبرالي، وهنا يبزر التناقض الذي يولد أسئلة كبرى تدور حول كيفية الجمع بين مشروعين نقيضين، وتدور حول مكانة الاستقلال الوطني وقيمته في مخيلة ومشروع هذا التحالف.
في مقابل هذا التحالف الذي تحولت أحزابه من الناحيتين الفكرية والسياسية، بدأ المجتمع في بناء منظومة أخرى ترى ان النهضة تتم بالاعتماد على الذات ومن خلال استلهام نوذج يبني على الصالح من ارث السودان و تجربته في المساقات الثقافية والقيمية والسياسية والاقتصادية، مع عدم التجافي عن العالم الخارجي بل اقامة علاقات تبادل تقوم على الندية والكرامة الوطنية، وترعى المصالح المشتركة باستقلال ودون التفريط في السيادة.
يعتبر طغيان الصبغة والملامح الوطنية السمة المائزة لهذه المنظومة التي بدأت في التشكل من مكونات المجتمع الرئيسة، ممثلة في الطرق الصوفية، والكنائس، والقبائل، والرموز والشخصيات الاجتماعية، وغالب الأحزاب الوطنية، لكن ثمة تحديات كبيرة تواجه هذه المنظومة الجديدة، أولها تعريف هوية هذه المنظومة، وتحديد طبيعتها والتوافق عليها، وهذا أكبر هذه التحديات التي تواجه مكوناتها في لحظات التأسيس، لأنها إن مضت في التشكل لتصبح حزباً أو تحالفاً سياسياً فإنها لن تشكل الاضافة النوعية المنتظرة منها، وفي السودان ما يربو على مئة حزب، وفيه عدداً من التحالفات يتجاوز عدده عدد أصابع اليدين. المطلوب أن تتألف مكونات هذه المنظومة على أطروحة وطنية جديدة تزاوج بين القيم والعلم، وخلاصة التجارب والعبر، وان تتأسس كمنصة وطنية تتعاطى مع التحديات والاستحقاقات من منطلق وطني لا منطلق سياسي أو حزبي، وهذا الذي ترى ملامحه في معادلة التحدي والاستجابة والتدافع خلال السنوات الثلاث الماضية، وبدأت في التبلور أكثر خلال العام الأخير من عمر المرحلة الانتقالية، ثم على مكونات هذه المنظومة الانخساف فيها ومفارقة القديم إلا بالقدر الذي يمكن من استخلاص العبر والاستفادة منها.
خامساً: إنهاك وتفكيك المجتمع
شهدت هذه المرحلة محاولات محمومة لتقسيم المجتمع السوداني وانهاكه وتفكيكه على نحو لم يعرفه المجتمع في أحلك الظروف التي مرت به في تاريخه الطويل، وذلك عبر إفتعال المشاكل بين مكونات المجتمع المختلفة، ومن خلال اشعال الصراعات والحروب القبلية، واستثارة النعرات المختلفة، فنشأت جراء ذلك صراعات قبّلية وجهوية في شرق السودان الذي ظل آمناً مستقراً تتعايش فيه الاثنيات وتأتلف وتتداخل وتتصاهر في تفاعل حضاري بديع، فتحول كل ذلك إلى حروب وصراعات أُريقت خلالها دماء بعض أبناء هذا الاقليم.
تكررت تلك الصراعات في كردفان، ثم في دارفور التي ظلت آمنة منذ اتفاقية الدوحة للسلام التي وقعتها الحكومة مع غالب الحركات المسلحة عام 2011، وانتقلت الصراعات القبلية كذلك إلى النيل الأزرق، وإلى أطراف السودان الأخرى في تطبيق عملي لنظرية شد الاطراف وضرب المركز التي أنتجتها الكيان الصهيوني وجعلها سياسية من سياساته في الاقليم.
وفي ذات السياق، غزت جماعات سياسية وثقافية مرتبطة بالغرب وتحمل أطروحاته القيمية والثقافية المجتمع السوداني، وبذلت جهوداً كبيرة لضرب منظومة قيم المجتمع التاريخية، واستبدالها بالقيم الغربية، وفي ذلك، كان التركيز كبيراً على الأسرة التي استهدفت بالاضعاف والتفكيك ، كما كان التركيز كبيراً على شريحة الشباب التي تم استهدافها بالمخدرات، واستهدافها بنماذج قيمية تصادم قيم المجتمع التاريخية، ويُعد نموذج الشذوذ الجنسي من هذه النماذج التي بذلت جهوداً كبيرة من أجل ترسيخ وجودها في المجتمع برعاية ودعم حكومي.
وبرغم حالات الانهاك والتقسيم التي ضربت المجتمع السوداني خلال الفترة الانتقالية، إلا أنه بدأ في امتصاص الصدمات ومن ثمّ شرع في تأسيس مواقف وطنية يقارع بها الخطوب والمخاطر التي واجهته، ولمقابلة تحدى الاستقلال الوطني نشأت حركة مجتمعية فاعلة تناهض وجود البعثة الأممية، وتدعو إلى اخراجها من البلاد، وإلى استعادة السيادة والاستقلال الوطني.
وفي مقابل تحدي إعادة الهندسة الاجتماعية والقيمية، نهض المجتمع فقاوم مشروع تغيير المناهج الدراسية، وناهض مشروع الانقلاب القيمي الذي اعتمد على بعد قانوني سنت حكومة عبد الله حمدوك لأجل تحقيقه قوانين جديدة، وعدّلت قوانين وألغت أخرى. وقد ناهض المجتمع وكافح مشروع الغزو الثقافي الذي يعمل على استبدال قيم المجتمع بقيم بديلة مصادمة لوجدان المجتمع وموراثاته .
وليس بعيداً عن جهود استعادة السيادة والاستقلال الوطني، والجهود المبذولة من أجل المحافظة على المجتمع وهويته وقيمه، نهض المجتمع في مواجهة مشروع التطبيع مع الكيان الصهيوني، وانتظمت قوى المجتمع في هيئة شعبية لمناهضة التطبيع عبر مناشط وفعاليات شعبية مؤثرة.
ثم احتشدت مكونات المجتمع وتراصت في منصة وطنية جامعة تنشد توظيف الطاقات الوطنية لصالح مشروع وطني يعمل من أجل إعادة التوازن إلى المسرح السياسي السوداني، ولتشكيل الحاضر والمستقبل وفق المشيئة الوطنية التي تحفظ للوطن وحدته واستقلاله وأمنه ورفاهه. وهذا الذي تنادت له القبائل، والأحزاب الوطنية، والشرايح الشبابية والنسوية، تحت مظلة المجلس الأعلى للتصوف الذي أطلق مشروع نداء السودان الذي أنهى أعمال الحوار الوطني على مائدة مستديرة منتصف شهر أغسطس/آب/2022.
مشاهد السودان المستقبلية
إن الواقع السوداني بمعطايته التي سبقت، يُعد واقعاً صعباً بالغ التعقيد، وقد زاد المشروع والنفوذ الخارجي من صعوبة وتعقيد هذا الواقع، خاصة وأن للمشروع الخارجي شركاء “سودانيين”، تمكنوا من تقسيم الأدوار بينهم، وأدوا أدوارهم بجرأة، من خلال التكامل بين الواجهات السياسية المختلفة من أحزاب، ولجان شبابية، وبين الواجهات العسكرية التي تمثلها الحركة الشعبية لتحرير السودان جناح عبد العزيز الحلو، ورصيفتها التي يترأسها عبد الواحد محمد نور، وتضطلع البعثة الأممية “يونتامس” بدور “المايسترو” الذي يوزع الأدوار، ويحدد زمن كل لاعب.
من كل الذي تقدم، تبرز مشاهد تستشرف مستقبل السودان في العشرية القادمة من تاريخه، والمشاهد هي:
المشهد الأول: المشهد الديمُقراطي
يعتبر هذا المشهد هو المشهد المرغوب فيه من غالب أهل السودان، لكنه المشهد الذي تواجهه صعاب كبيرة، ومن أبرز تلك الصاب ما يلي:
– عدم قبول الأحزاب الصغيرة المتحالفة مع الخارجٍ بهذا المشهد، بسبب عجزها التاريخي عن تحقيق أي مكاسب انتخابية، الأمر الذي سيفقدها فرصة العودة إلى السلطة وكراسي الحكم الذي منحه لها شريكها الخارجي، وبالتالي يتوقع استمرار حملاتها الرافضة لهذا الخيار، وقد يحملها هذا الرفض إلى الانتقال إلى مرحلة متقدمة من مراحل إشاعة الفوضى والاضطرابات حتى تمنع قيام الانتخابات.
– عدم توفر إرادة سياسية تنتج توافقاً وطنياً على دستور انتقالي يُستند إليه كمرجعية في أي عملية انتخابية.
– رفض بعض الدول الغربية “المستتر” لأي عملية انتخابية تمكن المجتمع السوداني من الاختيار الحر، ورفض بعض الدول لمبدأ التحول الديموقراطي، وخشيتها من اعادة تطبيقه في السودان، ويكمن مبعث الخوف في عدم رغبتها في انتقال ثقافة الحرية والديموقراطية إلى دولها ومجتمعاتها.
– تفضيل بعض الدول للحكم العسكري على الحكم القائم على الخيار الديموقراطي الانتخابي الحر، كون الأول يحقق استقرار يعجز الثاني عن تحقيقه -كما تزعم- الأمر الذي ينعكس عليها بشكل مباشر.
– عدم وجود معادلة تستوعب قوات الدعم السريع الحركات المسلحة في دارفور في مرحلة الانتخابات وما بعدها، وخوف هذه الحركات من فقد المكاسب التي تحققت لها بموجب اتفاق جوبا، وخوف قائد الدعم السريع ومعاونيه من فقد المكاسب السياسية التي تحققت لهم خلال هذه الفترة الانتقالية.
إن تقدم المشهد الديموقراطي أو تأخره رهين بقدرة أي من طرفي المعادلة السياسية على فرض توجهه على الطرف الآخر، فالطرف الرافض للانتخابات لا يتمتع بثقل شعبي ولا مجتمعي، ويعتبر تحالفه مع الخارج هو مصدرة قوته الرئيسة، أما الفريق الراغب في تحقق هذا المشهد، ويعمل من أجل تحقيقه، فإنه يستمد قدرته من المجتمع، كما يشكل الرأي العام في مؤسسات الدولة – على ضعفها- مصدراً آخر من مصادر قوته.
االطرف الأول الرافض للانتقال الديموقراطي، والرافض إجراء انتخابات يريد التربع على كراسي السلطة بدفع وسند غربي، لكنه لم يدرك إن الغرب الذي يواليه يعيش واقعاً دولياً جديداً جراء الحرب في أوكرانيا، وجراء تداعيات الصراع الدولي حول النظام العالمي الجديد، وان ذلك جعله يعيش حالة تراجع على المسرح الدولي والمسرح الاقليمي.
المشهد الثاني: مشهد التغيير المسنود بالقوة العسكرية
وهو مشهد مطروح تتبناه بعض القوى السياسية التي ترفع شعار التغيير الجذري، وتعمل من أجل استنساخ نموذج التغيير في شرق أفريقيا الذي تمّ باستخدام القوة وتوظيفها في صناعة التغيير الجذري الذي أقصى الهوية العربية من زنجبار، ويعتزم أصحاب مشروع التغيير الجذري في السودان، استدعاء هذا النموذج وتطبيقه ليحقق ذات النتيجة التي حققها حزب الأمة اليساري في زنجبار عبر المجزرة الشهيرة التي نفذها في 12/يناي/ كانون أول/ 1964، وليعيد هندسة أوضاع السودان على نحو جديد يزاوج بين نموذج زنجبار ونموذج حكم عبد الله التعايشي خليفة الامام المهدي.
يعتمد هذا المشهد على استخدام القوة العسكرية لبعض الحركات المتمردة والتي لم توقع على اتفاقية جوبا، يشاركها في ذلك بعض الأحزاب الصغيرة وبعض الشرائح الشبابية التي حظيت برعاية غربية وانتظمت في الجماعات الأناركية بمسمياتها المختلفة.
لهذا المشهد نسخة ثانية بنيت على شراكة بين مليشيا مسلحة “مجاورة للمؤسسة العسكرية”، وبين تحالف أحزاب المشروع الخارجي، وتحظى برعاية اقليمية، وتعمل على الاستيلاء على الحكم باستخدام قوتها العسكرية بالشراكة مع هذه الأحزاب التي ستمثل دور الحاضن السياسي لهذا التغيير.
يعتمد هذا المشهد في نسختيه على الفوضى غير الخلاقة التي ستكون مدخلاً للعمل العسكري وهو ما ظل يراه الناس منذ عام من خلال المظاهرات وحالات الفوضى التي لم ينتبه كثيرون لحقيقتها برغم كشف بعض قادة هذا العمل لمشروعهم وملامحه ومراحله.
يلزم القول أن هذا المشهد هو مشهد الحرب الداخلية بامتياز، وفي حال حدوثه فإن التعافي منه وتجاوزه يتطلب زمناً طويلاً كما دلت التجارب داخل السودان وخارجه.
حظوظ هذا المشهد تضعف وتقوى من خلال ضعف أو قوة المؤسسة العسكرية، وقدرة قيادتها على اتخاذ القرار الصحيح في وقته، كما يتأثر سلباً وايجاباً بمستوى وعي المجتمع وقدرته على التفاعل الايجابي بالقدر الذي يسهم في تحصين البلد والحد من فرص تحقق هذا المشهد.
المشهد الثالث: مشهد سيطرة المؤسسة العسكرية
ولهذا المشهد نسختين كذلك، تتمثل النسخة الأولى منه في قيام قيادة المؤسسة بالسيطرة على كل مقاليد السلطة وترتيب أمرها على نحو يضمن بقائها، ويكرس قبضتها عليها من خلال ترتيبات تفضي لاستدامة الحكم العسكري وترسيخ قيادة المؤسسة العسكرية كقيادة سياسية للبلد عبر تدابير انتقالية قد تنتهي بتدابير انتخابية، وتجد هذه النسخة تشجيعاً من بعض الدول.
أما النسخة الثانية من هذا المشهد، فتقوم على اطاحة بعض الضباط بقيادة المؤسسة العسكرية الحالية والسيطرة على المؤسسة العسكرية ومن ثم السيطرة على قيادة البلد، ثم المضي عبر تدابير دستورية تفرض الأمر الواقع وتكرس القيادة الانقلابية كقيادة سياسية للبلد.
ينطوي هذا المشهد في أي من نسختيه على مخاطر كبيرة، في ظل وجود كثير من الحركات المسلحة،بعضها أبرم اتفاقيات سلام مع الحكومة، وبعضها رفض الاتفاق معها، مع وجود جماعة مسلحة تمتلك قدرات عسكرية ومالية كبيرة تجلس إلى جوار المؤسسة العسكرية ولها مصالح ومطامع، وقد يُعقد ذلك من عملية التغيير العسكري الهادف إلى السيطرة على السلطة دون حدوث تفاهمات مسبقة مع هذه الحركات المسلحة تضمن لها استمرار المكاسب والمصالح.
خـاتمــة:
الراجح وفق المعطيات الشاخصة على سطح المسرح السياسي تداخل بين المشهدين الثاني والثالث يفضي في نهاية حقبة الاحتراب التي (يمثلها المشهدين الأخيرين) إلى المشهد الأول على النحو الذي حدث في الجزائر بعد عشريتها السوداء، وذلك وفق ما يلي:-
– تطوير حالة الاضطرابات الحادثة الآن لتدخل مرحلة الفوضى المتزايدة.
– تدخل بعض الحركات والمليشيات المسلحة على خط الفوضى لتطويرها إلى حالة حرب داخلية.
– استمرار هذه الحالة التي تبدأ بالفوضى العارمة ثم تطورها إلى حرب داخلية، تستمر لمدة قد تصل إلى عشر سنوات.
– يلي ذلك سيطرة المؤسسة العسكرية على الأمور، ثم إنهاء حالة الاحتراب، العودة إلى المشهد الأول، المشهد الديموقراطي الذي تجسده “بصورة عملية” انتخابات مدروسة تجعل السيطرة من وراء جدر للمؤسسة العسكرية حقيقة ماثلة.
إن تجنب المشاهد القاسية التي تبدو راجحة وفق المعطيات الماثلة أمر ممكن، لكنه يتوقف على وقف التدخل والهيمنة الخارجية، وعلى فك الارتباط بين الخارج وأدواته المحلية، ويتوقف كذلك على فاعلية المجتمع، وتعظيم قدراته وأدواره المانعة لتحقق هذه المشاهد، وقدرة المجتمع كذلك على تشكيل حالة اسناد وطني للمؤسسة العسكرية يمكنها من الاضطلاع بدورها في حفظ وصون سيادة واستقلال البلد، وفي تحقيق أمنه واستقراره.