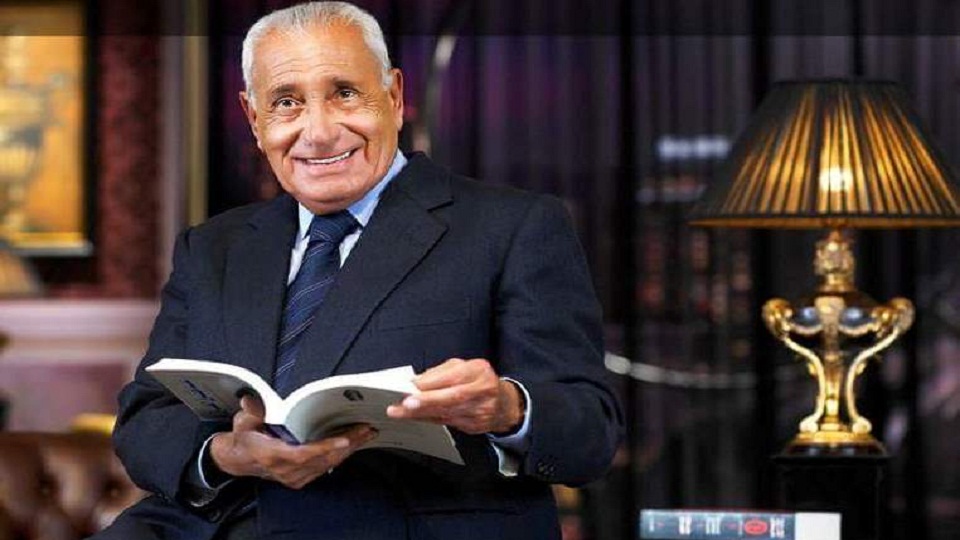الكاتب السياسي مجدى منصور يحاول سبر أغوار المنطق الرئاسي
معضلة البداية
لا يجادل أحد في أن شخصية الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي صارت تمثل عند قطاع عريض سواء من المحبين المؤيدين المتيمين بالرئيس أو الكارهين الرافضين الزاجرين له ما قاله ونستون تشرشل (رئيس وزراء بريطانيا) في وصفه للاتحاد السوفيتي السابق بأنه «لُغز محاط بالسر وملفوف بالغموض».
وكنت من موقع المتابع المهتم أرقُب الرجل منذ ظهوره على مسرح الأحداث علناً بعد تعيينه وزيراً للدفاع في حكم الإخوان.

وما تلاه مما حدث في مصر من أحداث حتى وصلنا لمظاهرات 30 يونيو وعزل مرسي في 3/7 ، وبعدها أصبح الفريق أول عبد الفتاح السيسي «بطلاً شعبياً» في مخيلة المصريين ، بل وكثير من العرب.
وتلتها الفترة الأولى لحكمه ، وبدا لي الرجل يومها يواجه المشاكل ويتعثر في زحام الأزمات ثم تتابعت بعد ذلك العقد والتعقيدات.
وفى البداية بدأت الرياح التي كانت تهب من قصر الاتحادية تُلقى على الشعب المصري ألواناً وأشكالاً من الوساوس والمخاوف والشكوك ، وخصوصاً في مسألة تحمل تكاليف الإصلاح الاقتصادي المزعوم ، وانحياز سياسات الرجل للأغنياء ضد الفقراء.
ثم إن الأخبار التي بدأ يسمعها الشعب ، والقرارات والأفعال التي يراها صادرة من الرئيس وحكومته كانت تنزع الاطمئنان من صدره لتغرس الأشواك بدلاً منها!
وكان أكبر الأشواك المغروسة في قلوب ونفوس وعقول المصريين اتفاقية تسليم جزيرتي صنافير وتيران للسعودية.
وكانت الصور والمشاهد والأحداث بعدها صدمات متتابعة.
وكانت ملاحظتي الثانية على أداء الرجل – هي في أسلوب خطاب الرئيس للشعب فالرجل منذُ ظهوره على الساحة السياسية المصرية دأب على أن يُحير المصريين ويصدمهم من خلال كلماته التي تنطلق في خطاباته ، والأمثلة لها أول وليس لها أخر!

ثم جاءت الفترة الثانية من حكمه (بعد تعديل الدستور لتمد في بقائه في السُلطة) ، وكانت ملاحظاتي الأساسية في تلك المرحلة تتلخص في نقطتين:
الأولى – هي تضييق المناخ العام لدرجة «الخنق» ، وكان ذلك يعنى بالنسبة لي «توجس» النظام مما حوله وتلك علامة «ضعف» تعكس شعور «بالخوف» أكثر مما هي بادرة قوة تزف بُشرة ثقة بالنفس وطمأنينة للوضع.
والثانية – أنه أصبح هناك كل يوم مع كل قرار أو تصريح للرئيس أسباب حقيقية للخلاف مع قطاع عريض من الشعب المصري (من الأحداث السياسية والاقتصادية للأحوال الاجتماعية ، ومن المسائل الثقافية للأمور الدينية!) ، والحاصل أن أوجه الخلاف بين الرئاسة وقطاع عريض من الشعب أصبحت يوماً بعد يوم تتسع ولا تضيق ، و تكبُر ولا تصغُر ، و تزيد بدلاً من أن تقل ، ومن ثم زادت احتمالات التصادم وقلت إمكانية التفاهم.
وكان كل ذلك له تداعياته ومضاعفاته وعواقبه على الجميع الشعب والنظام والإقليم.
وكنت أتابع كل ذلك وأجد أن المواقف من الرجل «حدية» فإما تجد المؤيد المحب بقوة أو تجد المعارض الكاره بجنون.
وكلا الفريقين لديه منطقه و أسبابه ومبرراته في اتخاذ مواقفه من الرجل ، وكنت أرى من جانبي أن الحقيقة أعقد من أهواء (المحبين والكارهين) على حد سواء و التي تشكل نظرتهم للأمور وللرجل.
وكنت استحضر دائماً نصيحة الأستاذ محمد حسنين هيكل (رحمه الله) بأن «الفهم قبل الحُكم».
وعاد السؤال لخاطري من جديد – كيف استطاع الرجل أن يُبدد كل ذلك التأييد والحب الجارف الذي كان له في قلوب المصريين خلال تلك الفترة القصيرة؟
ثم ما هي مرجعيته الفكرية التي تُشكل نظرته في التعامل مع عدد من القضايا مثل الديمقراطية والحريات العامة والتوجه الاجتماعي؟
وكما يقول الأستاذ هيكل: فإن أي شخص يُقبِل على العمل العام ويدخل ميدانه يصل إلى هناك ومعه حمولاته الثقافية الكاملة (وفيها الموروث بخصائص الطبيعة ، وفيها المؤثر بالبيئة والتربية والقيم الموجهة ، وفيها المكتسب بالعلم والمعرفة والتذوق ، وأخيرا وفوقها المتراكم بالتجربة مع الحياة والناس والظروف). (انتهى الاقتباس).
وكل ذلك لا يمكن معرفته في حالة الرئيس لأنه من الأسرار وما هو معلن صورة مرسومة ومعدة سلفاً صنعتها المساحيق الاعلانية للترويج للرجل للتغطية على الانتقادات ولا أقول السلبيات الموجهة له من كل حدب وصوب.
ثم أننى لو ركزت على تصريحاته الغريبة أحياناً والعجيبة أحياناً والمحيرة معظم الأحيان أكون وقعت في نفس المُنزلق الذى يقع فيه المحبين والكارهين على السواء ، وهو ترك المشاعر (تلون) النظرة للأمور وتتحكم في اتخاذ المواقف.
ووسط تلك الحيرة وبعد التدقيق في تلك التصريحات للرئيس، وجدت أمراً لم يفطن له الكثيرون.
وهو أن تلك التصريحات هي صدىً لمواقف اتُخذت وأفعال حدثت وتصريحات قيلت في أوقات تاريخية مختلفة على امتداد العالم ولكن بأسلوب الرئيس السيسي الذي وضع فيها لمسته الخاصة وبصمته المميزة!
فمثلاً تصريح الرئيس عن الأثر السيئ لثورة 25 يناير 2011 ، وانعكاسها على سد النهضة الأثيوبي عندما قال: «البلد كشفت ظهرها وعرت كتفها في 2011.. ولو مخدناش بالنا هيتعمل فينا أكتر من كده ».
إن ذلك التصريح هو صدىً قديم لمقولة عُرفت في التاريخ بأكذوبة (الطعنة في الظهر) وملخصها :
أنه بعد هزيمة ألمانيا في الحرب العالمية الأولى ، أنكر الجنرالان هايدنبرج ولود ندوروف هذه الهزيمة وألقيا المسؤولية على عاتق الثوار والعمال المضربين بقولهما «إن الوطن قد طعن الجيش في الظهر».
أي أن ادعاء «المؤامرة» التي عبر عنها الجنرالان الألمانيان هايدنبرج ولود ندوروف في «أن الوطن قد طعن الجيش في الظهر» ، تحول مع الجنرال المصري عبد الفتاح السيسي لتشبيه «جنسي مثير»! بقوله «البلد كشفت ظهرها وعرت كتفها في 2011 ».
ومن هنا قر قراري على الاستعانة بتجارب حدثت في أوقات تاريخية متعددة ، وإلقاء نظرة عليها ، ومن خلال تلك التجارب يمكن فهم نظرة الرئيس لعدد من القضايا.
وقبل الدخول لساحة العتبات المقدسة للموضوع أقول :
أنني من مدرسة ترى أن البحث عن الحقيقة بالاجتهاد في الفهم والتحليل أجدى من إطلاق الأوصاف والنعوت الشائعة ، ومن قذف التهم المعممة ، ومن إطلاق الأحكام بغير حيثيات وبغير فرص لنقضها!
أنى أعرف أن ما سأكتبه لن يُرضى لا المؤيدين ولا المعارضين ، وأقول أننى أجتهد فإن أصبت فلي أجران وإن أخطأت فهو أجر المجتهد ، وفى النهاية أرجوا أن تكون المسافة واضحة بين الاجتهاد و الأخطاء والخطايا!
وأخيراً – فإن مراجع المعلومات الموجودة بالمقال مذكورة في نهايته.
رئيس يُفضِل «ستالين» على «جورباتشوف»!
(1) رؤية أن التقدم الاقتصادي يسبق الحريات السياسية
يُخيلُ لي دائماً أن الرئيس السيسي أو أحد مستشاريه متأثر بشدة بتجربة الاتحاد السوفيتي السابق ، إن مفهوم (الاقتصاد الذي يسبق السياسة) ، قِيل في عهد ميخائيل جورباتشوف.
فعندما وصل جورباتشوف إلى القمة في الكرملين في مارس 1985 ، طرح سياسة (البيروسترويكا) أي (إعادة البناء) و(الجلاسنوست) أي (المصارحة).
ولقد تحدث جورباتشوف في قاعة البرلمان السوفيتي قائلا:
«عندما جئت للسلطة وجدت الإناء على النار يغلي ، وتصورت أن المطلوب هو رفع الغطاء عن الإناء لتنفيس البخار، ولكن ما رأيته داخل الإناء كان أصعب مما تصورت ، ولم يكن في مقدوري أن أعيد الغطاء والتظاهر بأنني لا أسمع ولا أرى شيئاً ، وإنما وجدت أن واجبى يحتم على أن أصارح الشعب السوفيتي بالحقائق، وأن أدعوه وهو وحده القادر إلى المشاركة في مواجهة الخطر».
ومع البيروسترويكا والجلاسنوست (أي إعادة البناء والكلام بصوت عال) زادت حدة المشاعر ، وزاد إلحاح الحاجات.
وكان السؤال وقتها: ما أخرة الكلام؟ وإذا زاد الكلام عما هو موجود من سلع وخدمات فهل يمكن توقع شيئاُ أخر غير الثورة؟
كانت سياسة الجلاسنوست (المصارحة) تضرب في هذا النظام كله بصرف النظر عن أية تقسيمات بين الفترات والعصور ، وهذا أدى إلى تآكل ونحر قوائم الشرعية تساعد عليه مشاكل الساعة واللحظة.
وكان هذا العنصر بالذات موضع نقاش بين “جورباتشوف” وعدد من كبار مستشاريه.
كان رأى بعضهم: أن تبدأ عملية إعادة البناء قبل أن تتفتح أبواب المصارحة، بحيث تجئ المصارحة وفى السوق سلع وخدمات. أما إذا جاءت المصارحة وليس في السوق سلع أو خدمات، فإن موجة المد العاتي لها سوف تكتسح الحاضر والمستقبل أيضاً دون أن تجد ما يوقفها عند حدود البارحة.
وكان من رأى البعض الأخر: أن التجربة الصينية أكثر حكمة، فهناك رأى الزعيم الصيني “دينج شياو بينج” أن يبدأ بفتح أبواب الحرية الاقتصادية ثم يجيء الدور بعدها على الحرية السياسية.
ودارت في الكرملين مناقشة حامية حول كلا الخيارين:
كان هناك رأى يقول: «أن في الصين أعطوا حرية اقتصادية أكثر من خمس مرات مما أعطينا نحن هنا، ونحن هنا أعطينا حرية سياسية أكثر خمس مرات مما أعطوه في الصين. والنتيجة أن الأحوال عندنا سائلة، والأحوال عندهم أكثر تماسكاً».
وكان رأى “جورباتشوف”: أن النتائج تستوي في الحالتين: فالحرية الاقتصادية لابد أن تواكبها حريات ديمقراطية أوسع.
والحرية السياسية لا بد أن تتوافر لها سلع وخدمات أكثر.
وكان ظنه أن الحرية السياسية متاحة على الفور ومن الأنسب فتح الأبواب لها بغير انتظار حتى وإن زادت احتمالات التعرض!
وفى فكر ورؤية الرئيس السيسي أن الرئيس الأسبق “مبارك” أخطأ نفس خطأ “جورباتشوف” ، عندما أعطى حريات سياسية في الكلام والنقد عبر الإعلام في ظل وضع اقتصادي صعب ومهلهل ، وذلك أدى لزيادة نحر في جدار الشرعية وعجز في مستوى المشروعية للنظام وتحولت البلاد في النهاية لحالة سيولة خطرة كادت أن تعصف بالبلد وأهله.
(2) فكرة غلق المناخ العام و السيطرة على منسوب الحريات في المجتمع

يمكن القول هنا أن الرئيس السيسي متأثر بذلك التوجه بزعيم الاتحاد السوفيتي الحديدي (جوزيف ستالين) ، وهو الذي بنى النهضة الصناعية الكبرى في الاتحاد السوفيتي (مرتين) مرة قبل الحرب العالمية الثانية بتكلفة إنسانية عالية ، ومرة ثانية بعد الحرب العالمية الثانية بتكلفة انسانية أعلى بكثير من المرة الأولى.
فعندما جاء “ستالين” إلى السلطة في أواخر العشرينات واجهته حقيقة بديهية ، وقد رتب عليها نتائج بالغة الخطر.
إن فكرة “المبادرة الفردية”(الرأسمالية) هي بالفعل منطق تحقُقها بأي شيء آخر.
وأما فكرة «التنظيم الاجتماعي» (الشيوعية)، فإنها تحتاج إلى “الفرض بالقوة” لأنها مختلفة عن منطق الطبيعة البشرية رغم اتفاقها مع مطلب العدل.
وعندما يبدأ «الفرض بالقوة» ويكون موجهاً إلى مجتمع بأسره يُرجى تغييره إذن فإن هذا «الفرض بالقوة» يصبح اختصاص الدولة.
وهكذا أصبح الفكر – الذي يدعو له حزب – سلطة دولة تفرض بالقوة على مجتمع – أن يتشكل بالكامل من جديد وفق تصوراتها، وكانت هذه التصورات جامحة ابتداء من إلغاء الملكية إلى إلغاء الدين!
وربما كان ما أغرى “ستالين” على الغلو في طريق الفرض بالقوة أن تلك كانت فترة (أزمة) الرأسمالية الكبرى في أواخر العشرينات وأوائل الثلاثينات.
أزمة الرأسمالية في الولايات المتحدة الأمريكية!
وحين كانت الرأسمالية في أمريكا محاصرة ، وكانت جيوش العاطلين خصوصاً من الجنود العائدين بعد الحرب العالمية (الأولى) إلى ظروف الكساد والبطالة في ذلك الوقت – تُعسكر في شارع بنسلفانيا تحيط بالبيت الأبيض الأمريكي وترغم الرئيس الجالس فيه وقتها – وهو الرئيس “هوفر” على استعمال القوة المسلحة في فض المظاهرات والاعتصامات .
العسكريون يفكرون في الانقلاب على الديمقراطية في معقل الإمبريالية!
حتى أن قائد الجيش الأمريكي في تلك الظروف وهو الجنرال “دوجلاس ماك آرثر” راودته فكرة (الاستيلاء على السلطة) لإنقاذ الدولة من «كُساح وعجز» المدنيين الحزبيين ، وهمس بفكرته هذه إلى رئيس أركان حربه وكان في ذلك الوقت الكولونيل “دوايت ايزنهاور” (الذى أصبح رئيساً للولايات المتحدة في أوائل الخمسينات).
وهكذا فإن “ستالين” سار في سبيل «الفرض بالقوة» إلى نهاياته الدموية وكان بين أسبابه أن «الثورة» (أحق أن تفرض) – من «الثورة المضادة» – التي رآها أمام عينيه على الناحية الأخرى من الأطلنطي.
وفى هذا الوقت كان “ستالين” يواصل الفرض بالقوة، ومع ضرورات “الفرض بالقوة” فإن “ستالين” بدأ ينشئ (جيشاً قوياً) لأعداء الداخل وللنازية الهتلرية العسكرية – ثم استرد الأرض لملكية الدولة بعد أن رأى الفلاحين الذين تملكوها عاجزين عن إدارتها، فقد تعودوا قروناً أن يكونوا عبيداً بالبيع والشراء مع الأرض دون تجربة في إدارتها .
وبهذه المسؤولية الكاملة للدولة في الزراعة ، وقبلها في الصناعة والتجارة والخدمات، ثم بمطالب دخول الاتحاد السوفيتي إلى عصر الصناعات الثقيلة فإن السلطة لم تعد للسوفييت وإنما أصبحت للحزب ، وذاب الحزب في الدولة ، وعلى القمة رجل واحد يملي إرادته المطلقة على كل الناس وكل الأشياء!
ولم يصبح “ستالين” بهذه السلطات كلها (قيصراً أحمر جديداً) فقط ، وإنما أصبح (إلهاً) يملك مقادير الحياة والموت!

رؤية السيسي وفقاً للمنطق الستالينى!

يمكن أن نقول أن الرئيس السيسي يرى الأمر ويتعامل معه من وجهة نظر ستالينية بحته:
وللحق يقال فالرئيس دخل إلى مشهد سياسي واقتصادي واجتماعي وثقافي مزدحماً بأكثر مما هو لازم ، وصاخباً بأكثر مما هو ضروري ومختلطاً ومتشابكاً ومعقداً وأصبح ذلك كله خليطاً عصياً على المزج والفهم في آنٍ واحد.
ثم إنه على طول الطريق منذ ثورة يناير 2011 وحتى 3/7 /2013 ، فإن الرجل لم يسمع من غالبية «النخب المدنية» أو من ادعوا أنهم النخب إلا أفكاراً لم تكن تهدف إلا إلى هدم أفكاراً أخرى دون النظر في تبعات الهدم ، ودون أن يفهم هؤلاء أن الرجل «عسكري» وبالتالي فهو بعيد عن فكرة «الثورة» وأقرب لفكرة «الاصلاح».
كما أنه في تلك الفترة استمع من تلك النخبة لكثير من طلبات الانتقام التي أرادت للتغيير أن يكون سلاحاً في يد الأحقاد لتصفية حسابات عالقة بينهم.
والرجل رأى بعد ذلك (كما رأى ستالين قبله) أن الوضع الذي شاهده وعاصره لم يعد يصلح للعيش به في اليوم والغد ، ولهذا يجب تغييره تغييراً شاملاً من (المنبع) وبالقوة (الباطشة) إن استلزم الأمر ، لأن الناس عادة لا تستسيغ التجديد والتغيير وتفضل القديم الراكد لأنه ما تعودت عليه وألفته.
ومن هنا يجب فهم التغيرات الجذرية التي يجريها الرجل في التعليم والإعلام (وهو منبع القيم ومُشكِل والضمير) وفى الاقتصاد (وهو الموجه لحركة التدافع الاجتماعي والصراع الطبقي) وفى السياسة الخارجية وقد أصبحت مبنية على منطق (الصفقات) والتي تنهى أي أحلام أو أوهام في عودة الدور المصري كما كان عليه في الفترة الناصرية لأن الزمان اختلف فضلاً عن الرجال.
كما أن الرئيس يرى أن هدف (تثبيت) الدولة المصرية التي تضعضعت أركانها وضعفت قوائمها واهتزت شرعيتها وذهبت هيبتها يستحق التضحية بجيل أو جيلين (كما قال الرئيس في عدد من المناسبات). أي أن بقاء الدولة أهم من وجود الشعب!(نفس منطق ستالين وكانت سياسة ستالين هي أن يضحي تضحية كاملة بأي عدد من أجيال الشعب السوفييتي في سبيل بلوغ مرحلة الانطلاق).
وهو بناء على ما سبق قرر كما فعل (ستالين قبله): اللجوء إلى «العنف» و «الجبر» كوسيلة لتحقيق الأهداف السياسية. لقد أصبح العنف والجبر عملياً معه (كما كان مع ستالين قبله) إحدى الوسائل (الحاسمة) لتحقيق الخطط والبرامج الاجتماعية والاقتصادية ، وذلك النهج أدى للموت النهائي والتراجيدي لفكرة «الحرية» الدافعة والمحرضة على الإبداع ، كما قتل ذلك النهج قبل ذلك شعار «بناء مجتمع اشتراكي تسود فيه العدالة»! (في الاتحاد السوفييتي مع ستالين).
كما أن الرئيس يرى أن النهضة هي نهضة (مادية بحتة) تتمثل في بناء مصانع و شق طُرق واقامة كباري! و تشييد وحدات سكنية واستصلاح أراضي.
أما (الروح) أو بناء (الإنسان) من خلال إعطاءه حق المناقشة والنقد والرفض والاختيار فهذا أمر يُنتج جيل (مُنشق) على القيم والتقاليد الاجتماعية السائدة في المجتمعات العربيةَ.
كما أن الرئيس اعتمد في تنفيذ رؤيته ومشروعه وحمايته على (الجيش) بديلاً عن (الحزب الشيوعي) في حالة “ستالين” ، لأن الحالة السياسية المصرية لم تستطيع أن تنجب حزباً قادراً على لم شمل المصريين على قضية أو هدف محدد. كما أن “المؤسسة العسكرية” هي الأكثر قوة وتنظيماً في الوطن.
ويرى الرئيس أيضاً – أن أي أمر أو فعل يُعطل مشروعه في البناء يستحق أن يواجه بكل قوة وعنف سواء كان قادم من قوى الشر (التي كان يطلق عليها ستالين قوى «الثورة المضادة» أو «أعداء الشعب») ، وخصوصاً وأنه يرى أن قوى الشر تلك ساهمت في تدمير أوطان مثل ليبيا وسوريا.
أو قادم من أصدقاء الأمس و الذين تحولوا (لأعداء اليوم بمعارضتهم له ولمشروعه وخططه) كالفريق سامى عنان (رئيس الأركان الأسبق) والفريق أحمد شفيق (قائد القوات الجوية الأسبق).وكما حدث من (ستالين مع تروتسكي).
إن الرئيس من المؤسسة العسكرية وتلك المؤسسة هي مؤسسة ثبات وانضباط ومن ثم فهي ترفض ولا تستسيغ التغيرات الدراماتيكية مثل (الثورات) ومن تلك الناحية يمكن فهم (نظرته) لثورة 25 يناير.
كما أن الرئيس كما ذكرنا من المؤسسة العسكرية التي ليس من تقاليدها الاعتراض أو معارضة الأوامر الصادرة من القيادة ، وإلا ضاع الانضباط العسكري ، ومن هنا يمكن فهم نظرة الرئيس «للمعارضة» بشكل عام ، و لأى رأى معارض أو مخالف لرؤيته وخطته.
وبناء على كل ما سبق ذكره فإننا «لا يمكن أن ننتزع شيء من سياقه»
فالرجُل عسكري منذ صغره لم يمارس السياسة حتى ظهر على مسرح الأحداث كوزير للدفاع في عهد الإخوان وبالتالي نظرته للسياسة وللسياسيين في منتهى (السلبية) ، ومن هنا يمكن فهم تصريحه (أنا موش سياسى من بتوع الكلام )!
وهو هنا يختلف عن الزعيم “جمال عبد الناصر” والرئيس “السادات” اللذانِ احتكا بكافة التيارات السياسية في عصرهما منذ شبابهما (الاسلامية ، والشيوعية على اختلاف فصائلها ، والليبرالية) بل ومارسوا العمل السرى فترة قبل ثورة يوليو 1952.
كما أنه يختلف عن الرئيس “مبارك” الذي عمل مع السادات كنائب له عدة سنوات أكسبته تلك التجربة بعض الخبرة والمرونة السياسية.
إن الرئيس بحكم وجوده في منصب مدير المخابرات الحربية وقت ثورة يناير وبعد اعتلائه لمنصب الرئاسة وضح أنه مهتم بأساليب الحرب النفسية (أو ما يُحب هو أن يُطلق عليه الجيل الخامس للحروب) ، ولأن الرجل جديد في عالم السياسة ولم يحتك بعالم الفكر و الثقافة فقد خلط بين «الحماسة» و«العقيدة» ذلك أن الحماسة قادرة على أن تجمع الصفوف وترصها لحظات ، ولكن العقيدة هي وحدها القادرة على إبقاء الصفوف متراصة وتنظيم زحفها على طريق المثل الأعلى.
فالحماسة هي مخاطبة «القلب» ، ولكن العقيدة هي مخاطبة «العقل والقلب» معاً ، وهو نفس الفرق بين علم «الاعلام» وهو السياسة «بالإقناع» وعلم «الإعلان» وهو السياسة «بالانطباع»!
إن الرئيس دخل إلى القوات المسلحة في وقت اقتحمت فيه المؤسسة العسكرية مجال الاستثمار في الأنشطة المدنية (لأسباب عديدة ليس هذا وقت شرحها) ومن ثم تشبع الرجل بمبادئ الرأسمالية وأفكارها عن الربح والخسارة بصرف النظر عن أي اعتبارات أخرى.
إن بعثة الرئيس الدراسية إلى الولايات المتحدة الأمريكية من المؤكد أنها تركت بداخله ومن ثم رشحت الى عقله الكثير من مبادئ اقتصاد السوق مثل «إن آليات السوق تصحح نفسها بنفسها بدون تدخل»، و أن «معالجة أخطاء النظام الرأسمالي لا تكون إلا بمنح المزيد من الحرية للرأسمالية» ، « دعه يعمل دعه يمُر» وفى النهاية فأن النظام الرأسمالي لا ينظر إلى أي غاية الا غاية «الربح» حتى ولو على أجساد الفقراء.
وأخيراً – لعل مشكلة مصر اليوم:
أن الرئيس ومؤيديه يتكلمون لغة الواقع ويحسبون حسابات الواقع وينصحون الآخرين المعارضين بالعيش على أرض الواقع بعيداً عن سماء الأحلام والأوهام وعدم الإقدام على حماقات انتحارية.
بينما المعارضون قلوبهم مشحونة بالرغبة في «الانتصار للحلم» والمواجهة الأقرب للأمثولة التراجيدية منها للإنجاز الواقعي.

وبسبب هذه التناقضات بين مشقة (الواقع) المُعاش وابتعاد وصعوبة تحقيق (الحلم) المرتجى انتقل الغالبية من الشعب من «الحالة الكافكاوية» حيث يموت الفرد لتبقى الأمثولة ، إلى «الحالة الشكسبيرية» حيث يكون الانتظار جحيماً والنسيان موتاً في متاهة من الوجع كما عرفنا من تردد الأمير هاملت وعذابات الملك لير!
المراجع:
1- السكرتير السابع والاخير (نشوء وانهيار الامبراطورية الشيوعية) ميشيل هيلير.
2- الزلزال السوفيتي – محمد حسنين هيكل.